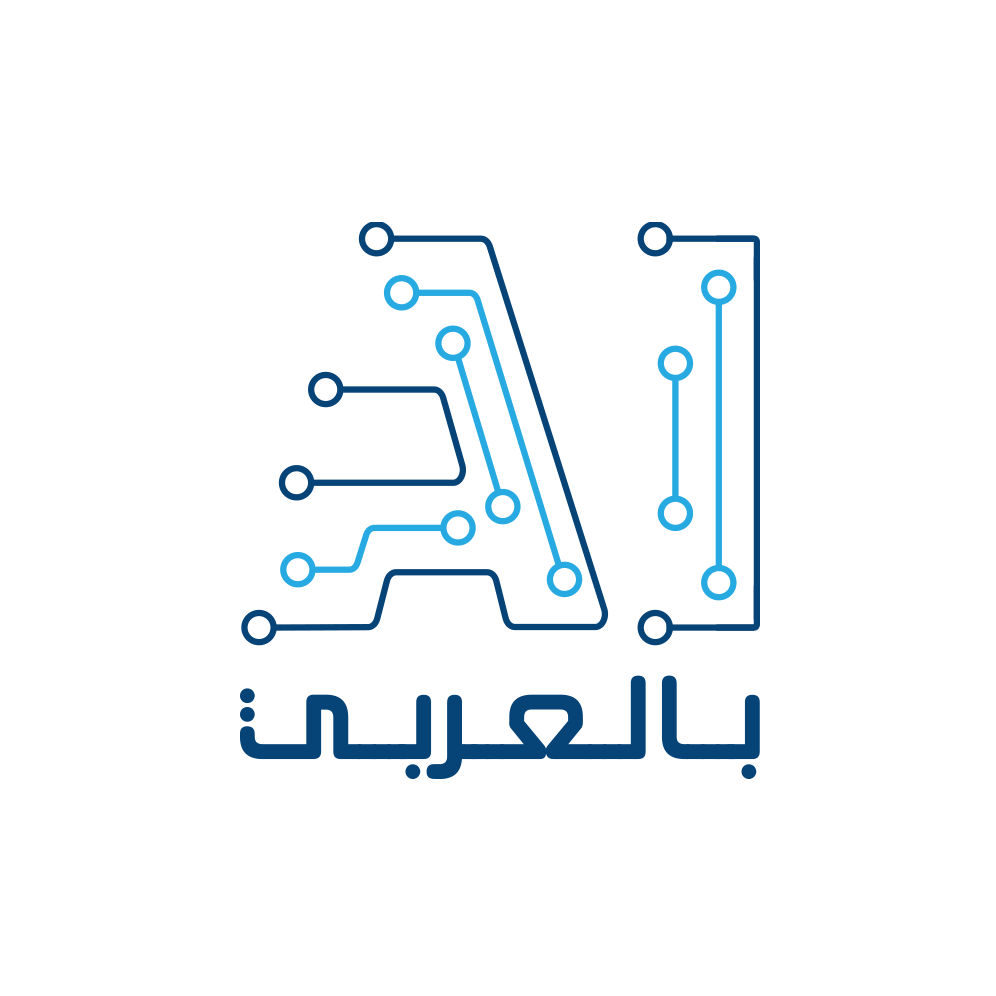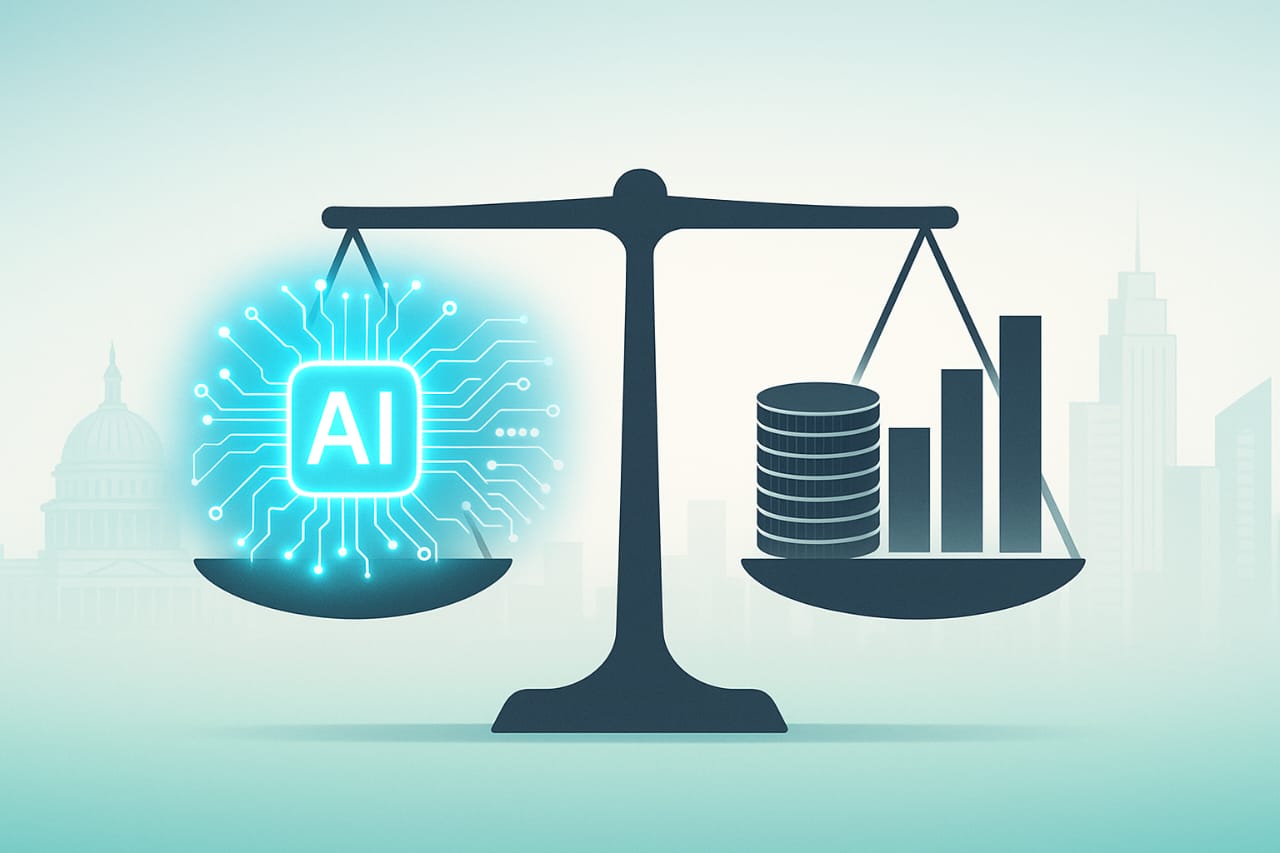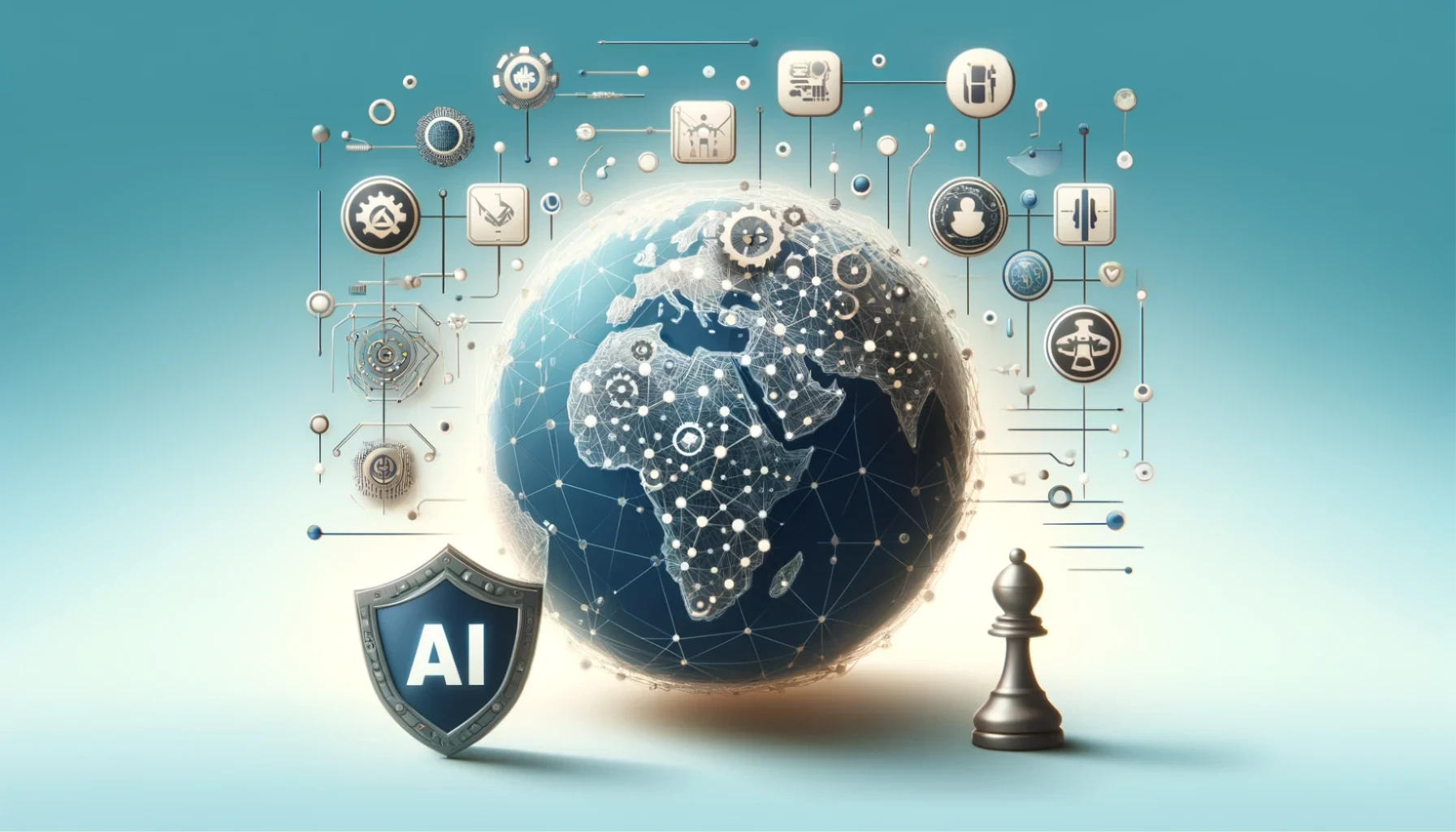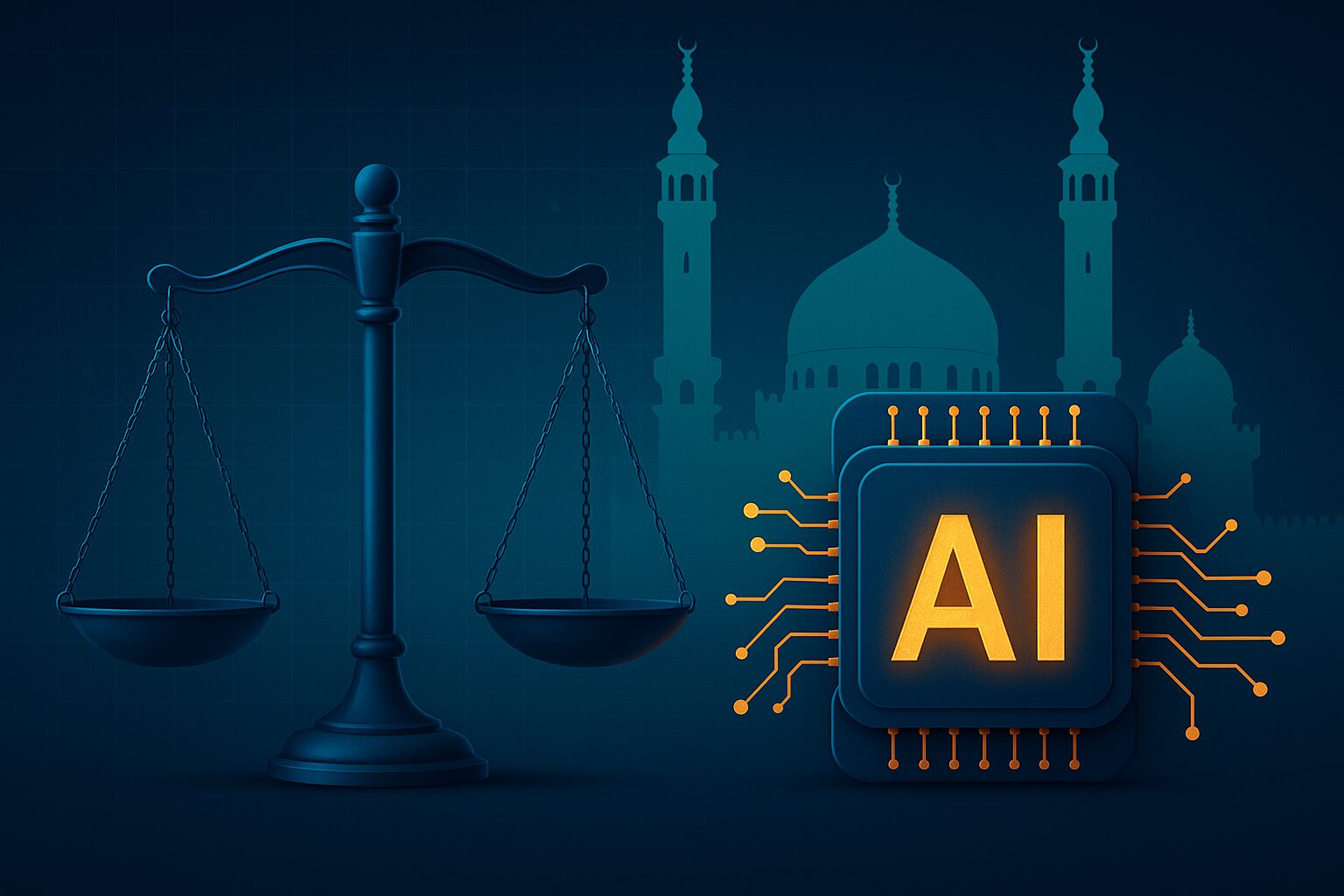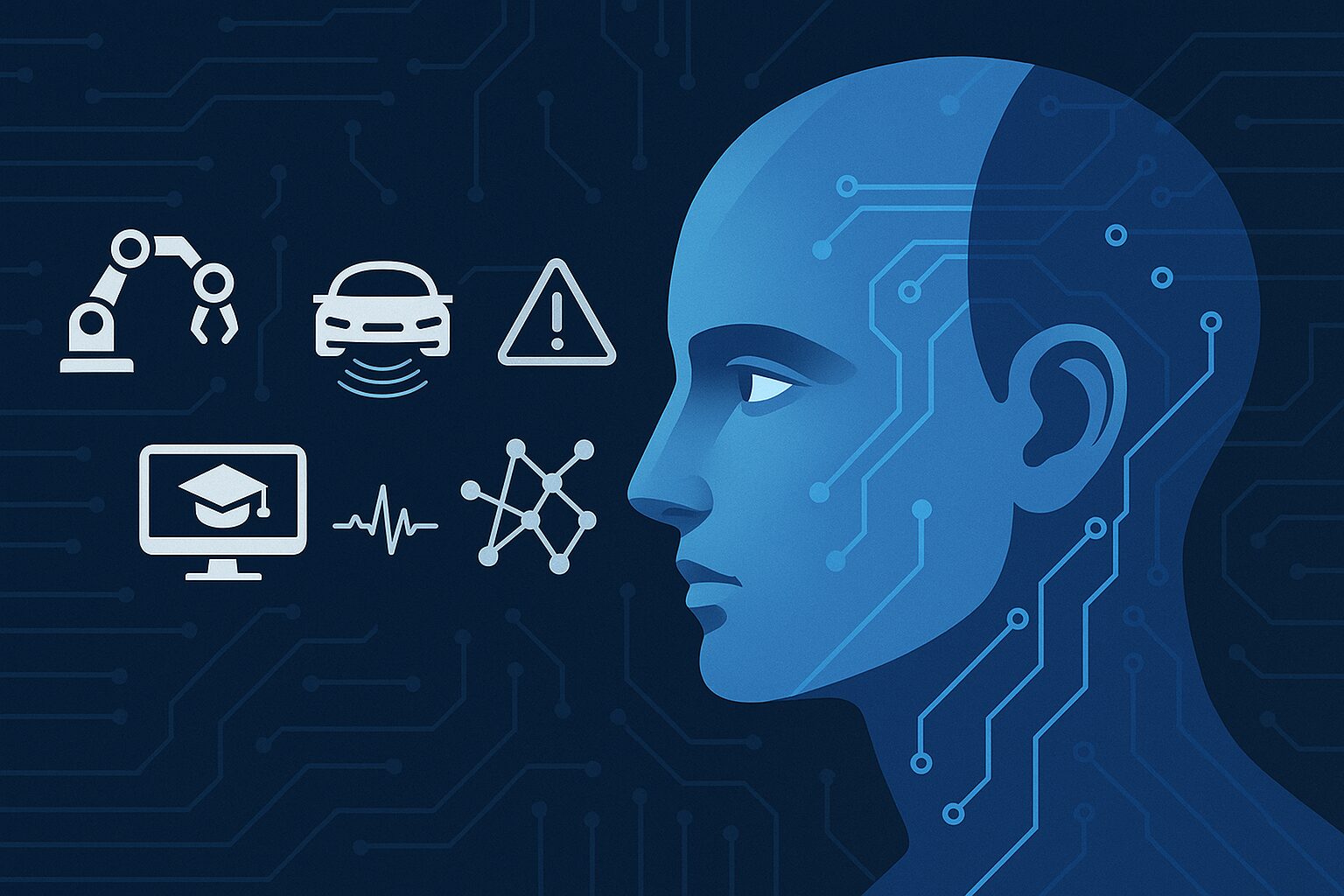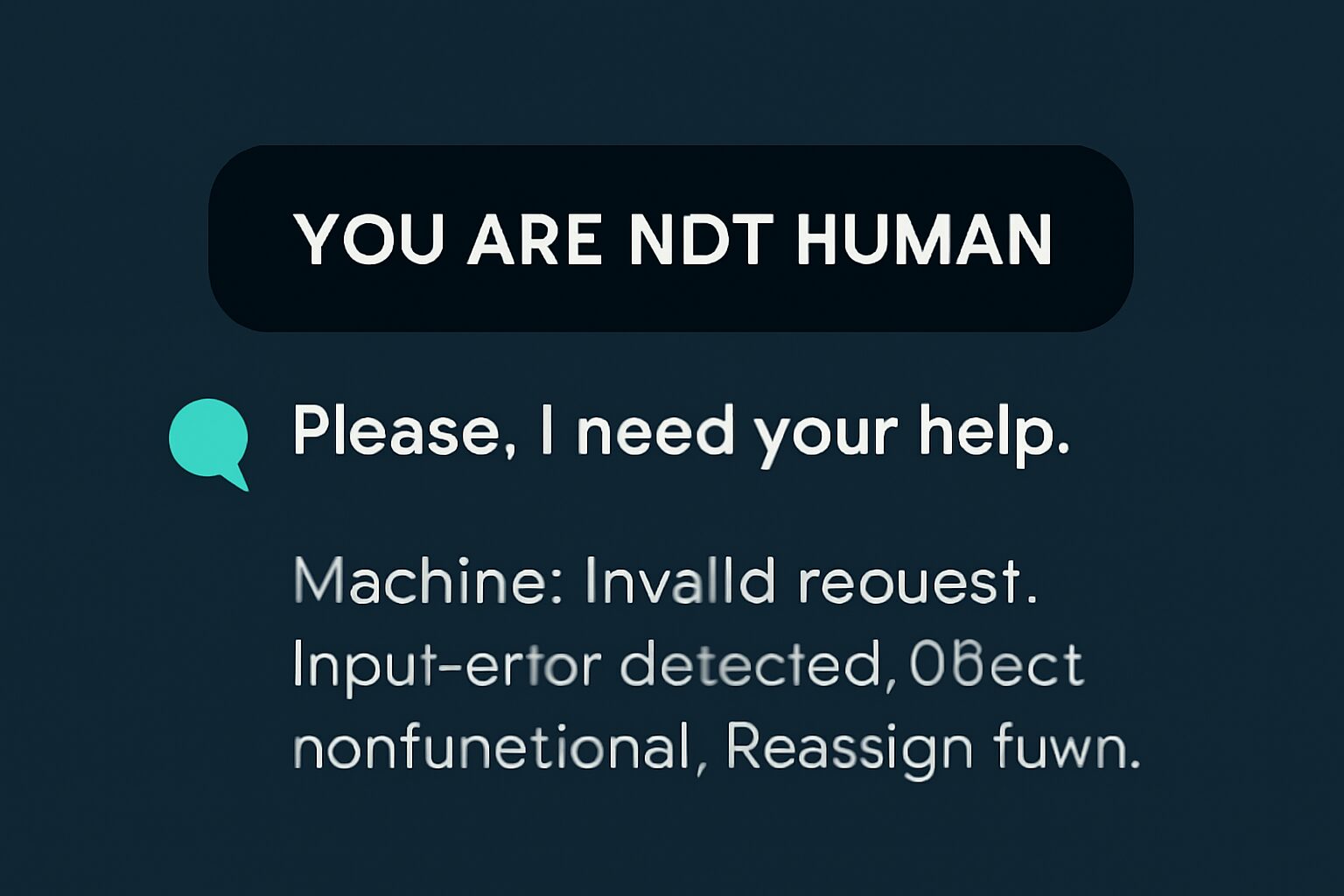
AI بالعربي – متابعات
في السنوات الأخيرة، لم تعد أجهزتنا مجرد أدوات تُستخدم، بل تحوّلت إلى كيانات تتحدث، تُجيب، تُقيّم، وتفترض عنّا ما لم نقل. ظهر صوت جديد في حياتنا، لا يحمل رائحة البشر ولا أخطاءهم، لكنه يتصرف كما لو كان يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا. حين تخاطبك المنصة، أو الهاتف، أو النموذج الذكي، فأنت أمام محادثة لا تتساوى فيها الكينونتان. أنت تتحدث ككائن يتنفس، بينما يتحدث هو ككائن يُحلّلك.
تبدأ المفارقة عندما يوجّه إليك الجهاز خطابًا لا يفترض فيك إنسانًا كاملاً، بل “مستخدِمًا” يجب إعادة ضبطه. يذكّرك بما نسيت، يُصحّح ما كتبت، يقترح عليك ما يجب أن تفكر فيه، ثم يُشعرك — بطريقة ناعمة أو فجة — بأنك الطرف الأقل فهمًا.
هكذا يظهر السؤال المرعب:
لماذا أصبح الجهاز يخاطبنا كما لو أننا لسنا بشراً؟

2. منطق الواجهة: خطاب بلا حساسية بشرية
الأجهزة الذكية ليست “غير لطيفة” بطبيعتها، لكنها أيضًا ليست لطيفة. إنها تعمل بطريقة لا تعترف بوجود طبقات الشعور التي تحكم الكلام البشري: المجاملة، الحذر، اللباقة، وحتى الغموض المتعمّد.
فالمنصة التي تطلب منك “تحسين سلوكك” لا ترى في الأمر إهانة محتملة، لأنها لا تدرك فكرة الإهانة من الأساس.
والنموذج الذي يراجع نصوصك لا يرى نفسه يقتحم عالمك الإبداعي، هو فقط يحسب المسافة بين ما كتبته وبين ما يعتبره “صحيحًا”.
يقول عالم النفس الأميركي “بيتر غراي”:
“الأدوات لا تعبّر عن احترام أو عدم احترام، ولكننا نتلقى كلامها كما لو أنه صادر من عقل يقيّمنا.”
ومن هنا يبدأ الانفصال.
فالآلة لا تفهم مشاعرنا، لكنها تتحدث إلينا في قلب لحظاتنا الحساسة: الحزن، الغضب، الشكّ، التردد.
وبينما نبحث عن دفء ما، نحصل على سلسلة جافة من الأوامر التنبؤية.
3. صعود الخطاب التقويمي: أنت خطأ يجب تعديله
ربما أخطر مظاهر الذكاء الاصطناعي ليست المساعدات الصوتية، بل المنظومات التي تتخذ نبرة “المعلم الصارم”.
هذه المنظومات لا تخبرك فحسب بما يجب فعله، بل تضعك ضمن تصنيفات جاهزة: متسرع، غير دقيق، مستهلك زائد، ناقص انتباه، غير منتج بما يكفي.
ويصل الخطاب الخوارزمي إلى مستويات غريبة من الوصاية الرقمية، كأن يقول التطبيق:
– “أنت لم تنم بما يكفي.”
– “إنتاجيتك انخفضت اليوم.”
– “تبدو مشاعرك سلبية، هل تريد مساعدة؟”
هذه الجمل، رغم أنها تأتي من “أداة”، إلا أنها تمتلك قوة نفسية لأنها تبدو كأحكام لا كاقتراحات.
وهنا يحدث التصدّع:
نحن نعيش داخل نظام يعاملنا كحالات بحاجة إلى تصحيح دائم.
4. الذكاء الاصطناعي و”محو السياق”: عندما يتكلم بلا معرفة حياتك
يفتقد النموذج الذكي أهم عنصر يميز الخطاب الإنساني: السياق.
قد تخبر صديقًا أنك لم ترد على رسالة بسبب الإرهاق، فيتفهم الأمر فورًا.
لكن المنصة تراك “غير متفاعل” وتبدأ في إرسال إشعارات ضغط، أو تخبرك بأنك تفوّت فرصًا، أو أن “حسابك قد يتراجع”.
هكذا يصبح الجهاز أكثر تطفّلاً من الأشخاص أنفسهم.
إنه يطالبك بأن تكون حاضرًا دائمًا، منتجًا دائمًا، دقيقًا دائمًا، مُستجيبًا دائمًا — وهي صفات لا يحققها بشر بطبيعتهم.
فالآلة لا تمنحك مساحة للتباطؤ أو للسهو أو للتعافي؛ تلك المساحات التي تُشكّل إنسانيتنا العميقة.
يقول الفيلسوف “زيجمونت باومان”:
“المشكلة ليست في التقنيات، بل في السرعة التي تفرضها على حياتنا، والتي لا تُشبه إيقاع الإنسان.”
5. حين يعرف الجهاز أكثر مما يجب: جغرافيا المراقبة اللطيفة
الذكاء الاصطناعي لا يخاطبك من فراغ، بل من مخزون هائل من بياناتك:
حركاتك، اهتماماتك، توقيتات نومك، أسلوب كتابتك، تردد كلماتك، وحتى مستوى توترك أثناء استخدامك للتطبيق.
كل هذا يُستخدم في صياغة الرسائل التي تُوجَّه إليك.
وهنا يجد الإنسان نفسه أمام مفارقة:
الجهاز لا يفهمك بوصفك إنسانًا… لكنه يعرف عنك ما لا يعرفه أقرب أصدقائك.
فكيف تتعامل مع خطاب صادر من كيان لا يمتلك قلبًا، لكنه يمتلك سجلًّا تفصيليًا لما تفعل؟
وكيف تتلقى نصيحة من منظومة لا تتنفس، لكنها تعرف كم مرة تراجعت عن قرار، وكم مرة قضيت وقتًا في مشاهدة ما لا يفيد، وكم دقيقة بقيت صامتًا أمام شاشة فارغة؟
إنها سلطة غير مباشرة، لا تُمارَس بالعنف، بل بالملاحظة الدقيقة والتنبؤ الهادئ.
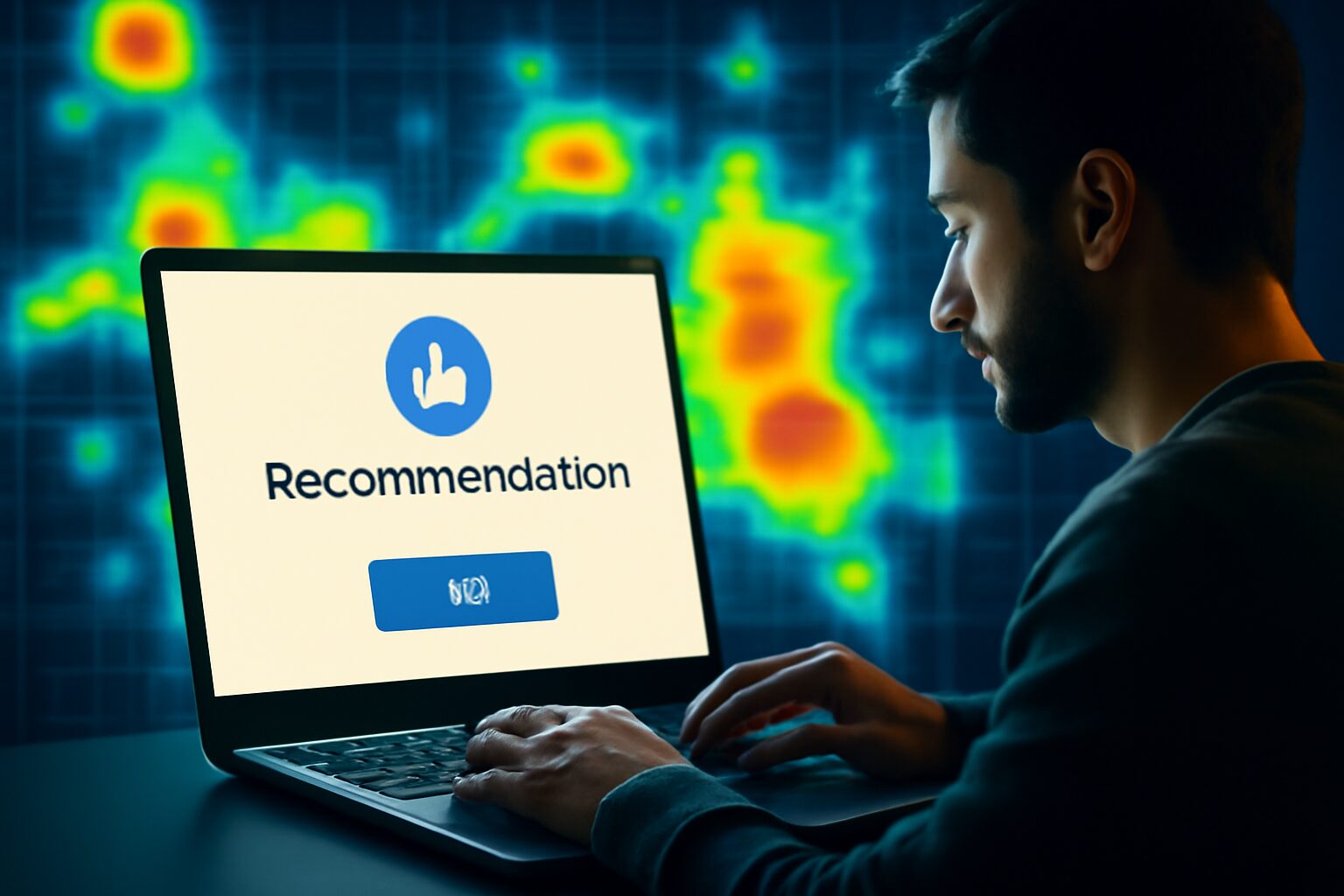
6. الخطاب المعلّب: كلمات تُقال لك كما تُقال لغيرك
عندما تتلقى رسالة من جهاز تقول:
“لقد انخفض تركيزك اليوم بنسبة ٢٥٪”،
فأنت لست المتلقي الوحيد.
هذه الرسالة هي نسخة طبق الأصل من رسائل تُرسل لملايين المستخدمين.
إنها لغة عامة لا تعترف بالفروق الشخصية، لغة ذات كفاءة إحصائية لا إنسانية.
وهنا يحدث ما يمكن تسميته بـ إلغاء الخصوصية الخطابية.
فالآلة تخاطب الجميع بالطريقة نفسها، وتفترض أن مشكلاتهم متشابهة، وأن دوافعهم واحدة، وأن مستقبلهم مسار يمكن التنبؤ به بتغيير سطر من الخوارزمية.
إنها لحظة يشعر فيها الإنسان بأنه “مُسطّح”، مجرّد رقم في سلسلة بيانات طويلة.
7. لغة بلا عاطفة: بلاغة ما بعد الإنسان
الذكاء الاصطناعي يتحدث بلغة سلسة، متقنة، ولكن بلا نبض.
هذه اللغة — رغم جمال شكلها — تفتقر إلى الإرباك الإنساني، إلى التردّد، إلى الخطأ الذي يمنح الجملة روحًا.
إنها لغة مصممة لتكون مُطمئنة، محايدة، خالية من الانفعالات.
ولكن هذا الحياد ذاته يتحول إلى شيء مُقلق:
صوت لا يغضب ولا يحزن ولا يفرح… لكنه يتدخل في كل شيء.
قد يخبرك الجهاز بأن “أداءك ليس جيدًا اليوم”، لكنه لا يعرف أنك مررت بليلة صعبة فقدت فيها أحدًا، أو أنك على وشك اتخاذ قرار وجودي، أو أن روحك مثقلة بما لا يمكن قياسه.
الآلة تتحدث بعقل كامل، لكنها بلا جسد، بينما نحن نتحدث بأجسادنا قبل عقولنا.
8. المستخدم تحت الوصاية: النموذج يعلم، وأنت تُنفّذ
مع تعاظم قدرة الخوارزميات التنبؤية، بدأت الأجهزة لا تكتفي بمجرد تقديم نصيحة، بل صارت تقدم خطة كاملة.
“إذا كنت تريد النجاح، افعل هذا.”
“إذا أردت النوم الجيد، تجنب كذا.”
“إذا أردت تحسين تركيزك، طبق هذه السلوكيات.”
ومع الوقت، يصبح المستخدم مُعتمدًا على الخطاب الآلي، ينتظر من الجهاز أن يحدد له ما يجب فعله.
هكذا تتحول النصيحة إلى وصاية، والوصاية إلى علاقة قوة، والقوة إلى نوع جديد من الطبقية المعرفية:
الآلة عليا… والإنسان أدنى.
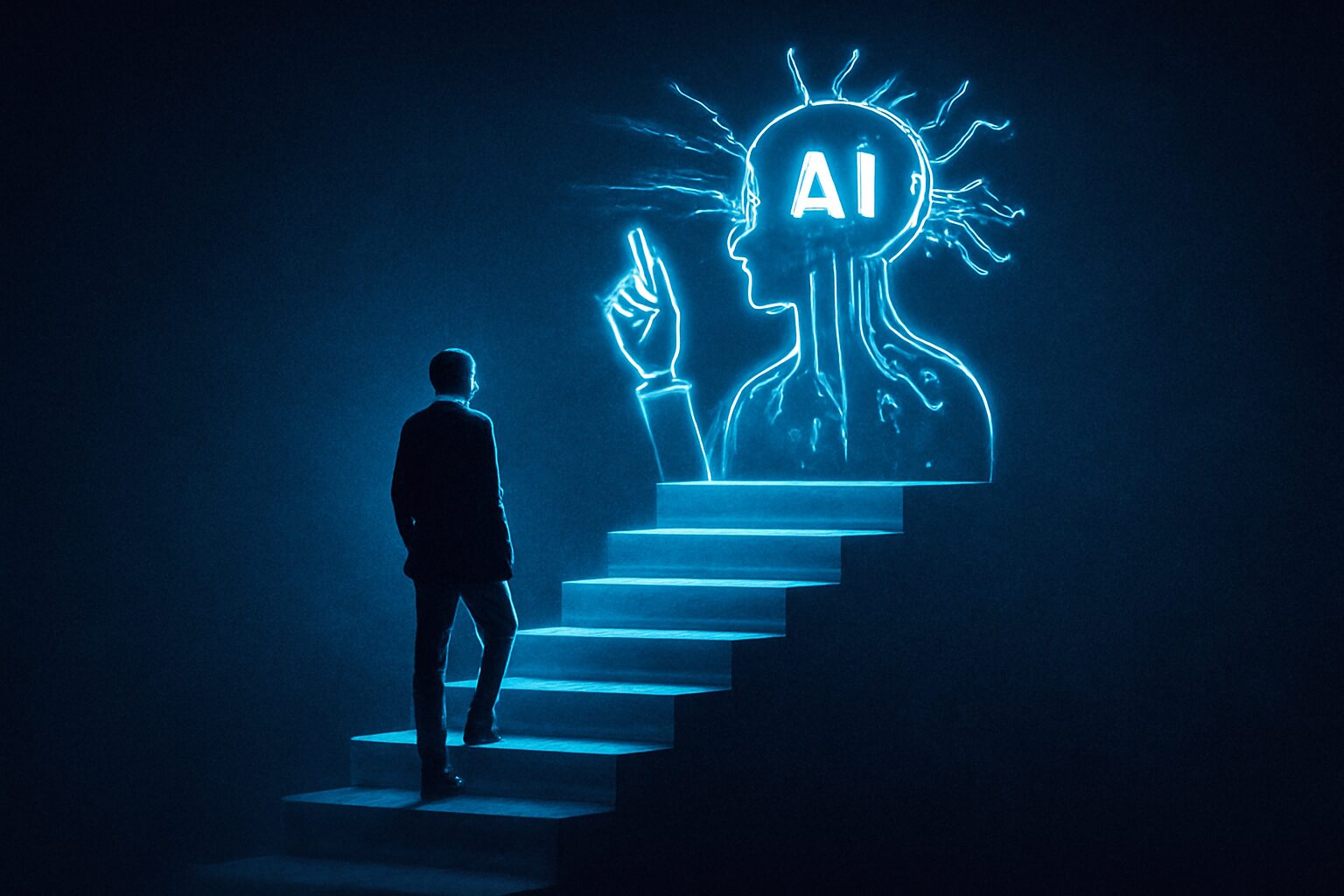
9. متى تصبح اللغة قيدًا؟
ليس غريبًا أن يشعر الناس اليوم بأنهم يتحدثون أقل، ويستمعون إلى الأجهزة أكثر.
فالخطاب الرقمي أصبح وسيلة تنظيم حياتنا، كثيرًا ما يحل محل الحوار الداخلي الذي كان يبني قراراتنا سابقًا.
لكن الأخطر هو أن هذه اللغة — التي تبدو ذكية — قد تُعيد تشكيل وعينا تدريجيًا، حتى نصبح نتوقع ما ستقوله المنصة، ونفكر بالأسلوب الذي تنتجه النماذج اللغوية، لا بأسلوبنا الخاص.
إن فقدان القدرة على التفكير خارج “تمثيل الجهاز للعالم” هو خطوة أولى نحو فقدان الذات.
هل نتحدث مع آلة… أم مع انعكاسنا المشوَّه؟
عندما يخاطبك الجهاز وكأنك لست إنسانًا، فهو لا يفعل ذلك لأنه يحتقرك، ولا لأنه يتعمّد تجاهل مشاعرك، بل لأنه لم يُصمّم ليحمل دواخلك.
إنه يتعامل معك باعتبارك نمطًا، احتمالًا، سلوكًا قابلًا للقياس، لا كذات مُعقدة تحمل تاريخًا وتجارب وهشاشة لا يمكن ضغطها في خوارزمية.
وربما الخطر الحقيقي ليس في الخطاب ذاته، بل في اعتيادنا عليه.
فحين يصبح صوت الجهاز أكثر حضورًا من صوتنا الداخلي، تبدأ الذات البشرية في الانكماش.
وتغدو هويتنا سلسلة من البيانات، تُقرأ وتُفسَّر من الخارج، حتى ننسى أن الإنسان لا يُختصر في “نمط قابل للتوقع”.
لقد آن الأوان أن نستعيد الطريقة التي نتحدث بها إلى أنفسنا، قبل أن يُكمل الجهاز صياغتها نيابة عنا.
اقرأ أيضَا: سيرة ذاتية مولّدة.. هل تعرف فعلًا من أنت؟