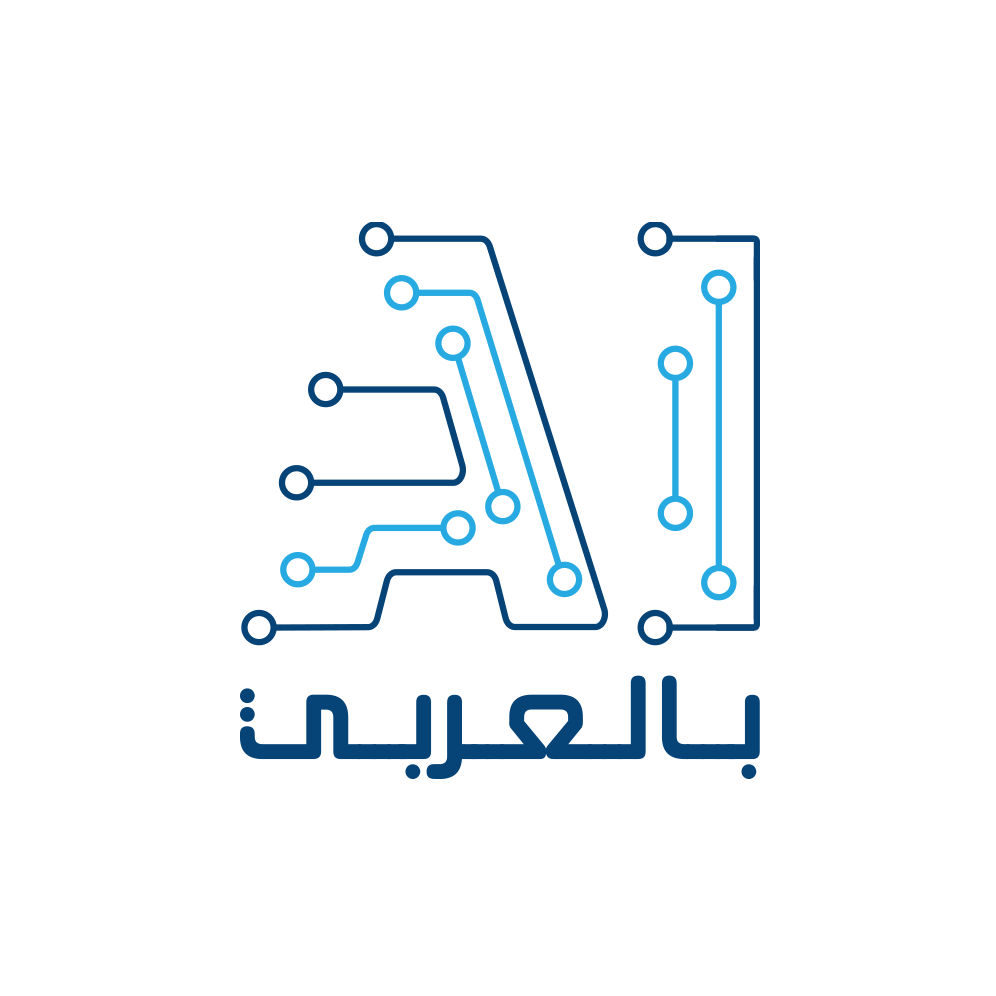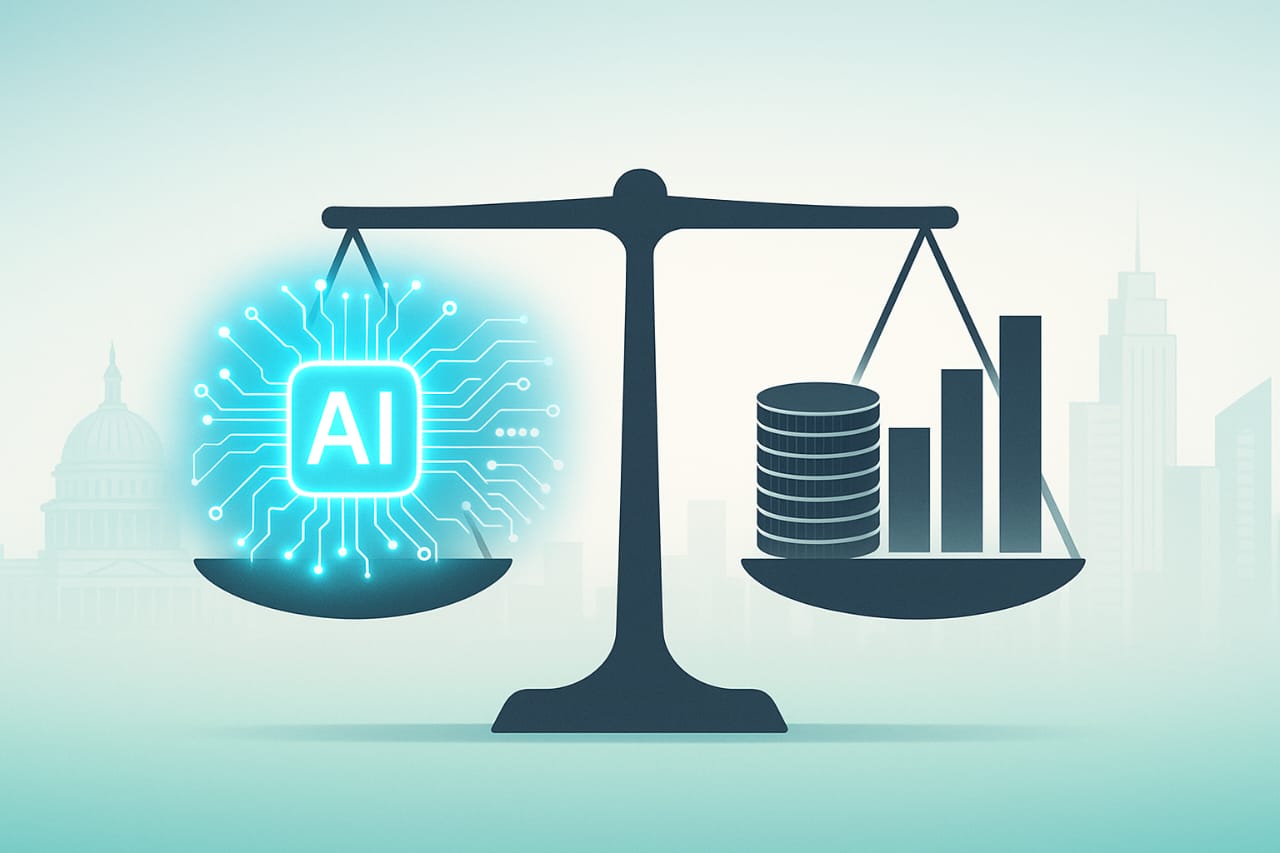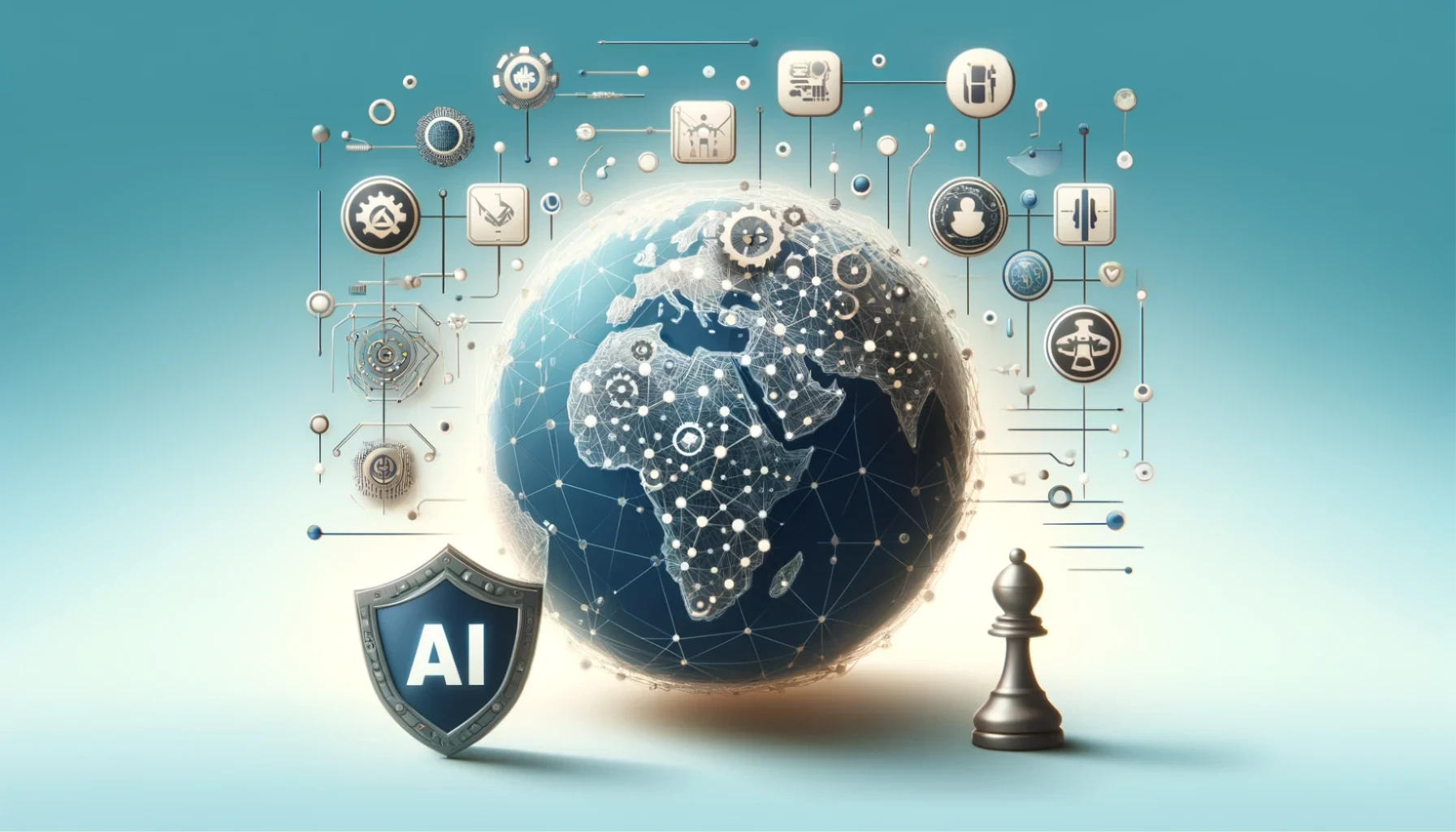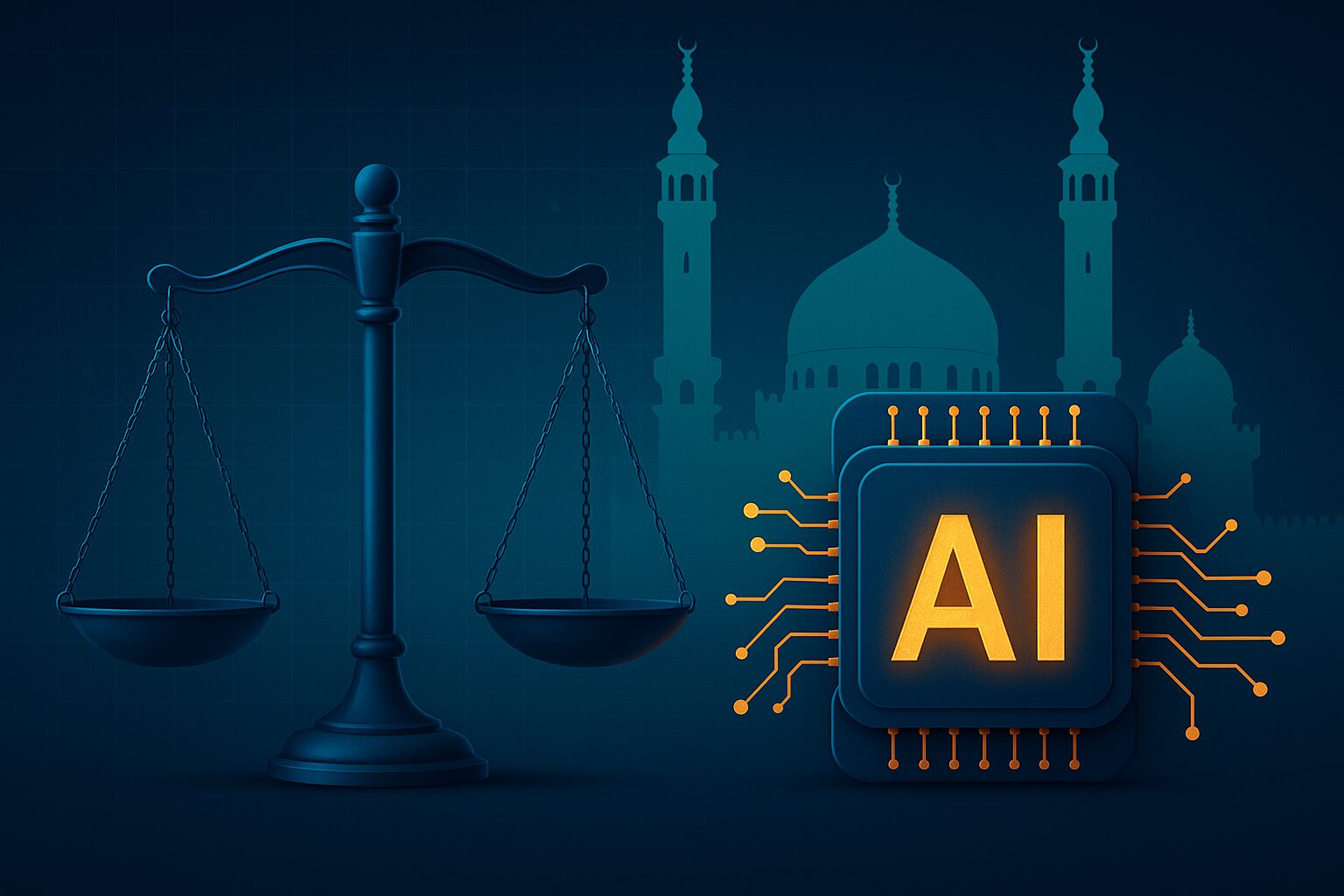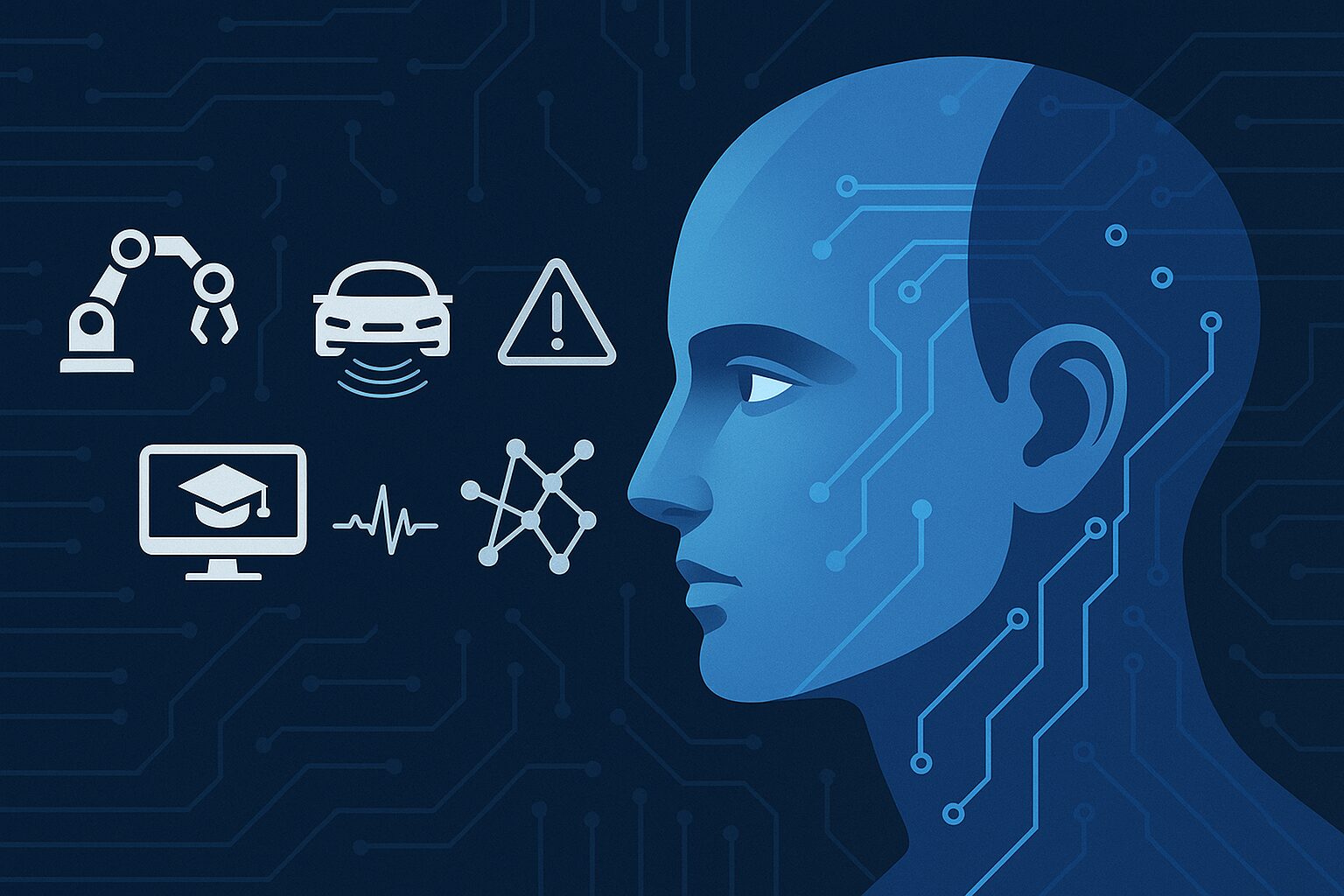AI بالعربي – متابعات
كما هو معلوم، فإن كومبيوتر “ألفا غو زيرو” AlphaGo Zero – الذي أنتجه مختبر أبحاث “الذكاء الاصطناعي” في المملكة المتحدة “ديب مايند” Deep Mind – قد تغلب على أبطال البشر في لعبتي “غو” Go والشطرنج Chess. زود بقواعد اللعبتين فقط، و”تدرب” من خلال خوض ملايين المباريات ضد نفسه في غضون ساعات قليلة. يعود الفضل في تحقيق هذه الإنجازات الخارقة إلى السرعة الفائقة وقدرة التخزين الكبيرة للذاكرة الحاسوبية لا إلى الأدمغة البشرية.
وفي ضوء ذلك، يمكن لـ”الذكاء الاصطناعي“، بفضل سرعة معالجته المتزايدة باستمرار، التعامل بشكل أفضل من البشر مع الشبكات الغنية بالبيانات والمتغيرة بسرعة. أما عن الآثار المترتبة عن ذلك فهي واضحة بشكل جلي في مجتمعاتنا. فعلى سبيل المثال، عندما يصدر حكم بالسجن ضدنا، أو ننصح بإجراء عملية جراحية، أو نعطى تصنيفاً ائتمانياً ضعيفاً، نتوقع أن نكون على دراية بالأسباب التي أدت إلى مثل تلك الأمور، وأن تكون لدينا القدرة على الاحتجاج أو الطعن فيها، لكن، إذا ما فوضت هذه القرارات بالكامل للخوارزميات، فيصبح مفهوماً إن نشعر بقلق تجاه ذلك، حتى وإن قدمت لنا أدلة مقنعة تثبت أن الآلات تتخذ قرارات أفضل من البشر، بشكل عام.
ليس هناك شك في أن “الذكاء الاصطناعي” سيصبح أكثر تدخلاً وأوسع انتشاراً. فجميع سجلات حركتنا وبياناتنا الصحية ومعاملاتنا المالية، موجودة في سحابة إلكترونية تديرها شركة متعددة الجنسية شبه احتكارية. ويمكن استخدام هذه البيانات لأسباب حميدة (على سبيل المثال، للأبحاث الطبية، أو لتنبيهنا إلى مخاطر صحية وشيكة)، لكن توافرها لدى شركات الإنترنت يحول ميزان القوى من الحكومات إلى تلك التكتلات العالمية.
من الواضح أن معظم عمليات التصنيع والتوزيع ستتم بواسطة الآلات. ويمكنها استكمال، إن لم يكن استبدال عدد كبير من العمال ذوي الياقات البيضاء (الذين يعملون في المكاتب) مثل الموظفين في مجال المحاسبة وترميز الكومبيوتر والتشخيص الطبي وحتى الجراحة. أعتقد في الواقع أن ظهور “تشات جي بي تي” ChatGPT – الذي أصبح موضوعاً ساخناً رئيساً في الأشهر الأخيرة – يجعل الأعمال القانونية معرضة للخطر بشكل خاص، بحيث بات يمكن للآلة الآن استيعاب كميات كبيرة من المؤلفات القانونية المستقلة بمفردها.
من ناحية أخرى، ستكون بعض الوظائف الفنية في قطاع الخدمات، مثل السباكة والبستنة التي تتطلب تفاعلات غير روتينية مع العالم الخارجي، من بين أصعب الوظائف التي يمكن أن تشغل آليا.
لا شك في أن الثورة الرقمية تدر ثروة هائلة على المبتكرين والشركات العالمية، لكن من أجل الحفاظ على مجتمع صحي ومستدام، يتعين إعادة توزيع هذه الثروة. وفي الواقع، يتطلب بناء مجتمع إنساني تدخل الحكومات لزيادة عدد الموظفين الذين يعتنون بالمسنين والأطفال والمرضى، وتعزيز مكانتهم في المجتمع. في الوقت الراهن، هناك عدد قليل جداً من هؤلاء العمال، وهم يتقاضون رواتب منخفضة، ولا يحظون بالتقدير المناسب، ولا يشعرون بالأمان الوظيفي.
تتعلم أجهزة الكومبيوتر التعرف على الكلاب والقطط والوجوه البشرية من خلال “سبر” ملايين الصور، وليس بالطريقة التي يتعلم بها الأطفال. ويتم تدريب “تشات جي بي تي” من خلال “قراءة” جميع الكلمات الموجودة على الإنترنت، وتعلم طريقة ارتباط بعضها بالبعض الآخر لتكوين جمل، لكنه “يفهم” الكلمات فقط، وليس الأشياء.
من هنا فإن التوصل إلى فهم فعلي للعالم الحقيقي واكتساب ما يمكن الإشارة إليه بـ”الفطرة السليمة” سيشكل تحدياً لـ”الذكاء الاصطناعي”. فالأمر يتطلب مراقبة أشخاص حقيقيين في منازلهم أو في أماكن عملهم الفعلية. وستكون الآلة (أو “الذكاء الاصطناعي”) محدودة حسياً بسبب الوتيرة البطيئة نسبياً للحياة الواقعية، إذ ستبدو أنشطتنا اليومية، بالنسبة لها، رتيبة وهادئة، وتشبه مشاهدة الطلاء وهو يجف.
ولن تتمكن أجهزة الاستشعار الإلكترونية من أن تضاهي المستشعرات البيولوجية. وفي الواقع، لا تزال الروبوتات أكثر حماقة من الأطفال عندما يتعلق الأمر بتحريك القطع على رقعة شطرنج حقيقية. ولا يمكنها كذلك القفز من شجرة إلى أخرى كالسنجاب.
إذاً، ما الذي يجب أن يثير قلقنا أكثر حيال “الذكاء الاصطناعي”؟ من المؤكد أن “تشات جي بي تي” سيعرضنا بشكل كبير، للجوانب السلبية لأجهزة الكمبيوتر ووسائل التواصل الاجتماعي: كالصور الإخبارية المزيفة، ومقاطع الفيديو المضللة، والخطابات المتطرفة غير الخاضعة للرقابة، وغيرها من التحديات التي تواجهنا في البيئة الرقمية.
وكانت عناوين الصحف المثيرة قد اقتبست كلاماً هذا الأسبوع عن بعض الخبراء الذين تحدثوا عما سموه “انقراض البشرية”. قد تكون هناك مبالغة في هذه التصريحات، لكن من الواضح أن سوء استخدام “الذكاء الاصطناعي” يشكل تهديداً محتملاً على المستوى الاجتماعي، يوازي مستوى تهديد الأوبئة. إن ما يقلقني ليس سيناريو الخيال العلمي الذي يصور “سيطرة” فائقة من “الذكاء الاصطناعي” على البشرية، بمقدار المخاطر المرتبطة بتزايد اعتمادنا – كما البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للعالم بأسره – على الشبكات المترابطة، بحيث إنه إذا فشلت هذه الشبكات، كشبكة الكهرباء أو الإنترنت، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار مجتمعي واسع النطاق، ستكون له بلا شك عواقب عالمية.
المسألة تحتاج لوضع قواعد تنظيمية – إذ يتعين اختبار ابتكارات مثل “تشات جي بي تي” بدقة، قبل نشرها على نطاق واسع، شأنها شأن الاختبارات التي تجرى على الأدوية قبل إصدارها واعتمادها من قبل السلطات الحكومية. ومع ذلك، يشكل وضع القواعد التنظيمية تحدياً خاصاً في هذا القطاع الذي يهيمن عليه عدد قليل من التكتلات الضخمة متعددة الجنسية.
لكن دعونا ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك. فماذا لو طورت الآلة وعياً مستقلاً؟ هل تبقى طيعة أم تتصرف “على سجيتها” خارج إطارها البرمجي؟ يسلط أدب الخيال العلمي الضوء على “الجانب المظلم” لهذه التكنولوجيا، مشيراً إلى التداعيات والعواقب السلبية المحتملة التي قد تنشأ عن التكنولوجيا المتقدمة، بحيث يخرج “الذكاء الاصطناعي” عن حدوده، ويتسلل إلى الإنترنت، ويسعى إلى تحقيق أهداف قد لا تتوافق ومصلحة الجنس البشري.
وفي الوقت الذي يأخذ فيه بعض خبراء “الذكاء الاصطناعي” هذا الجانب على محمل الجد، يرى آخرون مثل رودني بروكس (مخترع روبوت “باكستر” Baxter متعدد الاستخدام)، أن هذه المخاوف هي سابقة لأوانها، ويعتقدون أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يصبح “الذكاء الاصطناعي” مصدر قلق أكبر، مقارنة بالعيوب والقيود الحقيقية للعقل البشري.
أنا شخصياً أعتقد أن من المحتمل أن تحقق الآلات السيادة في عصر ما بعد الإنسان، وذلك يعود في المقام الأول إلى القيود المتأصلة في الحجم وقدرات المعالجة للأدمغة العضوية “الرطبة” التي تحكمها العوامل الكيماوية والأيضية. وربما بتنا قريبين بالفعل من تلك الحدود.
ووفق أي تعريف “للتفكير”، فإن المقدار والشدة اللذين تعمل بموجبهما أدمغة الإنسان العضوية، ستطغى عليهما كلياً في المستقبل البعيد عقول “الذكاء الاصطناعي”. يضاف إلى ذلك أن المحيط الحيوي للأرض يظل بعيداً من أن يكون المكان الأمثل لـ”الذكاء الاصطناعي”، وسيكون الفضاء ما بين الكواكب والنجوم هو المجال المفضل لهذا الذكاء، بحيث يكون لدى المصنعين الآليين مجال أكبر للبناء، وحيث قد تطور “الأدمغة” غير البيولوجية رؤى تتجاوز بكثير تصوراتنا.
لكن يجب ألا نشعر نحن البشر بالدونية. فعلى رغم أننا لسنا بالتأكيد الفرع النهائي لشجرة التطور، فإننا قد نكون ذا أهمية كونية بشكل خاص، للبدء بالانتقال إلى كيانات قائمة على السيليكون (ربما تكون خالدة)، ونشر تأثيرها في آفاق أبعد من الأرض، تتجاوز حدودنا بشكل كبير.
المصدر: اندبندنت عربية