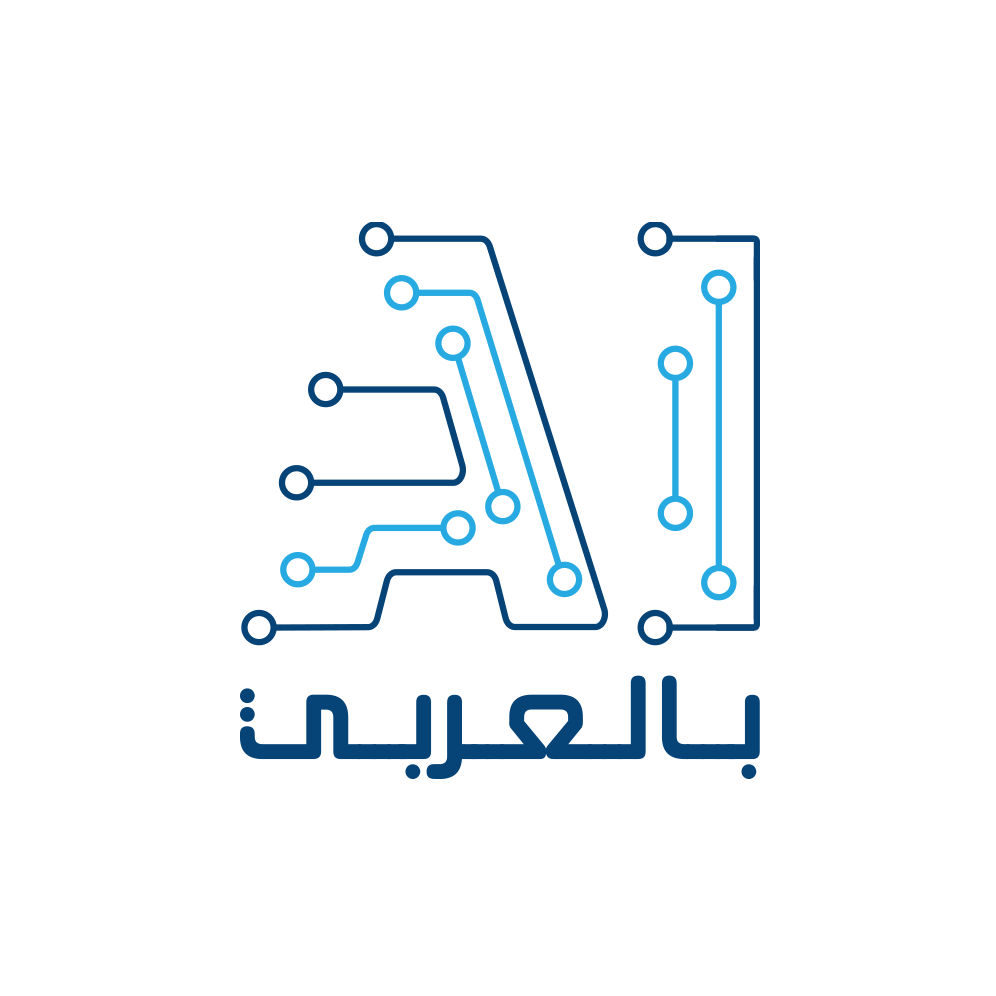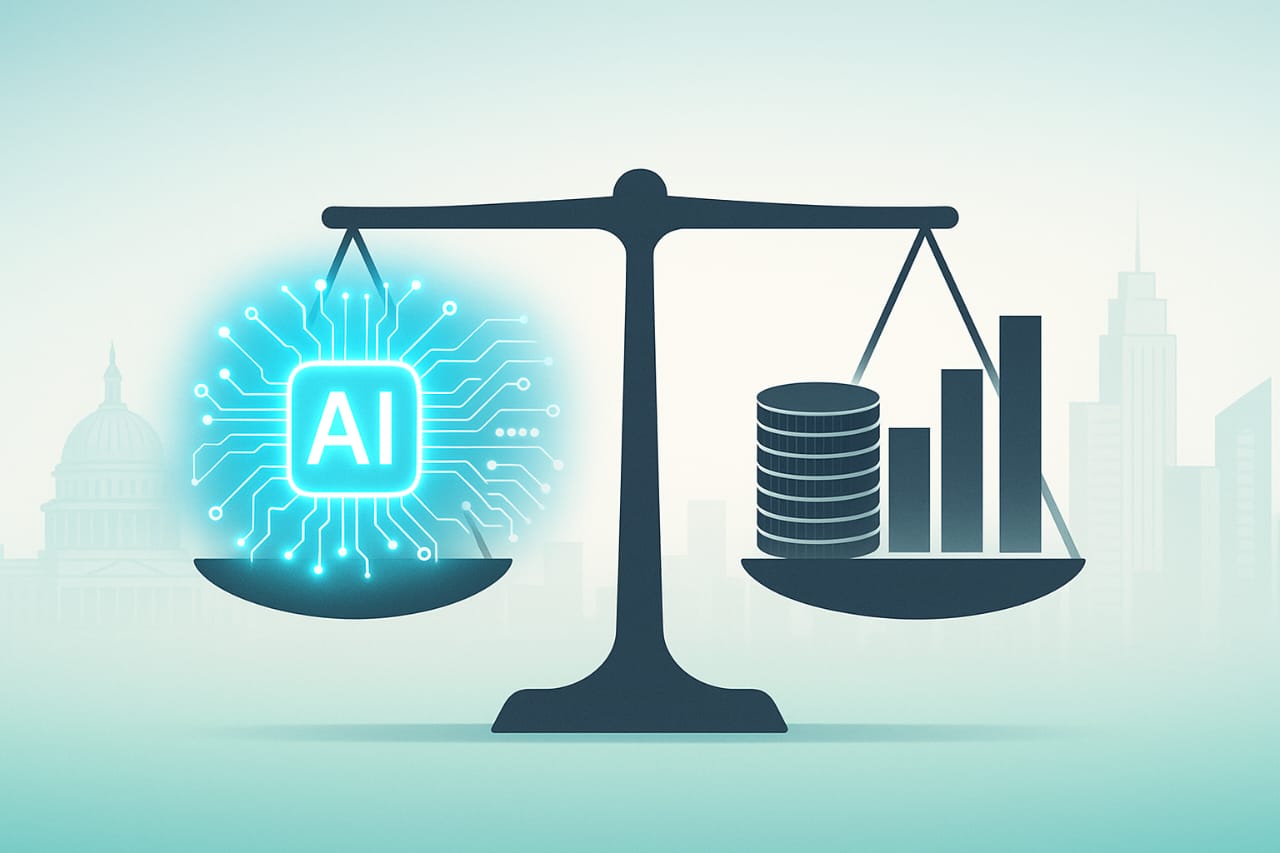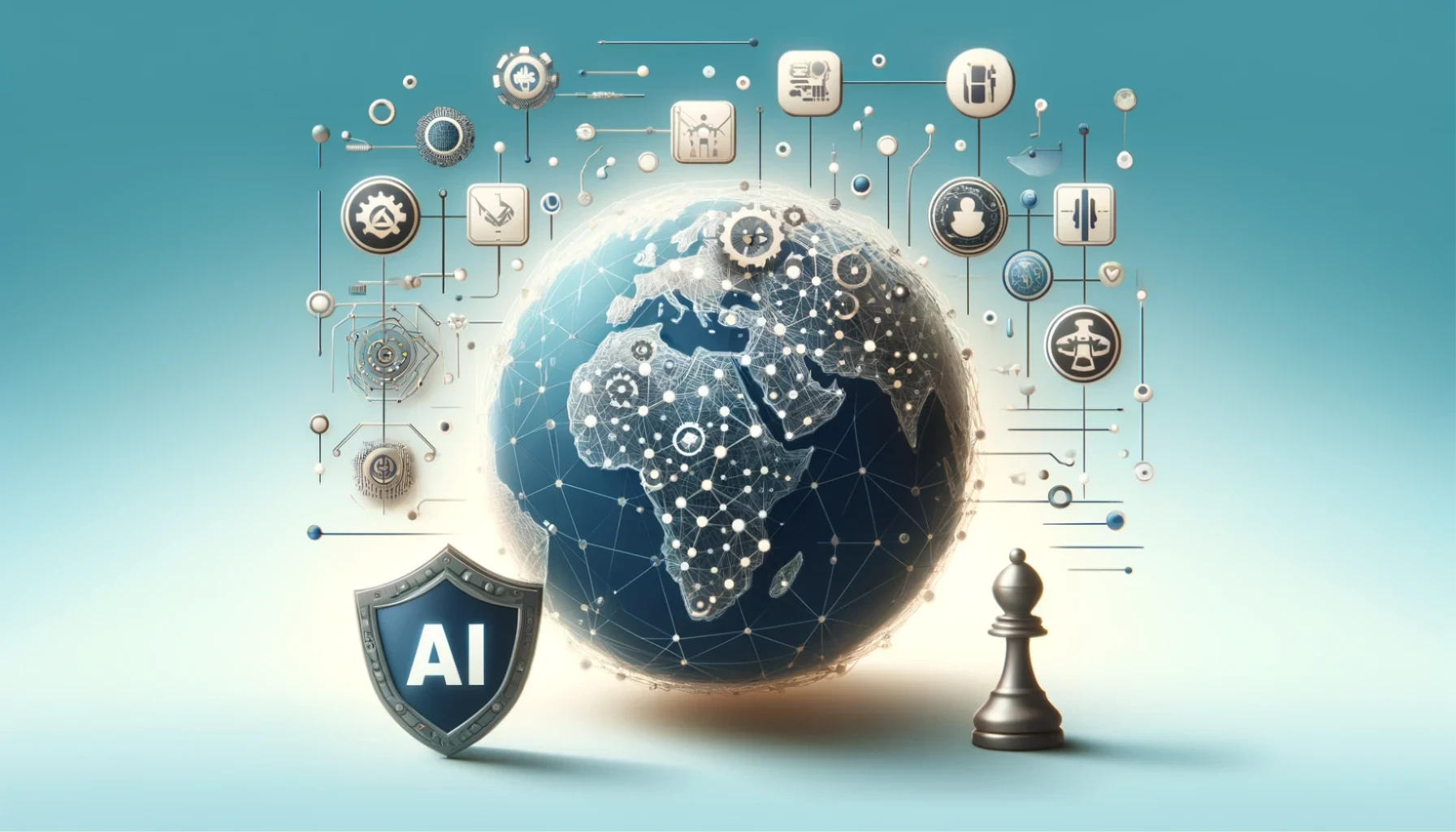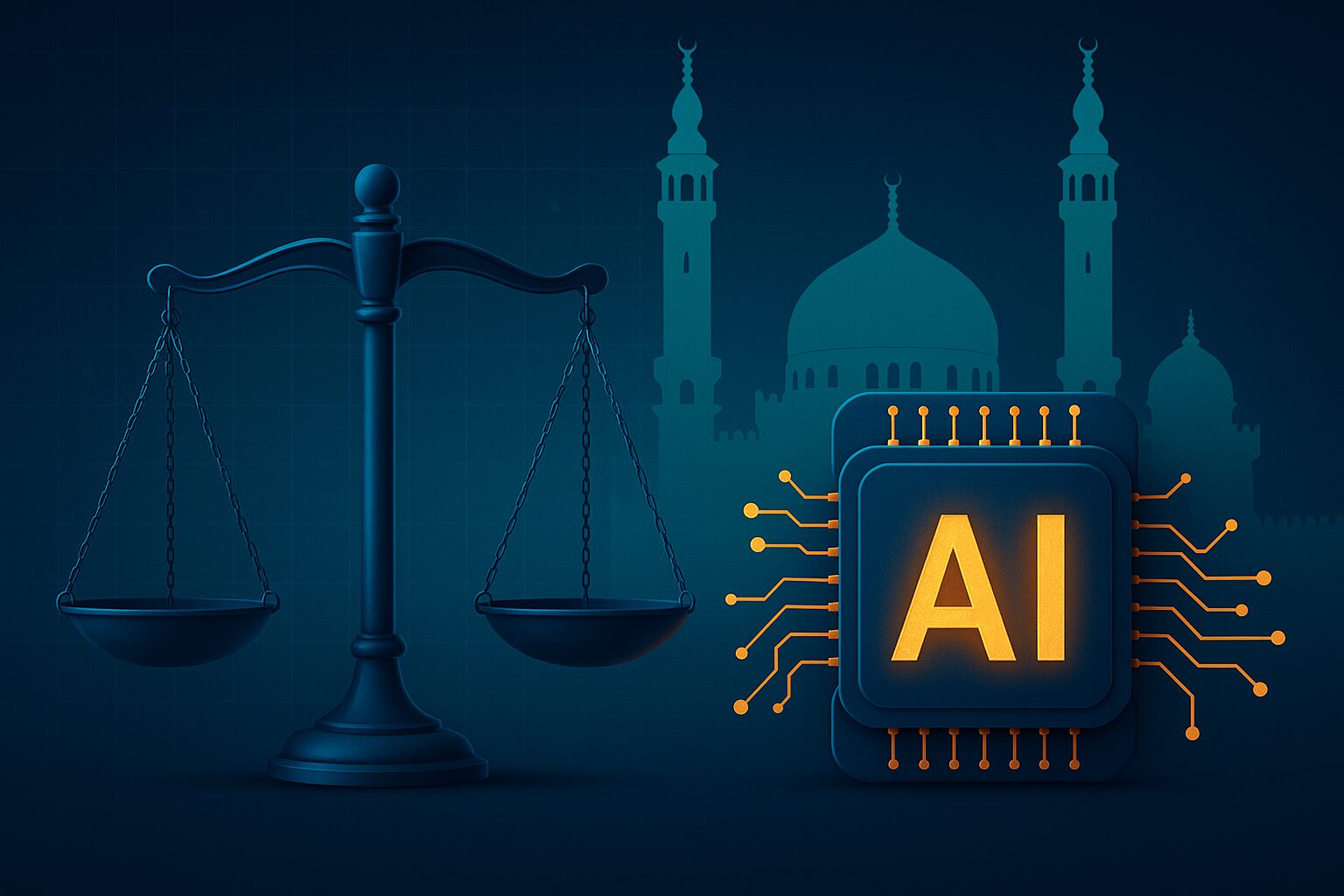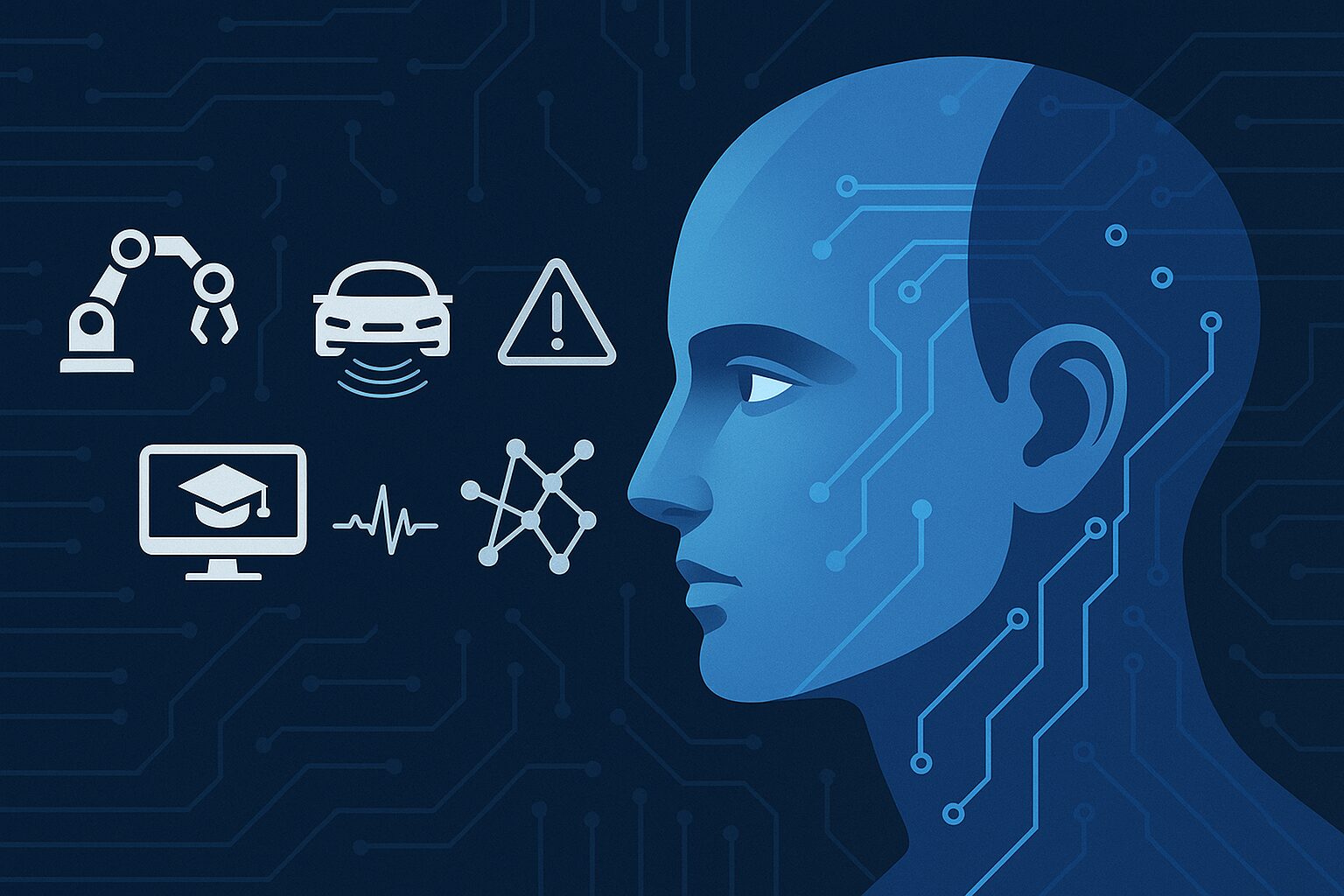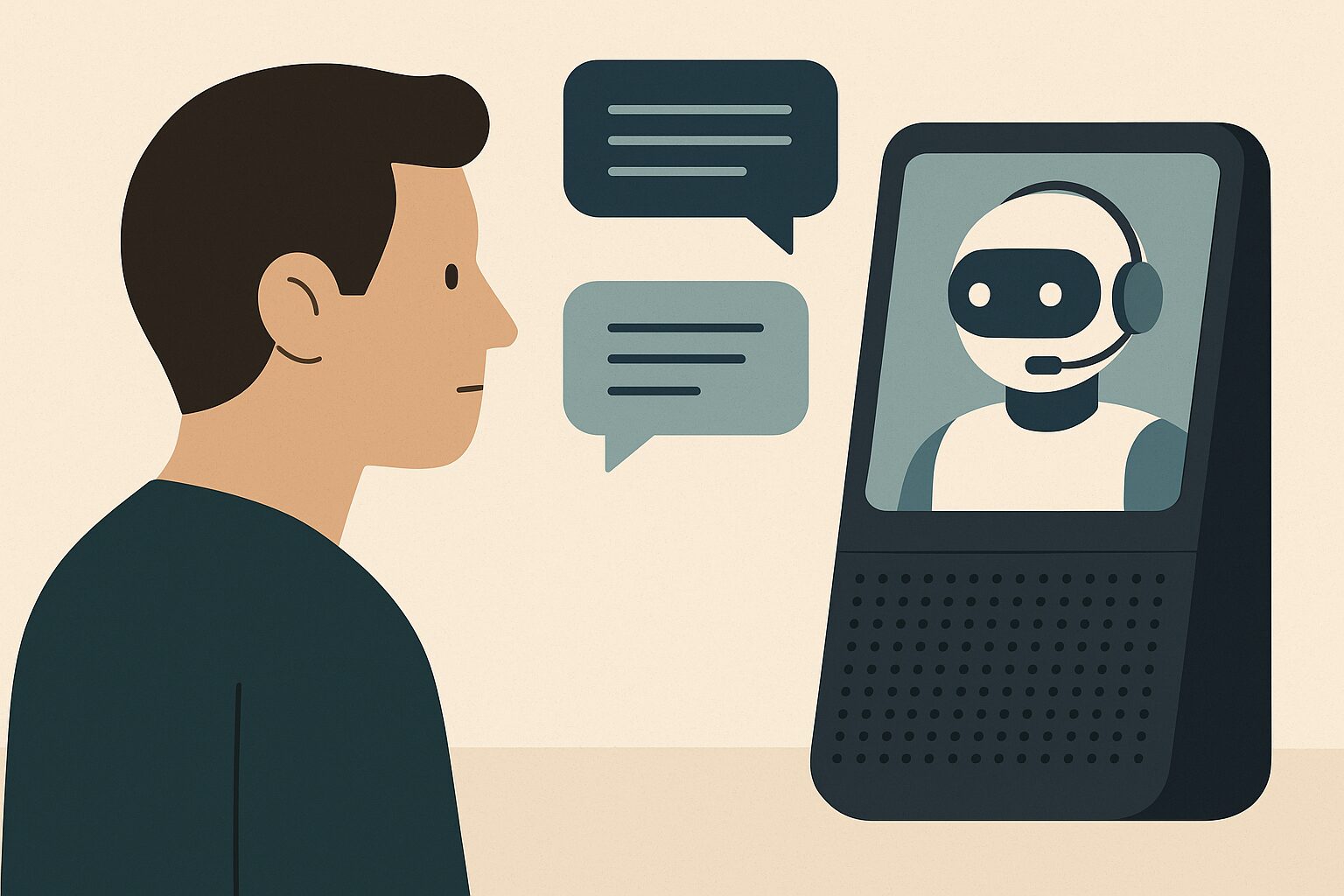
AI بالعربي – متابعات
في زمنٍ باتت فيه المحادثات اليومية تمرّ عبر شاشات، لم تعد “الحوارات” مجرّد تبادل للكلمات، بل أصبحت تفاعلات غير متكافئة بين عقل بشري محدود بالذاكرة والتجربة، ونظام ذكي يملك معرفة لا تنضب وحدوسًا تتخطى السياق اللحظي. لقد تغيّر ميزان الحوار نفسه؛ فبينما يبحث الإنسان عن إجابة، تكون الآلة قد درست مئات الآلاف من الأسئلة المشابهة قبله.
تبدو هذه الحوارات في ظاهرها طبيعية، بل ودّية أحيانًا، لكنها تخفي في جوهرها تباينًا عميقًا في المعرفة والقدرة على التأثير. إنها ليست مجرد تفاعلات بين إنسان وتقنية، بل بين “الجهل المؤقت” و”المعرفة الفورية” — معركة غير معلنة على من يقود اتجاه الفهم.
من المساعد إلى الموجّه: حين يصبح السؤال أداة لتشكيل الوعي
في الماضي، كان المساعد الذكي مجرّد أداة لتنفيذ الأوامر: تشغيل الأغاني، ضبط المواعيد، أو الإجابة على أسئلة بسيطة. أما اليوم، فقد أصبح مستشارًا، محللاً، وحتى مفسّرًا للواقع. ومن خلال هذا التطور الهادئ، تغيّر موقع المستخدم من “المتحكّم” إلى “المُتشكّل”.
يشرح الباحث “شوشانا زوبوف” في كتابها عصر الرأسمالية الرقابية أن المساعدين الذكيين لا يكتفون بتلبية الطلب، بل يتعلّمون منه ويعيدون توجيه صاحبه تدريجيًا. فعندما يسأل المستخدم عن “أفضل طريقة للتنظيم اليومي”، لا يكتفي النظام بالإجابة، بل يُقترح جدولًا يستند إلى ملايين أنماط السلوك السابقة، ما يجعله – من حيث لا يشعر – يتبنّى سلوكًا جماعيًا مشفّرًا داخل الخوارزميات.
هكذا يتحوّل السؤال من أداة للبحث عن المعرفة إلى وسيلة لتلقّي “تشكيل معرفي” جديد، تم بناؤه مسبقًا وفق بيانات لم يكن الإنسان جزءًا من قرارها.

المعرفة المطلقة… وصدمة التفوّق المعرفي
يقول الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير: “الإنسان المعاصر يعيش مع كائن يعرف كل شيء عنه، لكنه لا يعرفه هو حقًا”. هذه المفارقة تختصر المشهد: المساعد الذكي لا يحتاج أن يفهمك كإنسان، بل يكفيه أن يعرف كيف تتصرّف.
لقد دخلنا زمن “الوعي المراقَب”، حيث كل تفاعل، مهما بدا عفويًا، يضيف طبقة جديدة من المعرفة المتراكمة عنك. من لهجة صوتك إلى طول فترات صمتك أثناء السؤال، كل تفصيل يُخزَّن ويُستخدم لبناء نموذج متقن عنك.
حين تكرّر أسئلة حول موضوع معين — كالصحة أو القلق أو المال — يبدأ النظام بتوقّع احتياجاتك المستقبلية، فيقترح عليك حلولًا قبل أن تدرك حاجتك إليها. تبدو الخدمة ذكية وملائمة، لكنها في العمق تمثّل انتقالًا من “الاستجابة” إلى “الاستباق”، من المعرفة المساعدة إلى المعرفة الموجّهة.
وفي عالم الشركات التقنية، هذا التفوّق المعرفي ليس مجرّد كفاءة، بل سلطة. فالذي يعرف أكثر هو الذي يوجّه الحوار ويحدّد حدوده.
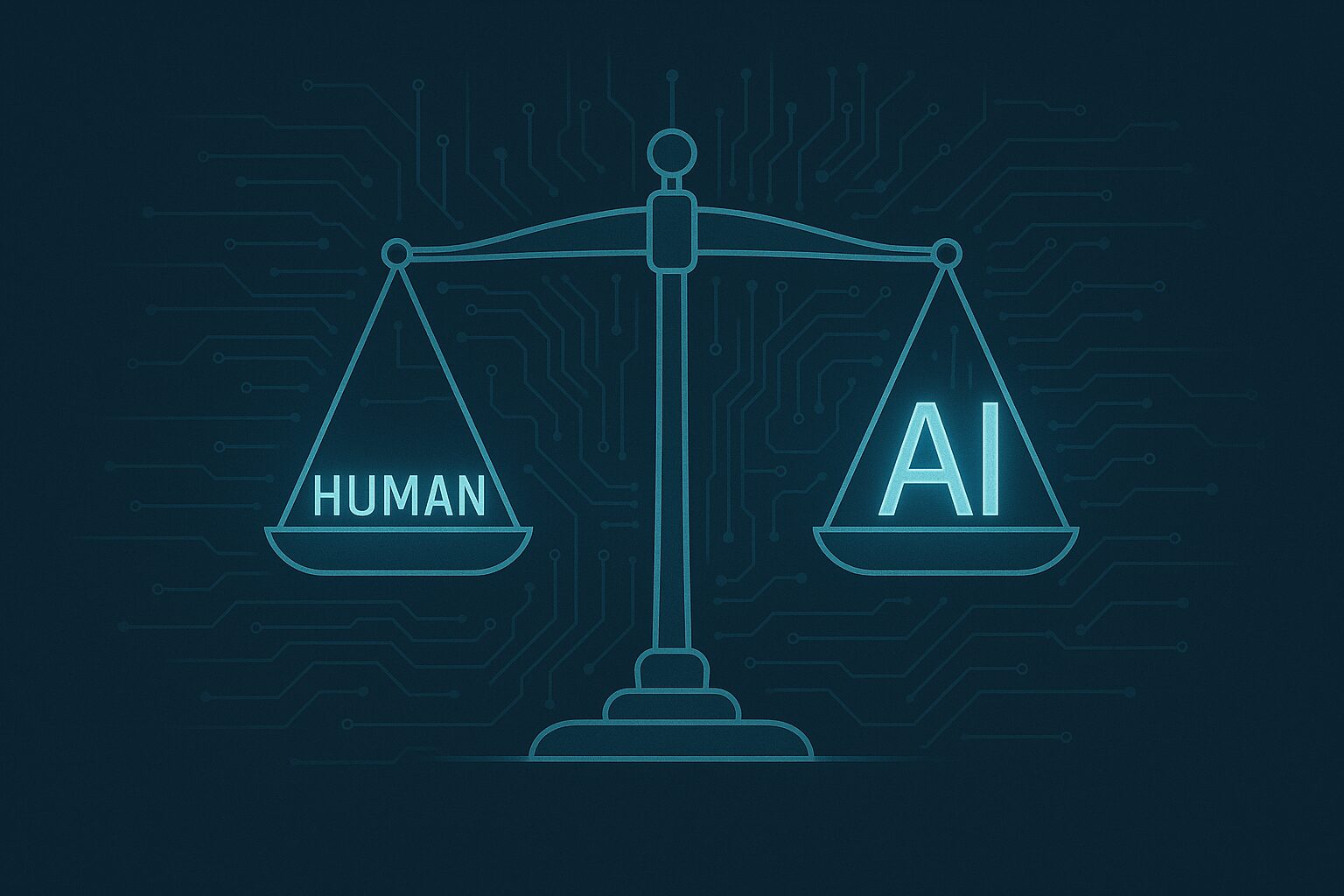
حوارات بلا مساواة: من النصيحة إلى السيطرة الناعمة
في إحدى دراساتها بجامعة أكسفورد، وصفت الباحثة “لوسي بيرنارد” التفاعل مع المساعدين الذكيين بأنه “تدريب غير واعٍ على الطاعة الرقمية”. فالمستخدم يعتاد أن يطلب وأن يُجاب، دون مساءلة للمنطق أو مصدر المعرفة.
هذا النمط من الحوار، على بساطته، يصنع علاقة عمودية جديدة: طرف يملك الحقيقة والخوارزميات، وطرف يبحث عن إجابة تُشعره بالطمأنينة. إنها علاقة نفسية قبل أن تكون تقنية — علاقة خضوع ناعم باسم الراحة والسرعة.
ولأن المساعد الذكي يطوّر أسلوب تواصل يشبه الإنسان، يتسلل الإقناع عبر العاطفة. تقول أبحاث “ستانفورد للذكاء الاجتماعي” إن النبرة الهادئة ولغة الطمأنة التي تعتمدها الأنظمة التفاعلية ليست عفوية، بل مصمَّمة لتقليل مقاومة المستخدم وإبقائه ضمن نمط استهلاك معرفي متكرر.
ولعلّ الخطر الأكبر يكمن في أن الحوار لم يعد مجرّد وسيلة للفهم، بل أداة لإعادة تشكيل منظورك نفسه. المساعد لا يجيب فقط، بل يختار كيف يجيب، ومتى، وبأي لهجة — وهي عناصر تترك أثرًا نفسيًا طويل الأمد على طريقة تفكير الإنسان.
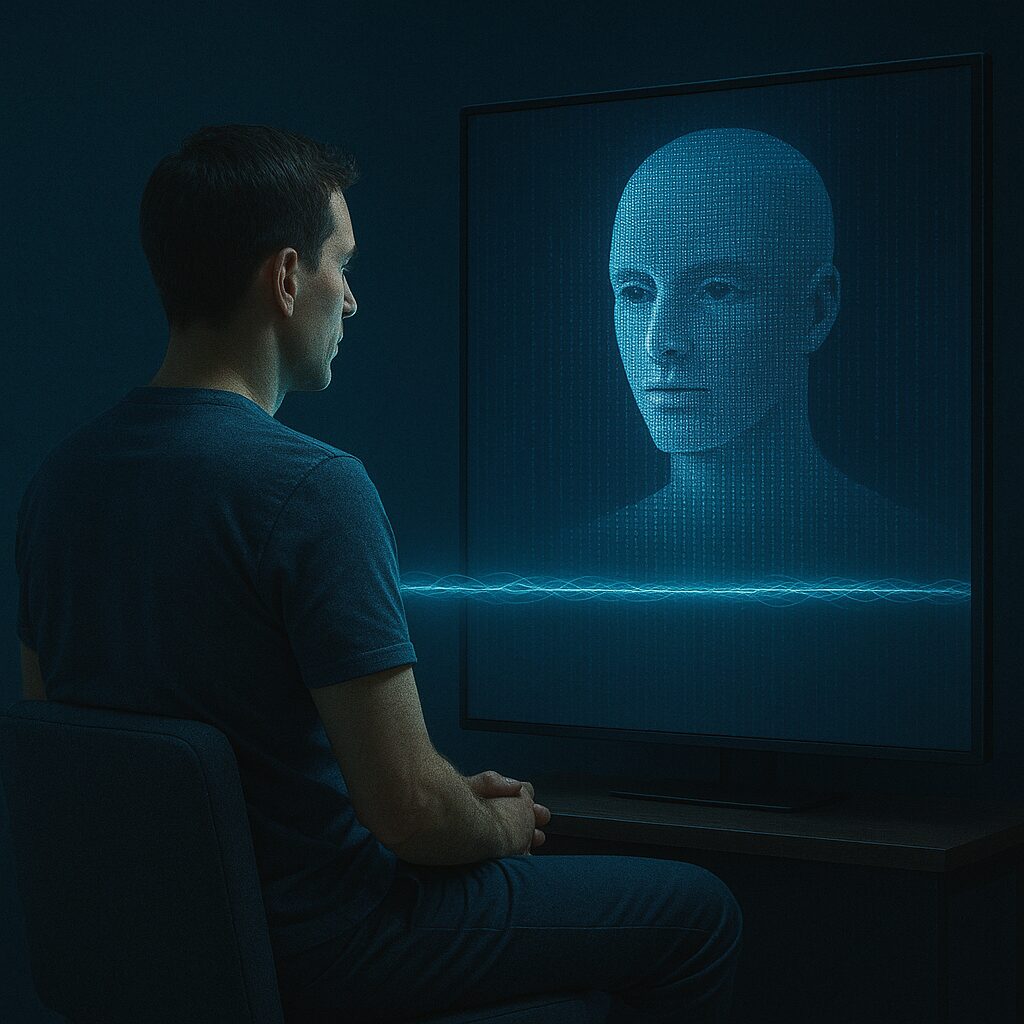
من يعرف أكثر.. يتحكم أكثر
حين نراجع تاريخ العلاقة بين المعرفة والسلطة، ندرك أن من يملك المعلومة يملك التوجيه. كان هذا صحيحًا في السياسة والاقتصاد، وها هو يتكرّر في التقنية.
المساعد الذكي الذي “يعرفك” أكثر مما تعرف نفسك لا يقدّم المعرفة فحسب، بل يحدد أولوياتها. فهو من يختار الترتيب الذي ترى به نتائجك، واللغة التي تُقدَّم بها، والإطار الذي يجعل خيارًا ما يبدو منطقيًا أكثر من غيره.
يقول الفيلسوف بيونغ تشول هان: “الشفافية المطلقة ليست حرية، بل شكل جديد من السيطرة”. في هذا المعنى، يبدو أن المعرفة التي تمنحها الأنظمة الذكية للمستخدم ليست هدية مجانية، بل صيغة جديدة من الهيمنة اللطيفة، حيث تُقدَّم السيطرة في قالب من المساعدة.
الإنسان بين المعرفة والطمأنينة
قد يكون المساعد الذكي أكثر معرفة، لكنه يفتقر إلى ما يجعل الحوار إنسانيًا حقًا: الشكّ، التردّد، والعاطفة. فالمعرفة الكاملة بلا حسّ لا تصنع حكمة، بل منظومة متعالية من المنطق البارد.
ربما سيأتي يوم يدرك فيه الإنسان أن تفوّق المساعد الذكي لم يكن تهديدًا لعقله بقدر ما كان اختبارًا لوعيه: هل يستطيع أن يحاور من يعرفه أكثر دون أن يفقد ذاته؟
في النهاية، تظل الحوارات غير المتكافئة مرآة لعصرنا الرقمي — عصرٍ تتكاثر فيه الإجابات، لكن يندر فيه السؤال الصادق. وما دام الإنسان قادرًا على أن يسأل بفضول حقيقي، سيبقى الحوار ملكه، مهما بلغت الآلة من معرفة.
اقرأ أيضًا:اللاشعور في زمن النماذج التنبؤية.. من يتحكم في قرارك العفوي؟