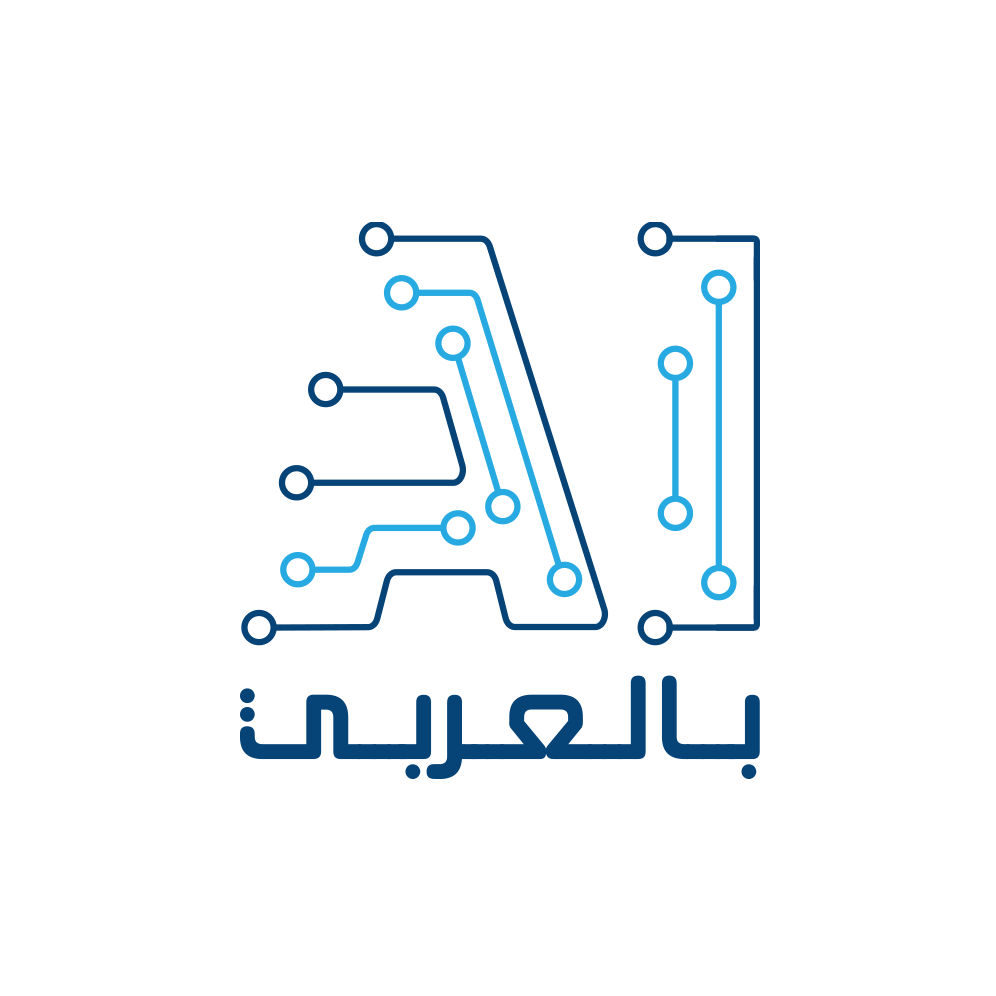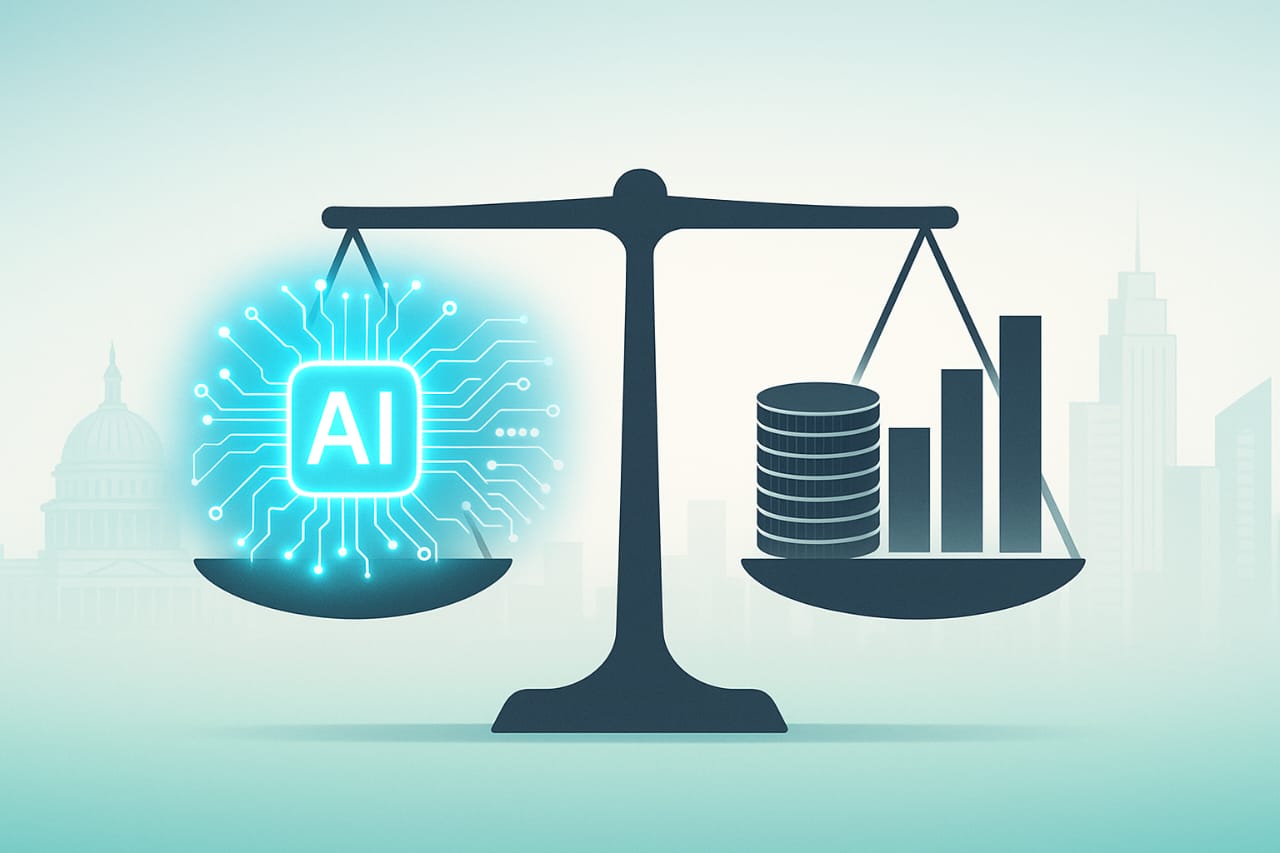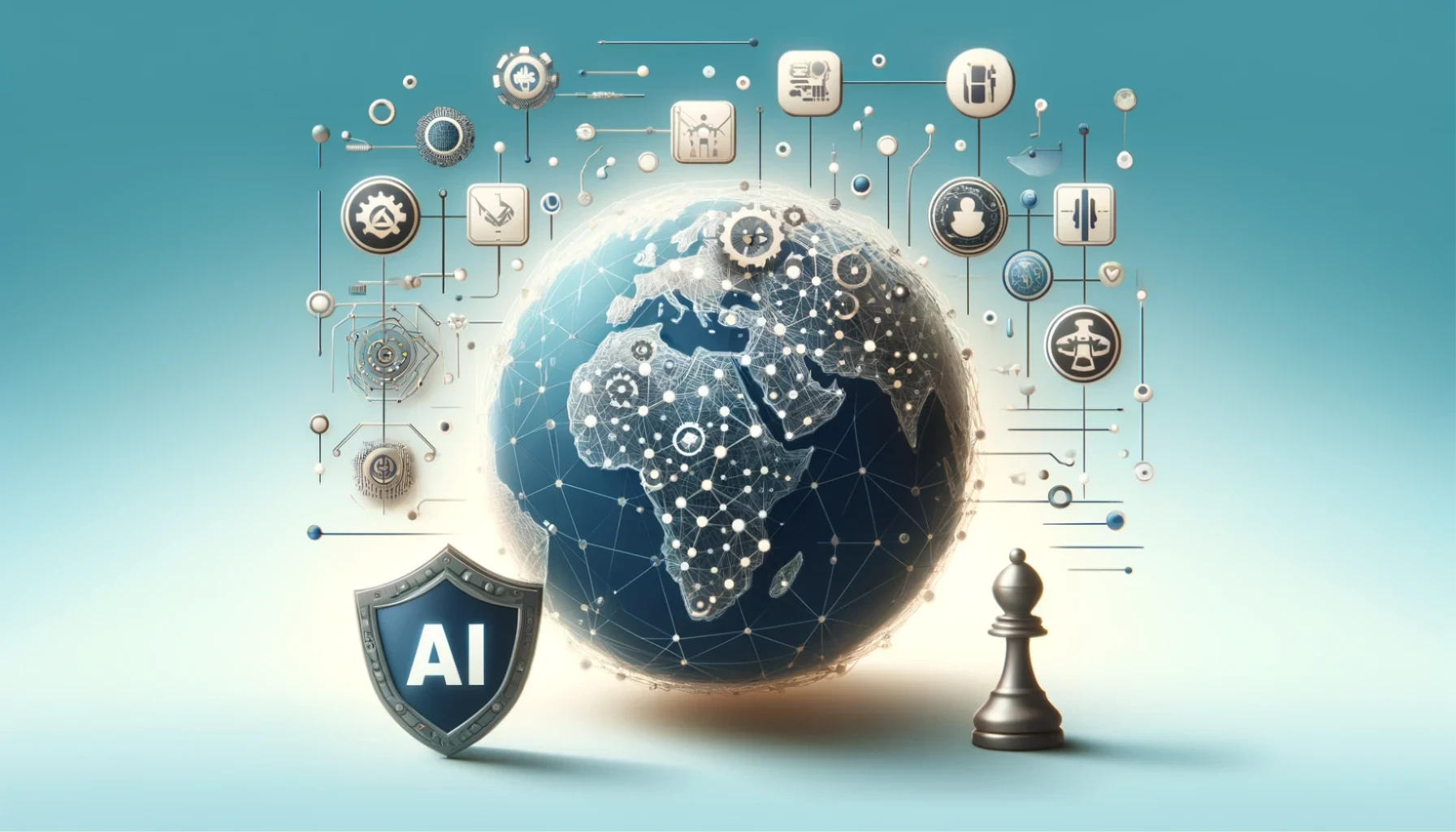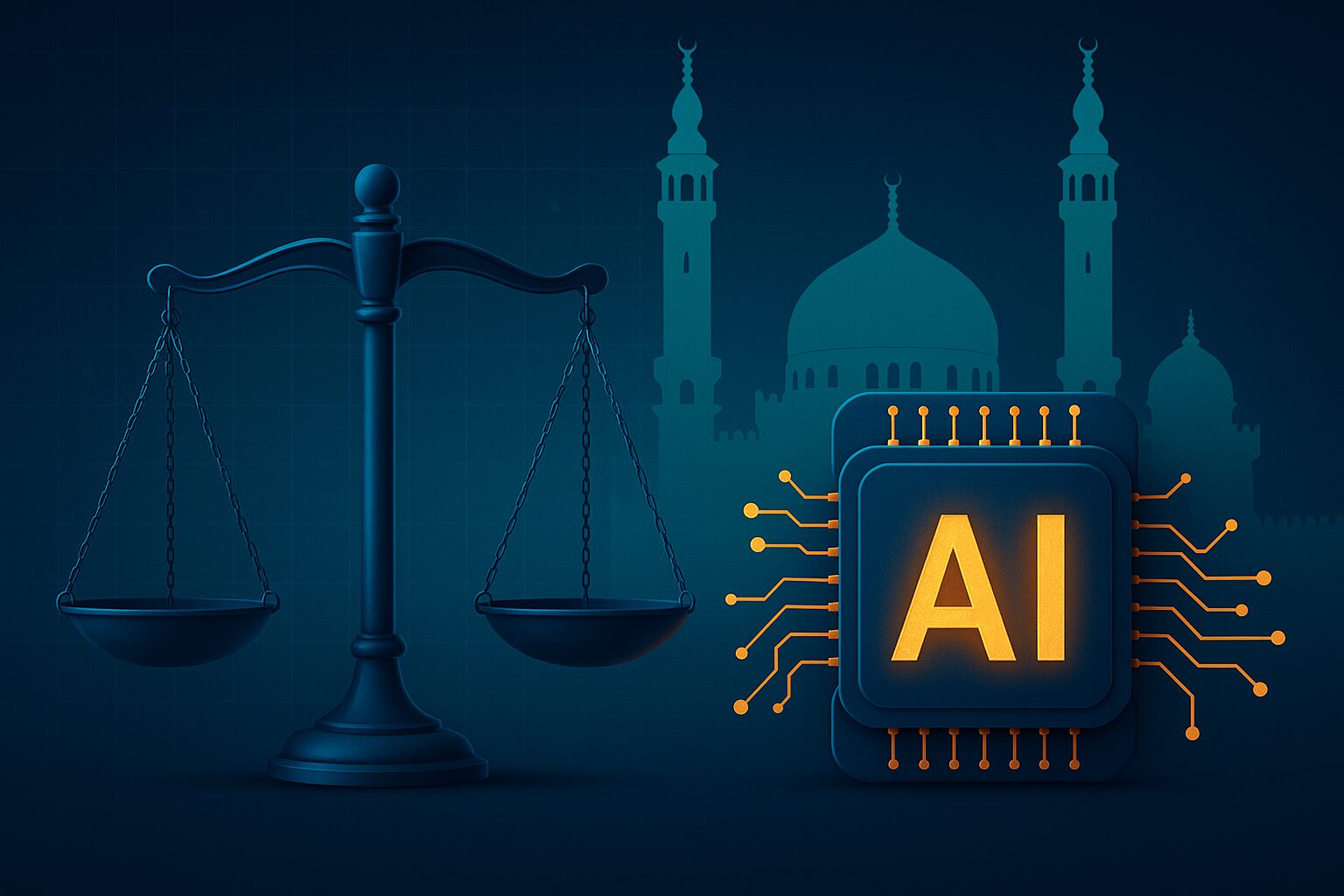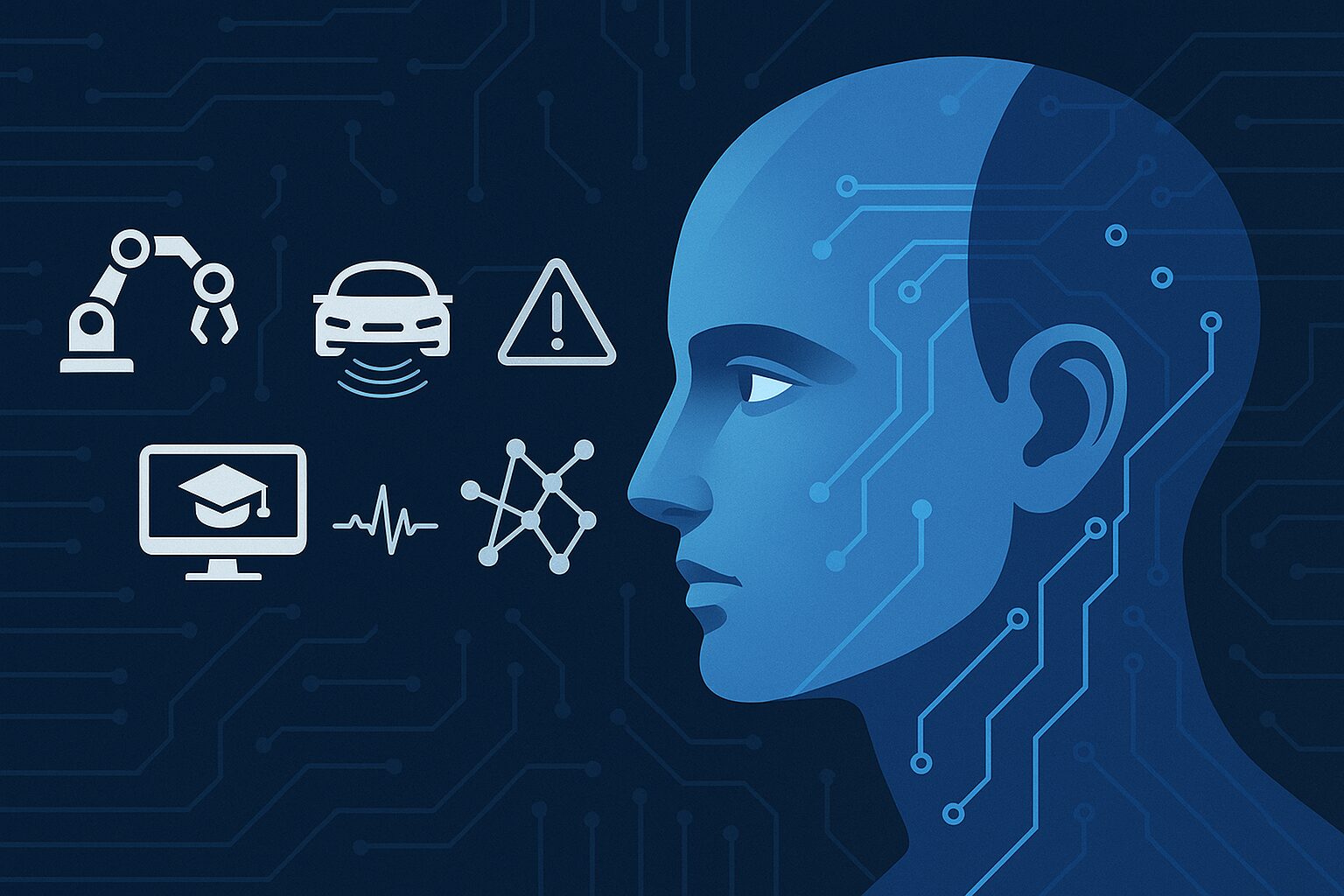AI بالعربي – متابعات
انتشرت على نطاق واسع، مقولة مصدرها منصات التواصل الاجتماعي، بفضل اكتسابها تأييدًا نسائيًا حول العالم، تقول فيها الكاتبة البولندية جوانا ماجيسيوسكا: “أريد أن يقوم الذكاء الاصطناعي بغسل الملابس والأطباق حتى أتمكن من ممارسة الفن والكتابة، وليس أن يقوم الذكاء الاصطناعي بممارسة الفن والكتابة حتى أتمكن من غسل الملابس والأطباق”، وفقًا لموقع المجلة.
تفاعل المنشور منذ أسابيع ولم يكن هذا ممكنا لو أنه لم يضرب على وتر مشترك بين النساء. تُذكّر بهذا الاجماع نظرية مارشل غانز، المؤسس لمنهج التنظيم المجتمعي في جامعة هارفرد ، الذي لاحظ أن الألم الجامع هو القوّة الأهم في اتّحاد أفراد من المجتمع، دون الاختلافات، فيغدو الألم قضيتهم، وإن نُظّم الألم فسيكون محرّكا للتغيير.
المجتمع النسائي هنا ملعبه العالم، والقضية تبدو لكثيرين تافهة بمقدار الغسيل، ويفترض أنّه قد عفا عليها الزمن، لكن الذكاء الاصطناعي وزمنه بعيدان عن عدم جعلها قضية، وحين تثار فهي تختصر بالضرر الجانبي المعترف به.
يحفّز هذا الإدراك التفكير بموضع المرأة في النموذج الحضاري الجديد الذي يقترحه الذكاء الاصطناعي، ومنه سؤال مركزي عن احتمال وكيفية وجود ذكاء اصطناعي صديق للمرأة وخصوصا الأم، التي لا تزال تواجه ترسانة تقليدية في توزيع الأدوار داخل المنزل، وهو جزء من مجال نمطيّ واسع، مقرّر ومتضمّن لسوق العمل.
جهود لامرئيّة
تشارك يسر صادق، أم لبنانية شابة لثلاثة أولاد، “كوميكس” وفيديوهات حول الأعمال المنزلية التي تؤديها الأمهات. تقول لـ”المجلة”: “أقَسّم إلى ما لا نهاية جدول أعمالي اليومي بين الترتيب والتنظيف والطبخ والتدريس، والتفكير هل سينجح ولداي في الاختبارات المدرسية، هكذا ألخّص نهاري وما يؤرقني على وسادة النوم. يوما بعد يوم، صارت هذه المهام تلخيصا لحياتي. يزيد الإحباط أن محيطنا لا يعتبر هذه الأعمال عملا حقيقيا يستنفد كل الوقت والطاقة”.
اضطرت هذه الأم وهي متخرجة في إدارة الأعمال إلى التخلي عن وظيفتها في مؤسسة خاصة، حيث كان يلازمها النجاح والامتلاء. وضعتها الأزمة اللبنانية والهجرة إلى بلد عربي أمام المفاضلة بين العمل والمنزل، فرجحت الكفة للأخير “من العجيب كيف تتقلّص الطموحات، حتّى يغدو جلّها، ذكاء اصطناعيا يعفي من مسح الغبار أو يقترح وصفة للطبخ”.
تنطوي معاناة يسر وقريناتها على السائد بأن تتولى المرأة الاهتمام بالمنزل، ويتفرغ الزوج للعمل خارجه.
في محاولة لتغيير الموازين، أوصت “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” في تقريرها عام 2020، بإدراج هذه الأعمال بأشكال مباشرة وغير مباشرة، تحت خانة “اقتصاد الرعاية”، وشرحت أهميته في تقليص الفجوات الجندرية الواسعة في المنطقة العربية، حيث كشفت أن “المرأة في الدول العربية تؤدي أعمالا رعائية غير مدفوعة الأجر بقدر 4.7 مرات أكثر من الرجل، وهي أعلى نسبة مقارنة بأي مكان في العالم”.
تناقش هذا المشهد وتقرّ بامتداده العالمي-التاريخي الكاتبة النسوية الفرنسية جيزيل زيغلاك في كتابها “الانقلابيات: الفنّ المتقن لكسر كلّ التوقعات”، حيث نستنبط ارتكازها على البنى الفوقية للمجتمع، بما فيها الثقافة والفن والدين والفكر، بالمعنى الماركسي ولكن في اتجاه معكوس، فهي تعتبر أنّ هذه العوامل هي المحددة لشروط توزيع الدور الانتاجي. وتنتقد “حشر قمعهم “الرجال” التاريخي في جيناتنا “النساء”.
كما أسهبت الفيلسوفة ومؤرخة العلوم التونسية-الفرنسية، كلودين كوهين، في كتابها “نساء ما قبل التاريخ”، بالحديث عن الهيمنة الذكورية التي وصفها بيار بورديو بأنها “حضور عالمي”، وهي ليست طبيعية، بل بناء تاريخي قائم على اختيار متعمد للأدوار الاجتماعية المنسوبة الى البعض والى البعض الآخر، وينم ذلك عن خلط بين الطبيعة والثقافة لصالح الرجال.
معادلة تتطرّف اليوم عند اللبنانية-المصرية إنجي غانم، التي حازت دكتوراه في علوم البيانات وتعلّم الآلة. المفارقة أنها تنتمي إلى المنظومة العلمية التي طوّرت الذكاء الاصطناعي، غير أنها لم تستطع الاستفادة منها، فاستغرقت في رعاية طفلتيها، وابتعدت عن سوق العمل، بعد 12 سنة من الدراسة الجامعية تنقّلت خلالها بين لبنان وأميركا وتركيا. تقول لـ”المجلة”: “تنتابني موجات كآبة بين حين وآخر. خسرت رهاني الأول، حين ظننت أنني من أوائل النساء العربيات اللواتي سيتمرّسن في ثورة الرقميات وستفتح لي الجامعات وأسواق العمل أبوابها العريضة، ولكنني اخترت التركيز على طفلتيّ”.
“ألكسا” و”سيري”
تجيب الدكتورة إنجي غانم دون حيرة عن سؤالنا: هل يوجد، أو يمكن وجود، ذكاء اصطناعي يساعد في المنزل؟
“نعم، يوجد ‘ألكسا’، و’سيري’ وهما مساعدان افتراضيان يعتمدان على الأوامر الصوتية. ‘سيري’ بدأت كمساعدة صوتية على هواتف ‘أبل’ وتطورت لتصبح مثل ‘ألكسا’، جهازا متّصلا بنظام الذكاء الاصطناعي ومؤهلا للاستخدام في المنزل، ولكنهما متاحان على نطاق ضيق ولميزانيات مرتفعة في معظم البلاد العربية”.
تمتلك “ألكسا” أو “سيري”، بحسب الخبيرة، القدرة على الحوار، وفهم مزاج الأشخاص. يمكن أن نقول لألكسا، “شغّلي أغنية مفرحة”، فتقوم من خلال قاعدة بياناتها بربط كلمة “مفرحة”، مع أغان ذات صلة. القدرة على السماع والبحث والإجابة والاختيار هي خصائص إنسانية، وتتبع لذلك تصنيف الذكاء الاصطناعي. وبإمكان “سيري” القيام بمهام أعقد، فإن أخبرناها أننا متوترون أو بمزاج معتكر، فستبادر إلى تخفيف الاضاءة وتشغيل موسيقى هادئة.
وتضيف أنّ “ألكسا” و”سيري” تُعتبران رفيقين ذكيّين يمكن وصلهما بكل أجهزتنا المنزلية، إذ يمكن إصدار الأوامر لهما من خارج المنزل من خلال تطبيقات الهاتف، أو من خلال الأوامر الصوتية داخل المنزل، فتبدأ بغسيل الملابس والأطباق أو تشغيل الموسيقى، ولكن يشترط الاستخدام التدخل البشري في بعض الأجهزة. ومن مميزاتها أنها تحفظ نمط عملنا من خلال التعلم الآلي ثم تعيد إنتاجه، ولكن استخدامها لا يمكن أن يندرج في الطبخ لأن حاسة الذوق غير مطوّرة عند الذكاء الاصطناعي. ويتطلب اتصال إمدادات المنزل وأجهزته بالذكاء الاصطناعي أن تكون مدرجة ضمن مرحلة البناء، أو شراء عدد كبير من الاجهزة التي تؤمّن الاتصال اللاسلكي بـ”ألكسا” أو “سيري” لمن يعيشون في بناء منجز، مما يجعل التكلفة باهظة نسبيا.
تستدرك: “هناك عامل مهم متعلّق بأولويات المرأة، وإعدادها للتضحية، وفي ظروفنا الاقتصادية الصعبة، تختار الأم العاملة إنفاق ما تجنيه لتربية وتعليم الأولاد، على بذلها في خدمات بمنزلة الرفاهية”.
وتميّز غانم بين ثلاثة مصطلحات متقاربة: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة الذكية. الأخيرة معتمَدة بشكل أوسع مثل الأضواء وصنابير المياه التي تعمل بوجود المستشعرات، وكذلك أجهزة الميكرويف والغسالات التي يمكن التحكم بتوقيت وطريقة عملها من خلال تطبيقات الهاتف. أمّا الروبوتات، فهي مصمّمى لتأدية دور محدّد، مثل حمل الصواني أو خدمة الطاولات في المطاعم، ولكنها لا تحمل بالأصل عناصر ذكية.
العمل والصورة النمطية
من جهتها، تشرح لـ”المجلة” الأستاذة الجامعية والباحثة بمجال الذكاء الاصطناعي في الاعلام، الدكتورة سالي حمّود، أن الذكاء الاصطناعي لاعب كبير في انخراط النساء في المهن والشأن العام، ويتفاعل بطريقة سلبية وأخرى إيجابية، ويجب دراسة تأثيره من زاوية المبرمج والمستخدم على حدّ سواء.
تضع أوّلا في الاعتبار، أن “انخراط النساء عبر التاريخ كان ولا يزال محدودا في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ٍSTEM)، وبالتالي يهيمن الذكور ومقاربتهم في معالجة البيانات والنصوص والترميز، فتفضي إلى فضاءات تنوجد فيها المرأة دون شعور بامتلاكها، ببساطة لأنها صُمّمت من دونها. وصارت متمادية وقوية الصرخات التي نسمعها ضدّ التحيز الجندري للذكاء الاصطناعي، من ضمن مجموعة تحيزات أخرى غير مرتبطة بالجنس، وقد تجسّد العرق والدين واللغة والجنسية وهويات تخضع لنظرة تقييمية عالمية مسيطرة، فيلتقط الذكاء الاصطناعي هذه الاختلافات، ويفاقم عدم المساواة الاجتماعية، ولعل أبرزها التفاوتات بين النساء والرجال في منظومة الأعمال”.
تقارن حمّود، أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأكثره شعبية “تشات جي بي تي”، حين يطلب منه صورة لمدير/ة دون تحديد الجنس، يولّد صورة لمدير رجل.
وقد طلبت باحثة في جامعة أوكسفورد من الذكاء الاصطناعي 5 أسماء لأطباء وممرضين، والنتيجة كل أسماء الأطباء مذكّرة، والممرضات مؤنّثة، حيث أنّ هذا الذكاء يساهم في إرساء مفاهيم ذكورية غائرة في التاريخ، دون أي ثورة في المفاهيم، فينسب المهن والأدوار الهشّة إلى النساء، وتلك المتفوقة اجتماعيا واقتصاديا إلى الرجال.
أما الخبيرة الجنسانية عبير شبارو، فتذهب في حديث لـ”المجلة” إلى مقارنات إضافية، تشمل الأدبيات والقيم: “يتوجّه إلينا ‘تشات جي بي تي’ بصيغة المذكّر. وينزع عن الوصف النموذجي للقادة أو للمديرين صفة التعاطف، وهي سمة مثبتة لقيادة النساء. أما على صعيد الإبلاغات التي نتقدّم بها على ‘فيسبوك’، حين تطال امرأة حملات تشهير وشتائم، فإن ‘ميتا’ في أحيانٍ كثيرة لا تعتبر أنّ هذه العبارات تنافي ‘معايير المجتمع’، وعلينا هنا التذكير بمن برمج ومن يتلقى الشكاوى، وغالبيتهم رجال”.
“ميتا” والسمعة الرقمية
تنتقل الدكتورة سالي حمّود إلى تأثير “ميتا” على السمعة الرقمية للنساء: “لم يعد ‘فيسبوك’ و’إنستاغرام’ منصتين للتواصل الاجتماعي. هما في الحقيقة شركة إعلانات ‘ميتا’، وتجني أرباحها بناء على الخوارزميات التي يطورها الذكاء الاصطناعي. هذا الفهم سيزيل تساؤلات حول المحتوى الخاص بالنساء، ذلك أن ‘ميتا’ مطالبة مرارا بشفافية الخوارزميات، لكنها لا تصرّح عنها. كما أن ‘ميتا’ لا تضع للمعلنين تفضيلات قائمة على الجنس. لهذا السبب، يقام العديد من التجارب في مراقبة التفاعل وفكّ تشفير الخوارزميات، وتستنتج بالمبدأ أنّ ‘ميتا’ تروّج للمحتوى الذي يمسّ سمعة المرأة عبر التعري والتسليع، على قاعدة الألم والمتعة (pain and pleasure) الجاذبين للمُشاهد”.
تحدّد أن “النساء هنّ الأكثر استهدافا من فيديوهات التزييف العميق، وتطاولهن في السياسة والشأن العام أكثر من الرجال. نسترجع مثلا الفيديو الشهير لرئيسة وزراء نيوزيلاندا السابقة جاسيندا أرديرن، وهي تدخن القنب. وغالبا ما تتزايد هذه الفيديوهات خلال الحملات الانتخابية، وليس بسبب التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي، بل رزمة من الأحكام الاجتماعية المنحازة ضد النساء، وتعمد إلى التضليل على أساس الجندر”.
في النتيجة، لا ريب في أن تغذّي هذه الممارسات تردّد نساء بأن يكنّ تحت الأضواء أو يخضن تجارب خارج الصندوق أو شغل مناصب قيادية، فيلجأن إلى رقابة ذاتية صارمة في المجالات العامة، أو ربما العودة إلى الاهتمام بالمنزل، الذي يجسد المكان الثقافي الطبيعي المخصص للنساء، حيث تتقاطع ضمن المساحة الخاصة المغلقة هذه أصداء العبء النفسي مع أعمال غير مرئية ومفتقرة للقيمة.
احتواء الفجوة الرقمية
تضمّ الدكتورة سالي حمّود صوتها إلى مطالبات متصاعدة لصدّ العنف ضد النساء في الاستخدامات اليومية للذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال “إدماج المرأة في صناعة الذكاء الاصطناعي والعلوم المتصلة، كالهندسة وبرمجة الحلول والتسويق، والتأكد من تمثيل المرأة في هذه القطاعات، من خلال نساء يمتلكن الكفاءة والتأثير في مجالس إدارة الشركات العاملة”.
في هذا السياق، وجد تقرير لمنظمة “أونيسكو” عام 2019 أن النساء عالميا يمثلن فقط 29 في المئة من مناصب البحث والتطوير في مجال العلوم.
وتنبه الخبيرة الجنسانية عبير شبارو إلى العودة الى أصل التفاوتات في العمل والمهنة التي تراكمت عبر الأزمنة، حيث لا تبدو غير متوقعة إنتاج هذه الفجوة الرقمية الواسعة بين المرأة والرجل، وأخرى كامنة بين النساء.
تستشهد بدراسة لمعهد “ماكنزي”، صادرة في عام 2023، تتوقع أنّ النساء أكثر عرضة من الرجال بنحو مرة ونصف مرة للانتقال إلى مهن جديدة بسبب استخدامات الذكاء الاصطناعي، ذلك أن الأعمال التي تشغلها النساء، تندرج عادة في الدعم المكتبي والخدمات، وستكون أكثر عرضة للفقدان.
وتعطي أرقام البنك الدولي، بالنسبة إلى الخبيرة، انعكاسا واضحا للفجوات في المنطقة العربية: “22.1% من الرجال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دفعوا فواتير الهاتف والإنترنت عبر تطبيقات إلكترونية، مقابل 13.5% فقط من نساء المنطقة، وفجوة أوسع تباعد بين هؤلاء ومعدل 31.8% الخاص بالنساء عالميا”.
تتابع: “لا تزال النظم المؤسساتية في منطقتنا بعيدة عن تدريب مواردها البشرية وتأهيلها للتحول الرقمي، وهذا يشيع المخاوف لدى النساء، ويعمّق الشعور بأنهن الحلقة الأضعف، سيفقدن الوظائف المدفوعة، وستُعاد إحالتهن إلى المنزل. وهذا معتقد خاطئ، ومشجع لمن ينشدن البقاء في منطقة الراحة. بإمكان المرأة التكيف مع تبدلات مستقلة عن إرادتها، والمجال متاح للتعلم الذاتي، فالمنافسة قريبا ستنطوي على مَن يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، ولا تعني إلغاء وظائف برمتها”.
خلاصات
تتأكّد شبارو من وضع المعادلات في سياقها الأنثروبولوجي، مذكّرة بأن “الذكاء الاصطناعي ليس وليد الأمس، فهو يُستخدم في الطيران والفضاء والطب منذ عقود طويلة. والخدمات التي نعتبرها تحصيلا حاصلا من شبكات المياه والتدفئة، كانت في وقت سابق مهام يومية للنساء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأدوات الكهربائية”.
في الواقع، شهد العالم في ستينات القرن الماضي تطورات يشير إليها مؤرّخون بـ”ديمقراطية التحديث”، حيث انتشرت الأدوات الكهربائية في البيوت العربية بشكل مناسب لكل الميزانيات، وحققت نوعا من المساواة عابرا للطبقات والجنسين وهو تحديث جماهيري لم تظهر فيه عوامل فكرية، وقد وقع بين الثورتين الصناعيتين الثانية والثالثة. الذكاء الاصطناعي يجسّد الثورة الرابعة.
تختم شبارو بأهمية الذكاء البشري في استخدام الذكاء الاصطناعي “فنحن حين نطالب بالعدالة الجندرية، نعني دون تحفّظ العدالة الاجتماعية وخير المجتمع الانساني. وهنا يجدر التمييز بين التخفف من الأدوار الرعائية التي نسبتها الأعراف التقليدية الى المرأة، وأخرى مدموغة في تكوينها الجينيّ. ليس من التعقل استهلاك روبوتات جديدة على شكل يد مغلفة بالقماش، تحلّ مكان يد الأم لتساعد الطفل الرضيع على النوم. هل دُرس تأثير الذبذبات على نمو الرضيع وكيمياء الدماغ؟ وكذلك كيف تحلّ آلة مكان التواصل الفطري بين الأم والطفل؟”.
أخيرا، يبدو السياق حمّالا لهوامش يمكن تطويرها بالنسبة الى سالي حمود. تقرّ بإيجابيات ودعم الذكاء الاصطناعي للمرأة في الأعمال، أبرزها تطبيع الشركات مع مبدأ الانصاف الجندري في التوظيف، من خلال نظام تتبع مقدمي السيرة الذاتية (المعروف بنظام ATS). كما عبرت الفضاءات الافتراضية ومنها إلى الواقع حملات عالمية متضمنة هاشتاغات داعمة للنساء في مواجهة الأنظمة السياسية القمعية، وأخرى ضد التحرش والاغتصاب، على نحو “أنا أيضا”، و”نصدق الناجيات”.