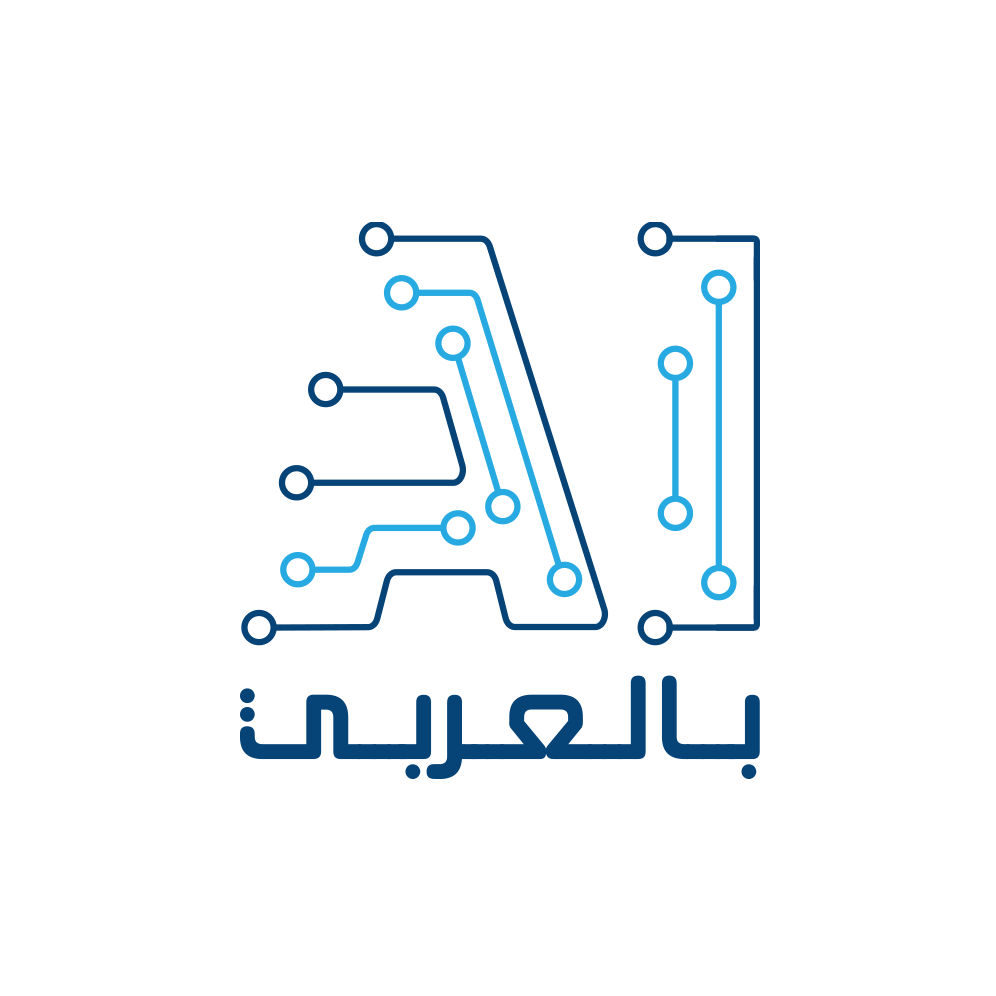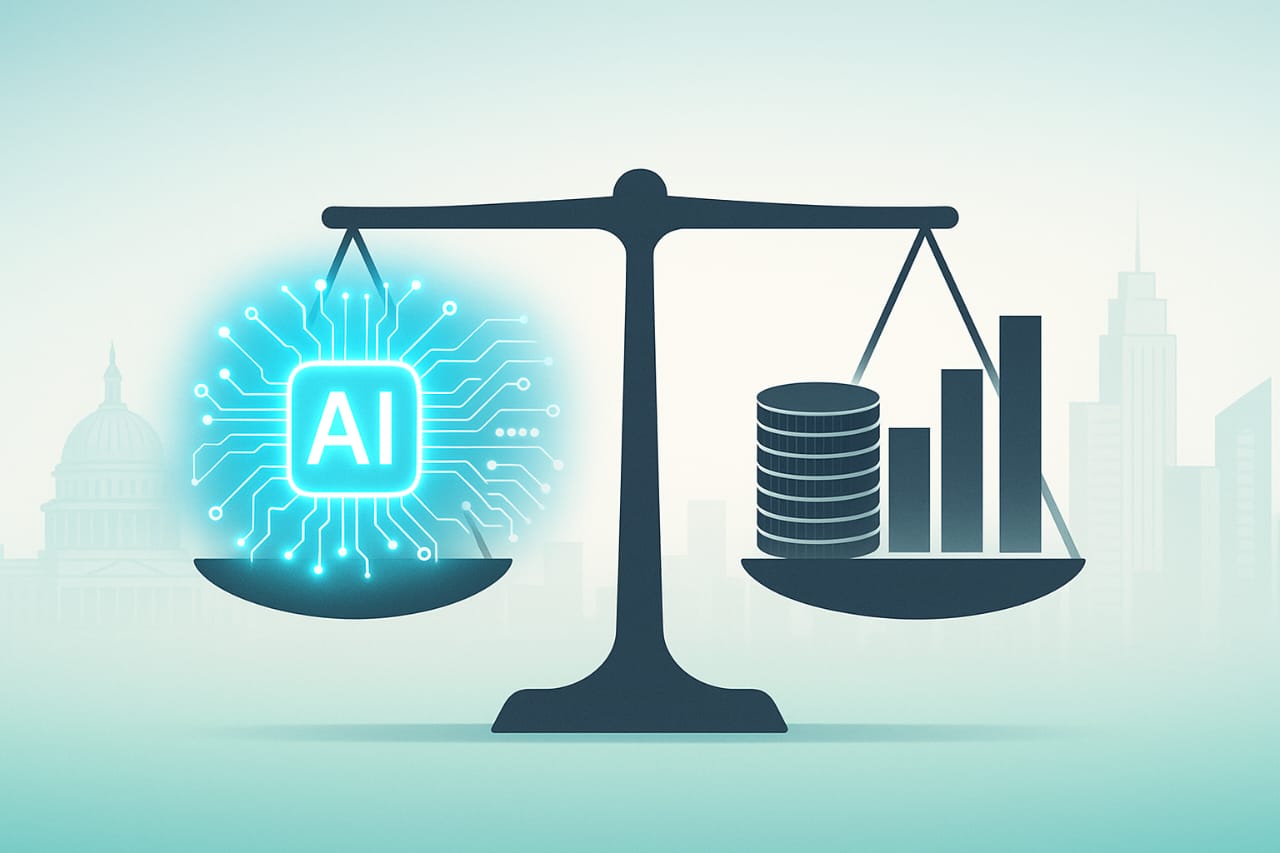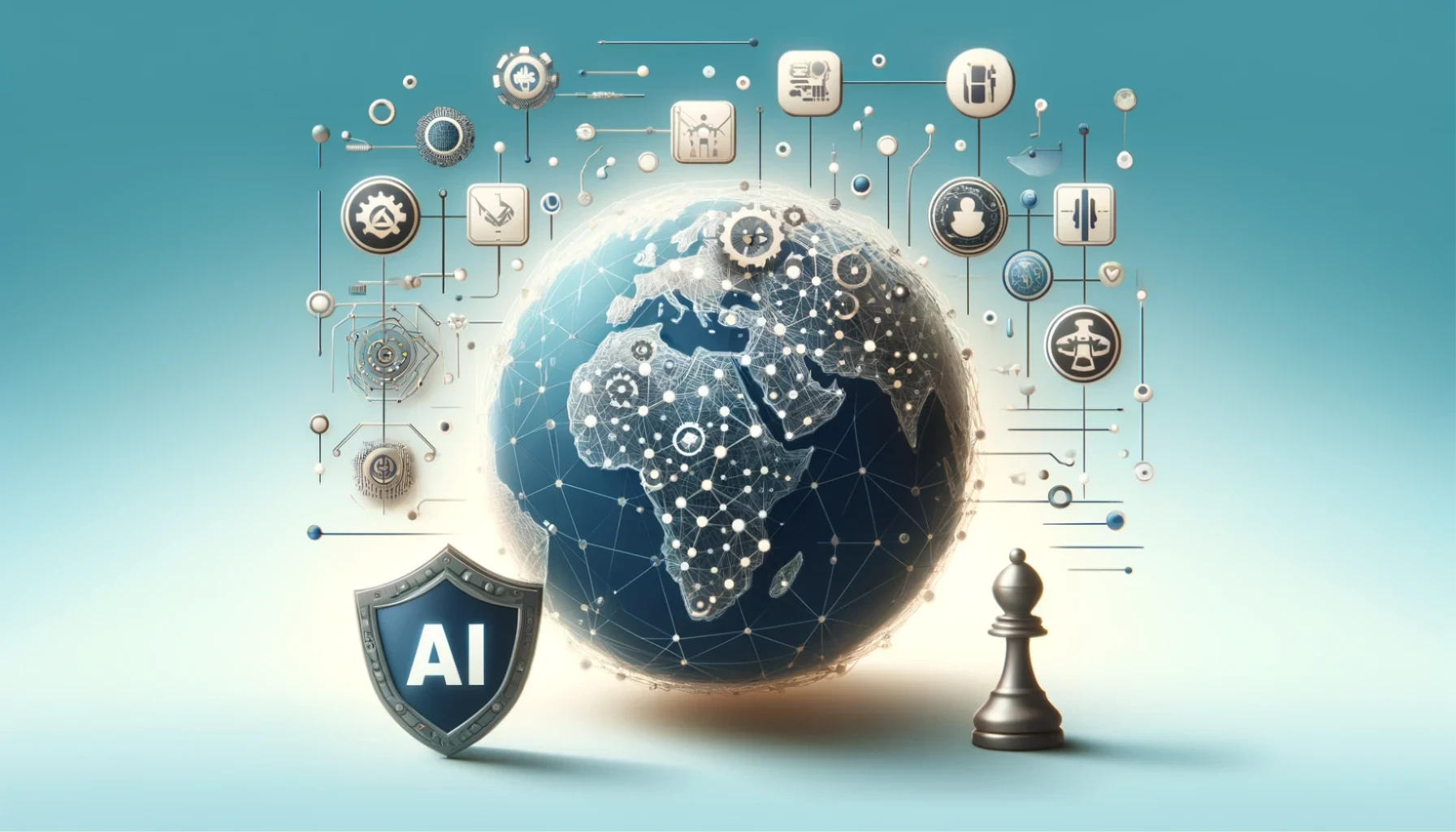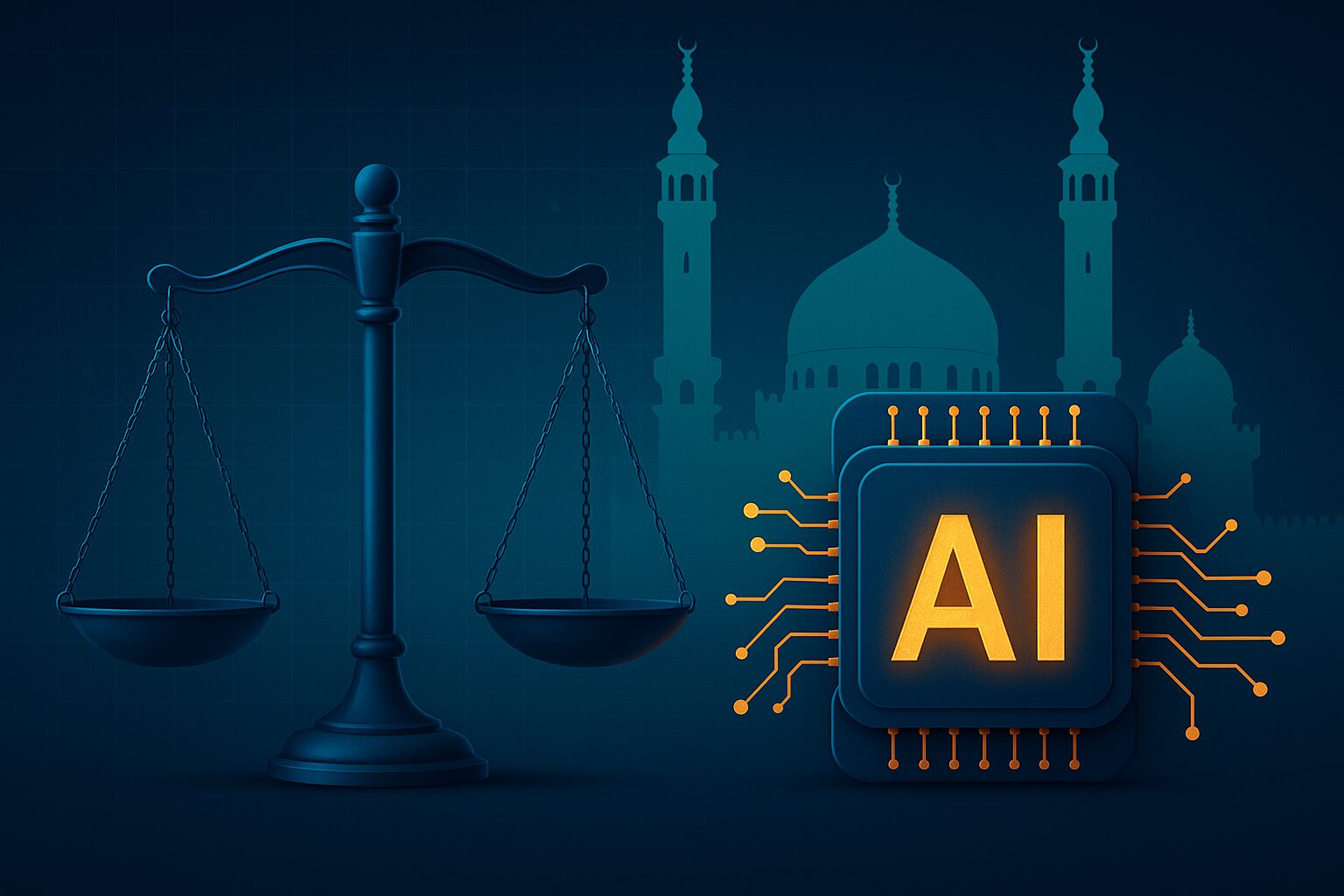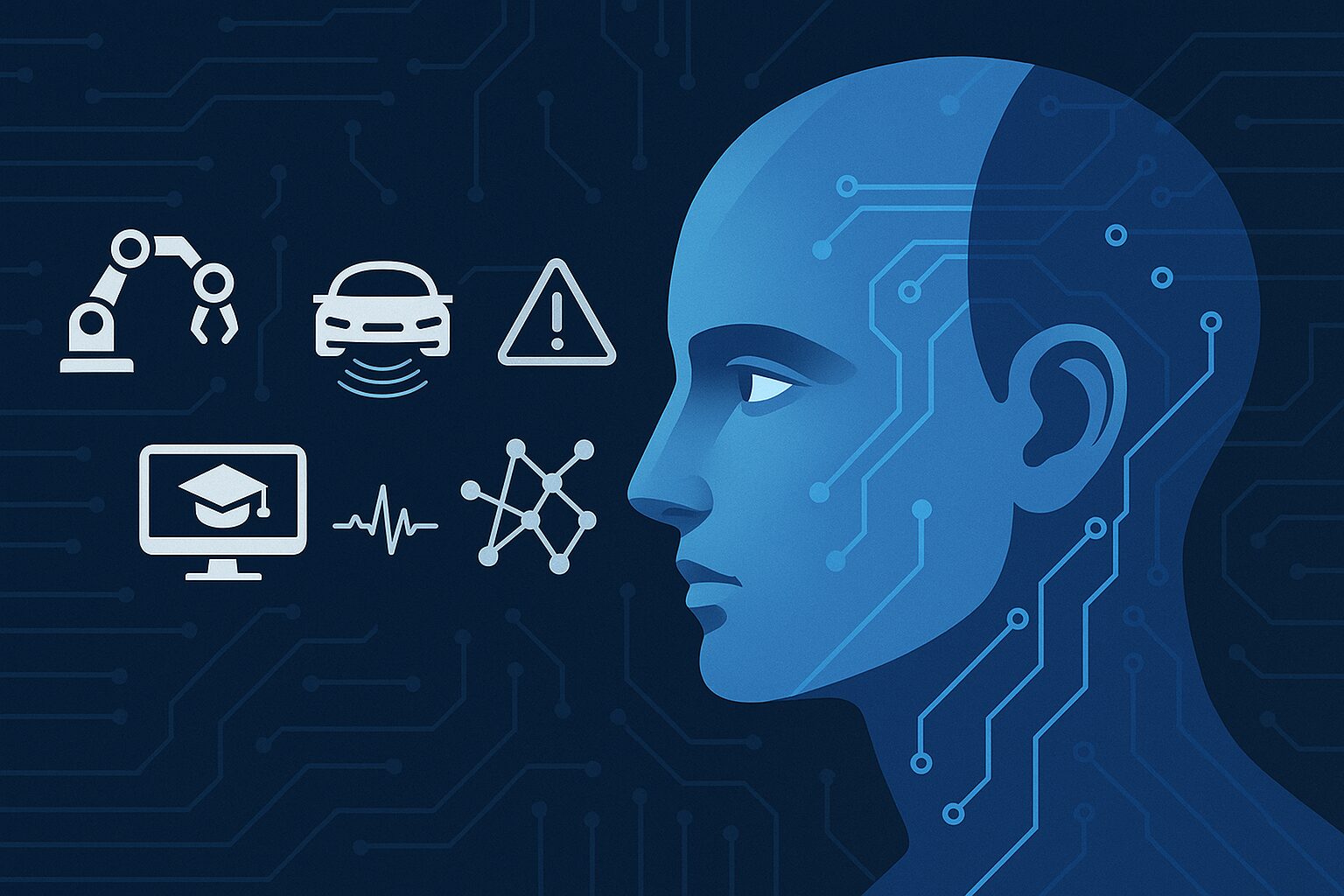المراهق الرقمي.. جيل يتكوّن وجدانيًا من خلال خوارزميات التوصية
AI بالعربي – خاص
في زمن تتحكم فيه المنصات الرقمية بمسارات التفاعل والانتباه، لم يعد تكوين المراهقين وجدانيًا واجتماعيًا نابعًا من الأسرة أو المدرسة فقط، بل بات يُصاغ بدرجة كبيرة عبر ما تُقترحه الخوارزميات. جيل “المراهق الرقمي” هو جيل لا يكتشف العالم من حوله، بل يُقدَّم له على هيئة مقاطع قصيرة، تحديات، توصيات، وردود فعل مصمّمة لتشده وتبقيه داخل حلقة التفاعل.
تعتمد خوارزميات التوصية في المنصات الكبرى — مثل تيك توك، يوتيوب، وإنستغرام — على تحليل سلوك المستخدمين وتقديم محتوى “محسوب عاطفيًا”، يستهدف إثارة مشاعر معينة: الضحك، الغضب، الانبهار، أو الحزن. وبهذا يصبح المراهق عرضة لتغذية وجدانية مستمرة، لا يختارها بنفسه، بل يتم تلقينها بناءً على نمط استهلاكه الرقمي.
هذا النوع من التعرض المفرط لا يشكل فقط ذائقته، بل يطبع مزاجه اليومي، ويؤثر في نظرته للذات والعالم. صورة الجسد، مفهوم النجاح، العلاقات، وحتى طريقة التعبير عن المشاعر، كلها تتشكل — أو تتحوّر — داخل بيئة يسيطر عليها المحتوى المُنتقى خوارزميًا، لا سياقات الحياة الواقعية.
أظهرت دراسة أجرتها جامعة “ستانفورد” عام 2024 أن أكثر من 64% من المراهقين يقيّمون يومهم بناءً على ما شاهدوه أو شاركوا به رقميًا، وليس بناءً على تفاعلهم الواقعي مع الآخرين. كما بيّنت الدراسة أن هناك علاقة مباشرة بين نوعية المحتوى المقترح وبين مستويات القلق والتقلبات المزاجية لديهم.
وتتفاقم المشكلة مع ميل هذه المنصات إلى تعزيز المحتوى المتطرف أو العاطفي الحاد، لأنه يحقق نسب مشاهدة أعلى. وهكذا يجد المراهق نفسه أمام سيل مستمر من “المقارنات السامة”، والمثاليات المفرطة، أو الصور المُفلترة، مما يدفعه لا شعوريًا إلى إعادة تعريف ذاته وفق معايير رقمية متقلبة.
الخطر لا يكمن فقط في المحتوى، بل في الإيقاع. فالتنقل السريع بين مقاطع قصيرة لا يتجاوز الواحد منها 30 ثانية يُربك قدرة الدماغ على التركيز المستمر، ويضعف من مهارات التفكير التحليلي والتأمل الهادئ، وهي أدوات أساسية في بناء هوية وجدانية متماسكة.
لكن في المقابل، لا يمكن تجاهل أن هذه المنصات قد تكون مصدرًا للمعرفة والتواصل والتعبير، بشرط أن تُستخدم بوعي، وبمرافقة تربوية حقيقية، لا بالتجسس أو المنع، بل بالتوجيه والفهم. فالمراهق الرقمي لا يحتاج إلى وصاية صارمة، بل إلى أدوات تساعده على التمييز بين ما هو ترفيهي وما هو مؤثر فعليًا في تكوين شخصيته.
تبقى الإشكالية الأكبر في أن خوارزميات التوصية لا تعرف النضج، ولا تفرّق بين طفل ومراهق وبالغ. هي مجرد أنظمة تعمل على أساس “ما يثيرك أكثر”. فهل يمكننا أن نترك الأجيال القادمة تنمو عاطفيًا داخل فضاء مصمَّم فقط لجذب انتباهها لا لرعايتها؟ وهل نمتلك الوقت لتصحيح ذلك قبل أن يتكون جيل كامل بلا جذور وجدانية حقيقية؟