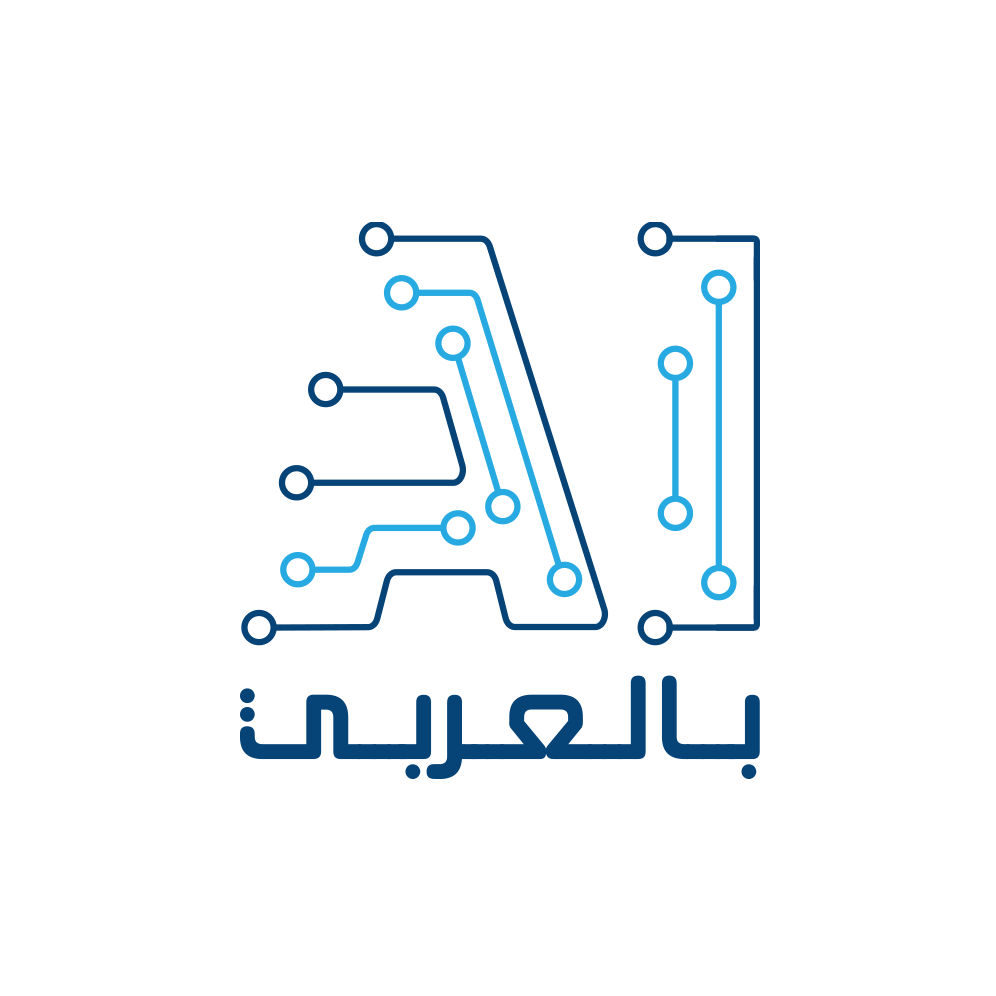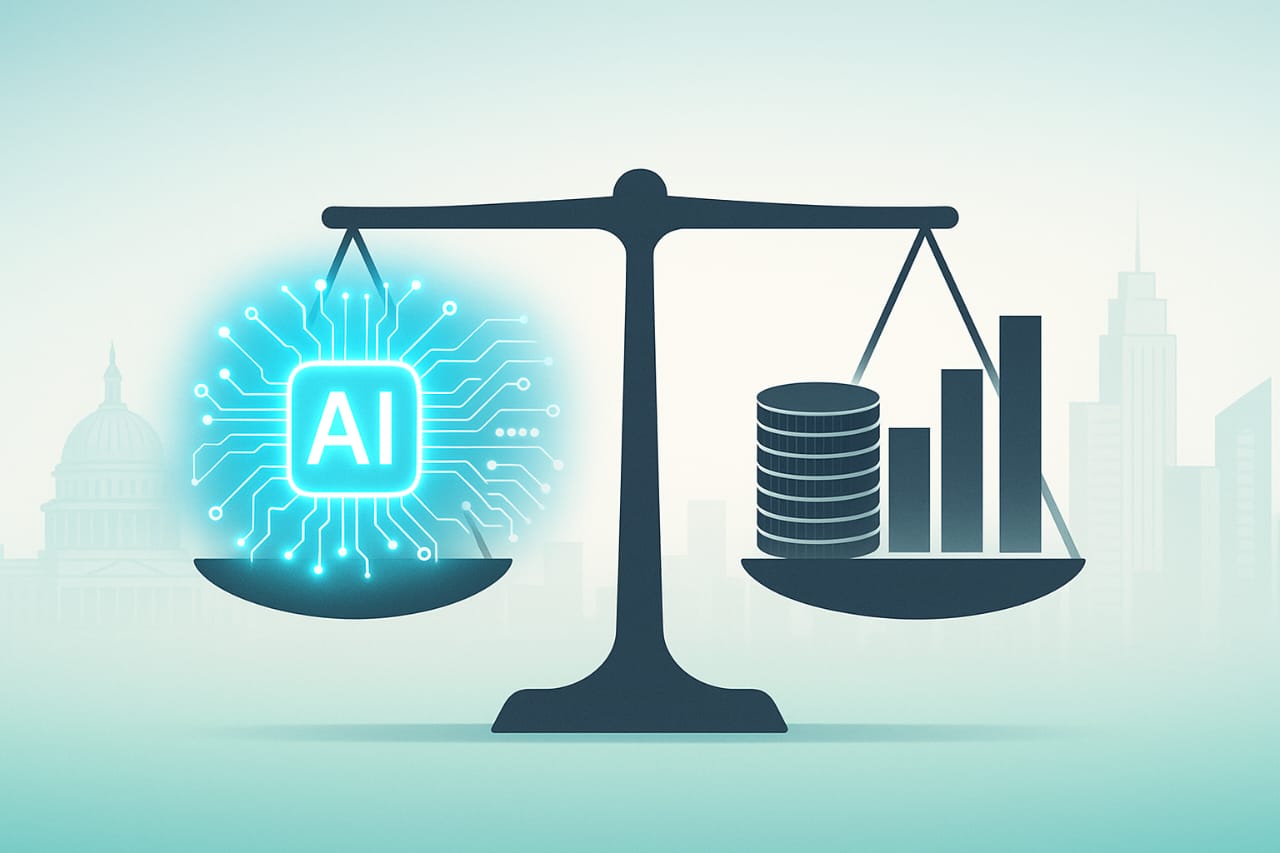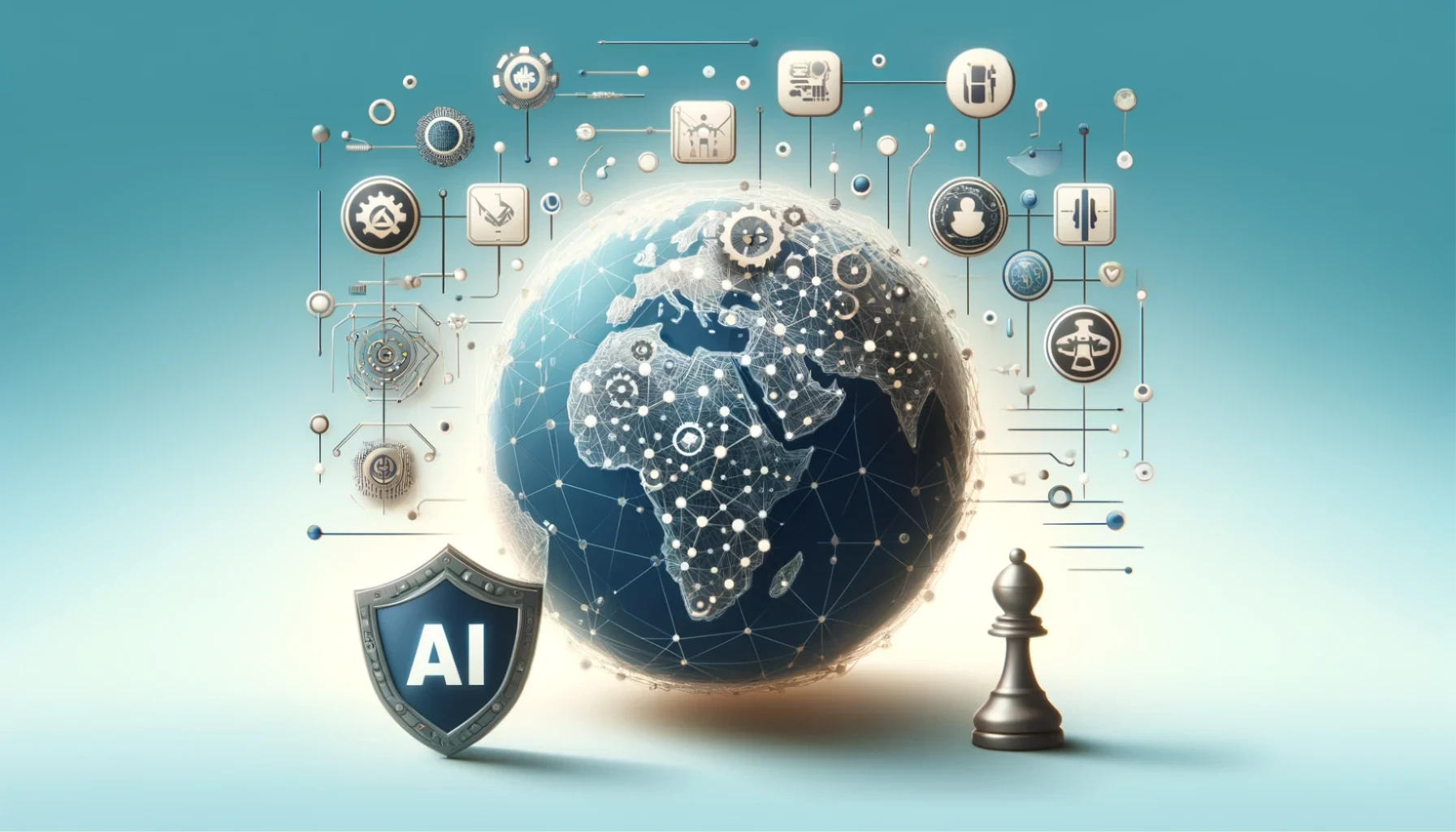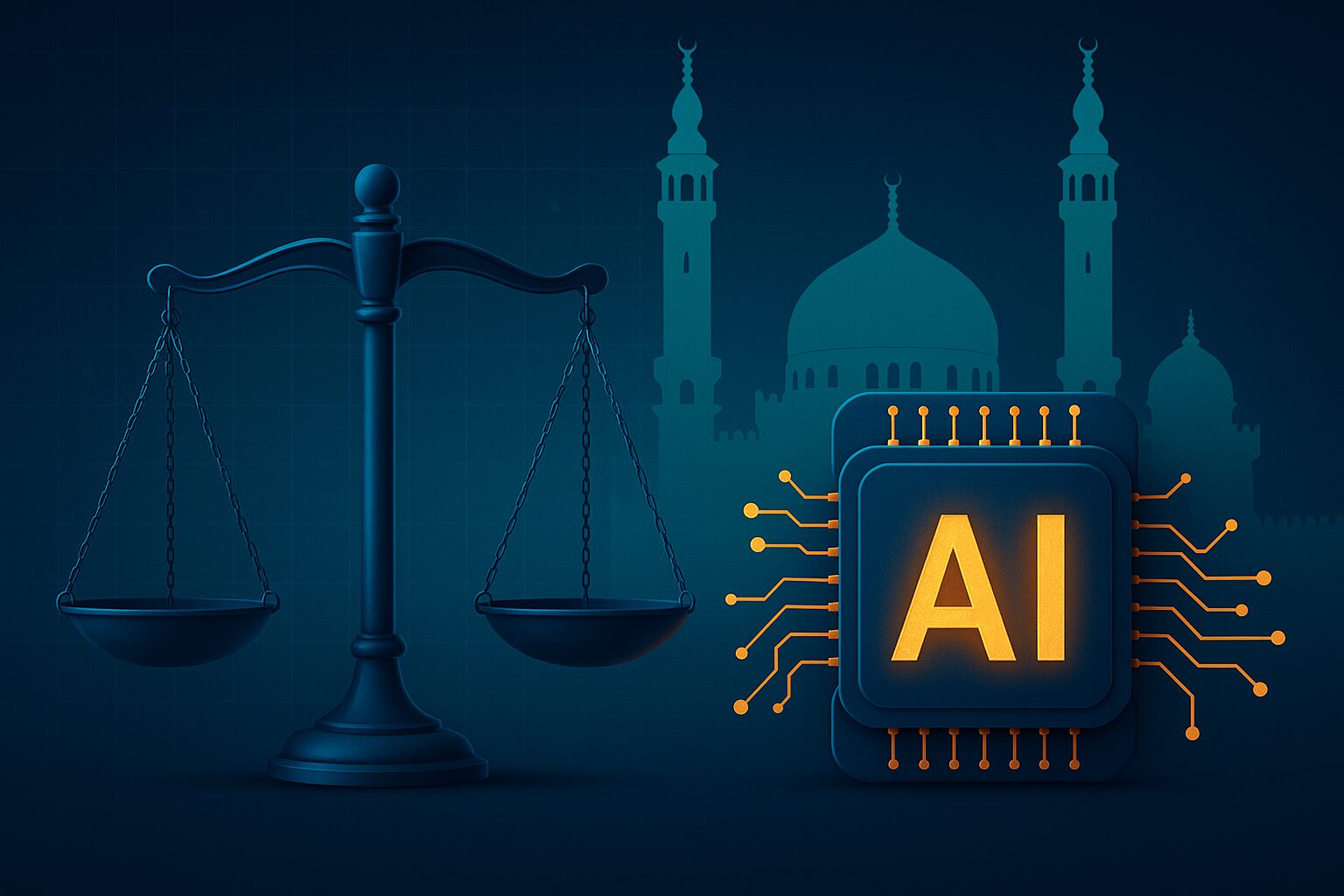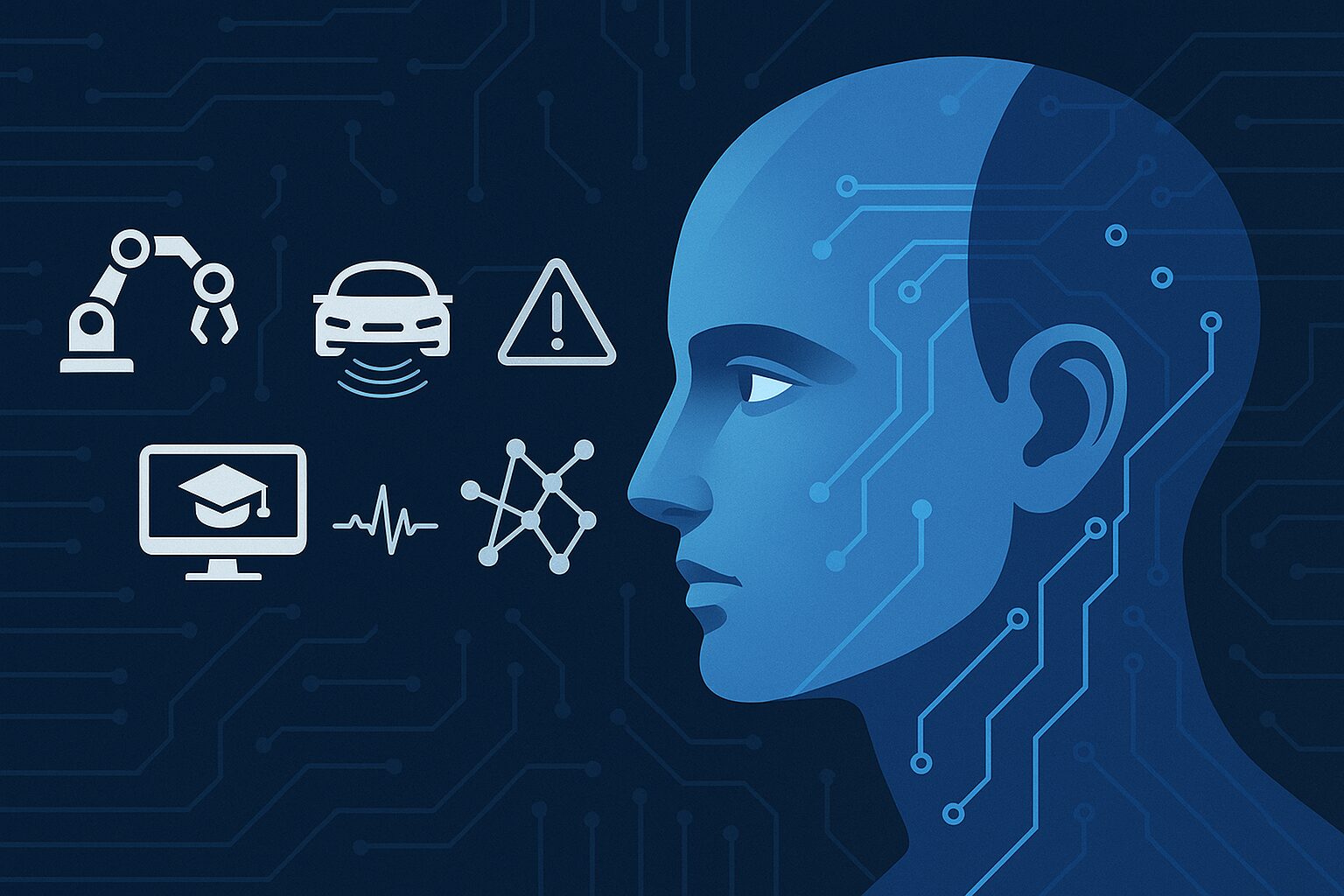تحديات في مواجهة العربية.. الترجمة والذكاء الاصطناعي
د.حصة بنت زيد المفرح
تواجه اللغة العربية تحديات كثيرة، ولعل من أهمها: الترجمة، والذكاء الاصطناعي. ولا يمكن القول إن الترجمة من التحديات الجديدة لها، لكن مراقبة الوضع الراهن، والدراسات، والإحصاءات، كل هذا يقول إننا مازلنا في الترجمة نخوض تحدياتٍ متنوعة، ويتأكد هذا مع مستجدات كثيرة أهمها: إعلان اللغة العربية لغة عالمية بين عدد من اللغات ذات المكانة، زيادة الإقبال على تعليمها وتعلمها في الدول عالميًا، شغف الآخرين بالتعرف على عوالم (العالم العربي) إيجابية كانت أم سلبية، واللغة عادة ستكون وسيلة لذلك، والترجمة مفتاح مهم لها.
وهناك ما استقر من صور نمطية عن العرب والخليج والسعودية خاصة، والترجمة يمكن أن تسهم في تغيير هذه الصورة، إضافة إلى التغيرات التي طالت بعض الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وتشمل: التقدم العلمي، والبحثي، والرياضي، والاقتصادي، والبنية التحتية، والمشروعات التطويرية، والإنجازات والجوائز العالمية، والجهود الكبيرة لتعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على الموروث مع السعي إلى التجديد.
وقبل البدء بالحديث عن الموضوع أفضل الإشارة سريعًا إلى دلالة المفهومين (الترجمة والتعريب) فالترجمة تدور معانيها اللغوية حول: النقل، والتحويل، والتفسير، والتأويل، ثم النقل من لغة إلى أخرى، وما يقتضيه النقل من: التفسير، والإبانة، والتأويل بما يكافئ دلالات النص المترجم.
وإذا ما أردنا وضع الترجمة تحت مظلة المفهوم الاصطلاحي سنقول: إنها فعلٌ ثقافيٌ يتيح التبادل المعرفي والثقافي بين الشعوب، وهي حوار ضمني بين تجارب الشعوب الثقافية، ولا تقوم على نقل الألفاظ والجمل فحسب؛ لأنها ستتغير حسب قواعد اللغة الجديدة، وإنما تعتمد نقل المحتوى والمضمون أيضًا، واستفادة كل ثقافة من الثقافات الأخرى.
أما التعريب فقد حدد في ثلاثة اتجاهات مهمة:
– تعريب اللفظ: ارتبط بداية بالمعرّب والدخيل، وكيف أن نطق بعض الألفاظ الأعجمية على منهاج لغة العرب هو مقياس مهم؛ فإذا جاء متفقًا مع أوزان العربية وأصواتها فهو معرّب، وإلا كان دخيلًا.
– تعريب النص: وهو هنا نقل النص من لغات أخرى إلى اللغة العربية، بمفهوم الترجمة لكنه أكثر خصوصية منه.
– تعريب المجال: أي جعل اللغة العربية أداة للتعبير في مجال ما: التعليم، والإعلام، والطب، والقضاء، مع الوعي بأن القضية ليست من باب التعصب، أو الانغلاق، أو التعالي الفكري، بل هو وضع لغة كل قوم في موضعها الصحيح، وهذا لا يتنافى مع دراسة اللغات الأخرى، وإنما هو مطلب مهم ونحن نتحدث هنا عن الترجمة.
ونظرة سريعة إلى تاريخنا العربي، وحركة الترجمة والتعريب فيه؛ تُسْلمنا إلى بعض النتائج المهمة وخاصة في العصر العباسي، لكن ينبغي الإقرار أيضًا أننا مازلنا بحاجة إلى الترجمة وخاصة إلى العربية، وما وصلنا إليه حتى الآن يحتاج إلى المزيد.
وتتأكد أهمية الترجمة بعد أن تحول العالم إلى مساحة ثقافية واحدة تعيش التفاعل بأقصر الطرق وأسرعها. ومن المهم ألا ننظر إليها نظرة سلبية قاصرة فنراها استلابًا، أو ذوبانًا في ثقافة الآخر، بل العكس؛ فهي تلاقح، وحوار ثقافي وحضاري مثمر إن أحسنّا توظيفه.
وربما السؤال المهم الذي نطرحه عادة: هل يمكن التواصل مع الثقافات العالمية، والتجارب الحضارية دون الترجمة؟ وإجابته واضحة وربما لا نختلف حولها؛ فالترجمة هي بوابة العبور للآخر، ويمكن أن نستفيد من هذا الآخر، مع الحفاظ على هويتنا راسخة ثابتة، لكنها ليست جامدة، بل العكس؛ فالترجمة إلى العربية، والترجمة منها تعزز مكانتها أكثر وأكثر، وجزء من المحافظة على الهوية أن نعرّف الآخرين بها أيضًا. كما أن عدم التوازن بين الترجمة إلى اللغة العربية، وهي الكفة المرجحة هنا، والترجمة من العربية إلى لغات أخرى؛ يستدعي الاهتمام، وتحقيق التوازن قدر الإمكان، فنحن هنا نستورد أكثر مما نصدر، ونريد أن نعزز هذا التصدير بالاختيار الواعي لما يترجم، ويعزز مكانة اللغة العربية وأهلها.
وميزة الترجمة أنها يمكن أن تنقل لنا صورة لا نعرفها عن أنفسنا، فنحن لدينا تصور عن هويتنا وموقعنا بين الآخرين، لكن الصورة التي ينقلها الآخر عنا مهمة أيضًا؛ فقد تكون إيجابية فتدعم مساراتنا الإيجابية، وقد تكون سلبية فتكون بين مسارين أو حالين: رؤية منصفة ودورها سيكون أشبه بالتقويم، أما إذا كانت غير منصفة فدورنا هنا أن نسعى إلى التصحيح، والترجمة في رأيي من أنجح الوسائل لذلك. والملاحظ أن بعض الدول مثل: اليابان، وأمريكا، وروسيا وغيرها تضع خططًا للترويج للصورة الإيجابية لثقافتها بتوظيف الترجمة.
وأظن أن من أهم التحديات في الترجمة إلى العربية ما يتعلق بالنقد والمصطلحات؛ لأننا بحاجة ماسة إلى توحيد الترجمة، والحديث عن فوضى المصطلح المترجم قضية مهمة، وتطرح دائمًا للنقاش، لكن نحتاج أن نعمل عليها بجدية وعزم أكثر.
وهناك نقطة مهمة يجب أن نعيها في الترجمة، وكيف يمكن أن تؤثر في التواصل بين الثقافات، وهي أننا عندما نريد أن نصدر حكمًا على ترجمة ما نقلت من العربية على سبيل المثال، يجب أن ندرك أن المترجم ليس الوحيد الذي يعمل في هذه المنظومة الترجمية إن صح التعبير، بل هو عنصر واحد فيها، وقد يأتي دوره حتى متأخرًا عن أدوار أخرى تسبقه، وقد يُختار له النص، وتحدد المعايير، ويحدد توجه الترجمة، وهذه المنظومة عمومًا تخضع لسياسات الدول، وسياسات النشر فيها، وعوامل أخرى كثيرة منها ما تتطلع كل ثقافة إلى معرفته عن الثقافة الأخرى. وهذا قد نربطه بسؤالنا الأول الذي انطلقنا منه: هل الترجمة تستهدف فعلًا التواصل الحضاري والثقافي؟ أم أنها قد تتعلق بأهداف أخرى كما في تكريس صورة نمطية ما مثلًا للمترجَم عنه. والقضية مطروحة في هذين البعدين عند إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق عندما قرأ العقل الاستشراقي بوصفه عقلًا استعماريًا وعقلًا حضاريًا.
كما أن الترجمة الإبداعية عادة تختلف عن الترجمة العلمية للكتب والمؤلفات في تخصصات مختلفة؛ لأنها حديث الذات، ولارتباطها بقضايا شائكة مثل: تعريف الأدب، وآليات التوظيف، إضافة إلى صعوبة استحضار التجربة الأصلية بانفعالاتها، ورؤاها، ودلالاتها كلها.
ومن أهم التوصيات التي تطرح في المؤتمرات، والندوات، والمبادرات التي تعنى بالترجمة، التوصية بأن تكون هناك مراكز، ومؤسسات وطنية أو محلية، وأخرى عربية خاصة بالترجمة، ويشرف عليها المختصون في المجالات المعرفية التي يترجم منها وإليها، مع إتقان لغتين أو أكثر كما هو معلوم. والمملكة العربية السعودية خطت خطوات جادة في هذا الاتجاه الذي يمكن أن يجمل في بعض الجهود الآتية: دارة الملك عبدالعزيز، ومراكز الترجمة في الجامعات كما في جامعة الملك سعود، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، وجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للترجمة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بجهوده الدولية في هذا المضمار، وغيرها.
وفي رأيي أن الترجمة المنظمة، وبمشاريع مدروسة ستحد من ظاهرة ملاحظة ليس على المستوى العربي فقط، وهي هجرة الكتّاب العرب من الكتابة باللغة العربية إلى الكتابة بلغات أخرى ومنهم الأدباء، وهذا على مستوى الكتّاب الأفارقة أيضًا الذين اختاروا اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهم يسعون بصنيعهم هذا إلى الانتشار، والوصول إلى الثقافات الأخرى، ومع الترجمة أظن أننا سنقول لهؤلاء الكتاب عمومًا، والأدباء خاصة: بإمكانك أن تصل بلغتك أيضًا.
من جهة ثانية، الواقع يقول: إن اللغات العالمية تحظى بالترجمة منها وإليها أكثر “الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية” لكن الوقوف على هذه اللغات فقط يعني أننا نضع هدفًا لنقل ثقافتنا، وهو هدف مهم، لكنه لا يعبر عن الأهداف كلها، والحضارات والثقافات كلها أيضًا، فنحن بحاجة إلى الانفتاح على اللغات والثقافات المختلفة، والابتعاد عن المركزية.
وإذا ما انتقلنا إلى التحدي الآخر “الذكاء الاصطناعي” فإن بداية التداخل بين العلوم اللغوية والتقنيات المعلوماتية الحديثة أدى إلى ظهور ما يسمى حوسبة اللغة، واللسانيات الحاسوبية، وهي الأساس الذي نشأ منه الذكاء الاصطناعي، وامتد إلى مجالات أخرى. والأصل فيه محاكاة الدماغ البشري المسؤول عن العملية الفكرية، والحركات التي يقوم بها الإنسان، لكن الآلة في الأصل لا تفكر كما يفكر العقل البشري، بل تنفذ مجموعة من العمليات مرتبطة ببيانات ومعلومات معينة.
ومن المعلوم أن الذكاء الاصطناعي أصبح هاجسًا لكثير من الأنظمة، والمنظومات المؤسسية على اختلاف تخصصاتها، ولا يمكن أن نقارنه بأي تجديد سابق كما في دخول الإنترنت، أو اختراع الحواسيب؛ فقد أحدث ردات فعل متباينة، وربما الغالب فيها كان الخوف من النزاع بين الإنسانية وغير الإنسانية أو الآلية هنا؛ لأنه يقوم على محاكاة الآلة لعمل الإنسان وقدراته، والتفوق في سرعة الأداء والإنجاز. وهو المرحلة الحاسمة في تكنولوجيا المعلومات، فقد كانت احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في العام المنصرم 2024 عن اللغة العربية والذكاء الاصطناعي؛ لتناقش قضايا مهمة منها تعزيز الابتكار مع الحفاظ على التراث الثقافي. والنقاش عن علاقة اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي طرح في احتفالية عام 2019، وكان السؤال المطروح آنذاك: كيف يكون الذكاء الاصطناعي مصدرًا للمعارف، وأداة لتعزيز اللغة العربية وحمايتها؟
وفي السنوات الأخيرة، كان التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والحفاظ على التراث الثقافي مطروحًا في مجالات مختلفة أهمها: حماية القطع التاريخية والأثرية وتحديد سماتها بدقة، واكتشاف مواقع التراث الثقافي، وحصر النقوش القديمة وترجمتها، وترجمة النصوص القديمة ورقمنتها، والكشف عن التزوير الفني بالخوارزميات المتقدمة، وتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لاحترام القيم والتقاليد الثقافية “الألوان والرموز تختلف من ثقافة إلى أخرى”، و الاستفادة منه في المتاحف والعروض المقدمة فيها؛ لتعزيز تجارب الزوار، والأرشفة والترميم الرقمي، والحفاظ على التقاليد الشفهية كما في السرد الشفهي واللهجات، وضمان بقاء هذا التراث للأجيال القادمة بأفضل الطرق وأحدثها.
ومن التحديات في مجال “الذكاء الاصطناعي” ما يراه المهتمون من أن طبيعة اللغة العربية يمكن أن تشكل صعوبة في التعامل معه لأسباب كثيرة منها: غنى اللغة العربية، وسعة المفردات اللغوية الذي سيؤدي إلى اختلاف المعاني حسب السياقات، واتساع مخارج الأصوات وتنوعها، وطبيعتها الاشتقاقية وتنوع الميزان الصرفي، وكثرة الخلافات والاختلافات على مستويات: النحو، واللغة، والإملاء، وحركات الضبط والتشكيل التي تعتمد عليها اللغة العربية في الإبانة عن بعض الألفاظ واختلافها عن ألفاظ أخرى، فـ”كَتَب، كُتِب، كُتُب” على سبيل المثال، إذا لم تضبط بالشكل فقراءتها واحدة، هناك التثنية؛ فاللغات الأخرى تعتمد على الإفراد والجمع فقط. وهناك اختلاف وتنوع اللهجات العربية المستعملة والفجوة بينها وبين الفصحى؛ مما يجعلها صعبة على الاستيعاب الآلي، يضاف إلى ذلك أن المحتوى العربي على التطبيقات العالمية لا ينافس محتويات اللغات الأخرى ذات المكانة عالميًا؛ فمحرك قوقل على سبيل المثال يوفر ما نسبته 90 % من المحتوى باللغة الإنجليزية؛ وهذا يفسر سر نجاح التعامل مع اللغة نفسها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يضاف إلى ذلك أن من صمم نموذج اللغة بناه على هذه اللغة تحديدًا، والتدريبات كانت على النموذج نفسه. كما أن المحتوى العربي قد يضمن بعض الآيات القرآنية الكريمة التي يخشى من تحريفها؛ لذا يحتاج النظام إلى تخزين النماذج الخاصة بالقرآن الكريم، وشكل الكتابة من اليمين إلى اليسار تحدٍ لنظام الكتابة في لغات أخرى تقوم على العكس.
ومن أكبر التحديات التي يمكن أن نتحدث عنها هنا التحديات الأخلاقية وتتعلق بـ : خصوصية بعض البيانات، ولا يُضمن هنا عدم انتهاكها، والتحيز وعدم تحقيق العدالة؛ تبعًا لتحيز البيانات نفسها كما في التحيز ضد لهجات معينة أو لغات، أو طرق تعبير خاصة، وعدم القدرة على المساءلة في حال وجود أخطاء في التحليل، أو إذا استخدمت البيانات بطريقة غير مناسبة، وهناك تحد في الحفاظ على الغنى الثقافي، والتنوع اللغوي دون تجاهل الخصائص المميزة للغة العربية، ومنها صعوبة التأكد من الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي كما في: الواجبات، والأبحاث، والتقارير، ومنها الاستنساخ، والتشابه، وإلغاء فردانية الإنسان وتميزه.
ومع هذه التحديات؛ فإنه لا يمكن إغفال الإنجازات الكبيرة المقدمة حتى الآن، ولعل بدايتها عربيًا كانت قبل ما يقارب العشرين عامًا عندما قدم رائد تعريب الحواسيب د. نبيل علي بحثًا في تطويع اللغة العربية لمتطلبات الذكاء الاصطناعي أو العكس، لكن مشروعه توقف آنذاك؛ لنقص الحوافز، والإمكانات المادية، ثم لوفاته. وكان مشروعه قائمًا على تجهيز قواعد بيانات ذكية يسهل التعامل معها، والاستفادة منها شملت: المعاجم والمترادفات والأضداد، والأقوال المأثورة والأمثال، والتراجم الموثقة، والصيغ الأسلوبية الثابتة، ورأى في بحثه أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخدم اللغة العربية في مجالات كثيرة مثل: التعليم والتعلم (توليد الأسئلة)، والتصنيف، والتلخيص، والترجمة وغير ذلك.
والإنجازات في هذا المجال مستمرة ولله الحمد؛ فمن الإنجازات المهمة في خدمة اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي ما قدم في قطاعات حوسبة اللغة، وإنشاء برامج تستوعبها وبمخرجات تجاري قدرة الإنسان على التعامل مع اللغة وتفوقها، ثم توظيفه في التدقيق اللغوي، وفي بناء المعاجم، والترجمة الفورية للغة وإخراجها صوتيًا، وبرامج تحليل النصوص، والبرامج الإحصائية، والترجمة الشفاهية والكتابية، وكشف الانتحالات والسرقات العلمية والبحثية، والتعرف على الخط العربي، والقدرة على تحويل النصوص إلى نصوص رقمية، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والترجمة من العربية وإليها، حتى وصلنا إلى مرحلة الكتابة الإبداعية التي صنعتها روبوتات ذكية.
ومن الإنجازات الأخرى؛ لتجاوز الصعوبات والتحديات: أن المؤسسات في بعض الدول العربية والخليجية مثل الإمارات العربية المتحدة أصبحت تنافس على تقديم برامج تتجاوز هذه الصعوبات، كما في تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبو ظبي. ومركز اللغة العربية الذي يهتم بعلاقتها بالذكاء الاصطناعي، ويعقد شراكات دولية ومحلية، ويضع مشروعات اقتصادية واستثمارية للغة العربية.
وفي المملكة العربية السعودية جهود استثنائية يشار إليها بكل فخر واعتزاز، كما في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الذي يقود أهم المشروعات في خدمة اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي، فهناك مركز “ذكاء العربية” الذي يوفر تطبيقات مساعدة؛ لبناء البيانات اللغوية وتهيئتها، ومدونات ومعاجم ومصادر متنوعة في اللغة ال عربية، ودعم البحث العلمي في المعالجة الآلية للغة العربية. وهناك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” التي قدمت عددًا من المبادرات؛ لإثراء المحتوى العربي وخدمة اللغة العربية محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، وتوجت بجائزة مجمع الملك سلمان في دورتها الثالثة للعام الحالي عن فئة المؤسسات. وشركة مُزن، شركة سعودية رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسست نظام “أُسُس” الرائد في فهم اللغة العربية وتحليلها، وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تزويد المؤسسات الحكومية والأهلية بحزمة من الميزات مثل: إنشاء المحتوى، والإجابة عن الأسئلة، وتحليل المستندات وتصنيفها. وهناك قطاعات أخرى مهمة مثل مركز الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك خالد.
وبعد، فإن هذه الجهود المعروضة وغيرها من جهود جبارة مازالت تستكمل حلقات نجاحها، وتمضي قدمًا نحو التألق في قادم الأيام، ويشهد التحديان “الترجمة والذكاء الاصطناعي” نجاحات متلاحقة ستؤتي ثمارها بتميز وجدارة، لكن تظل بعض العقبات قائمة، وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهود؛ لتجاوزها والعبور بها نحو بر الأمان اللغوي والثقافي.
المصدر: الجزيرة