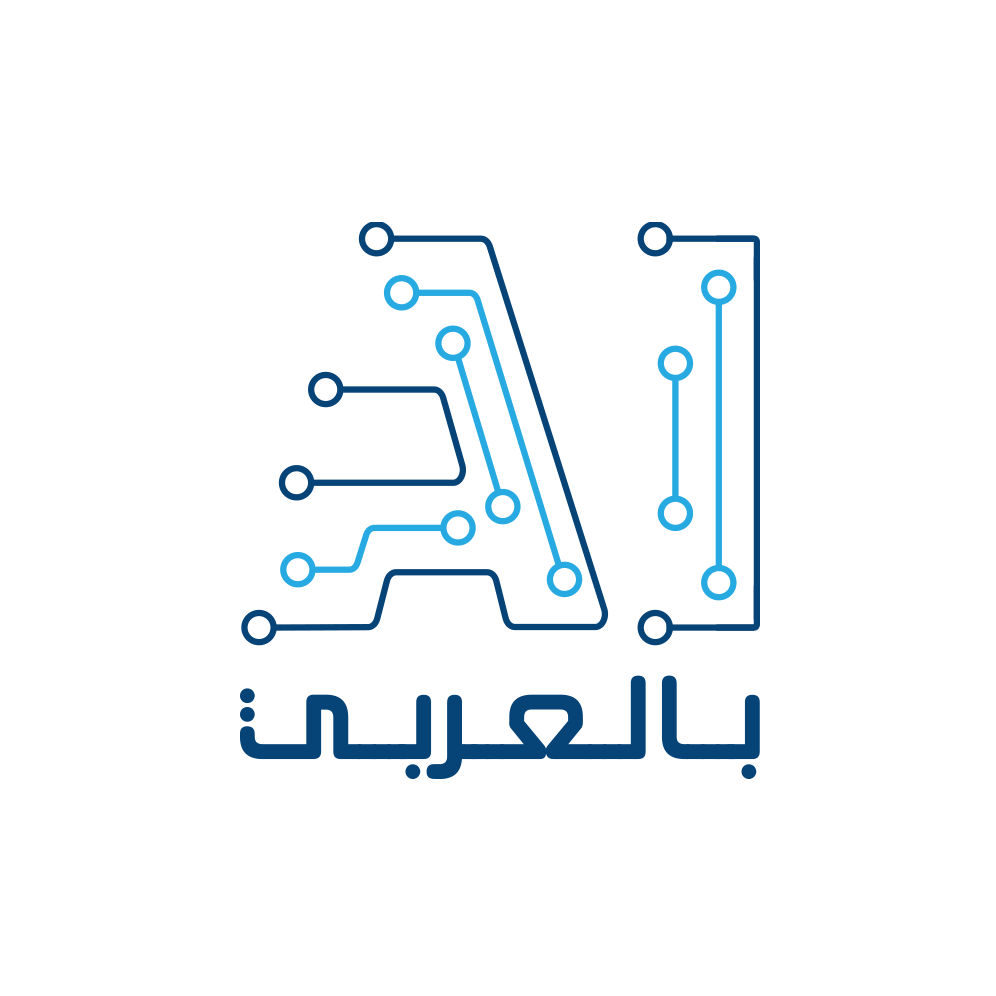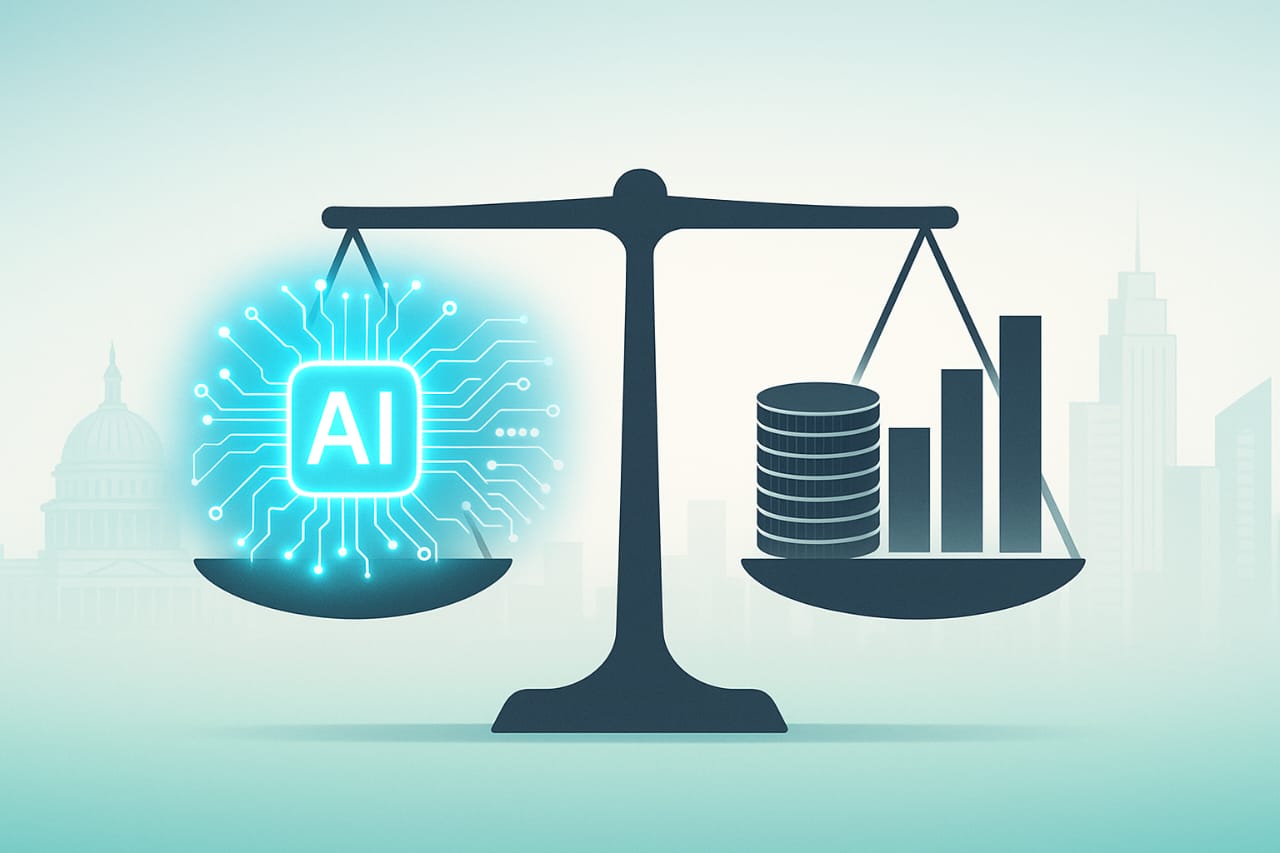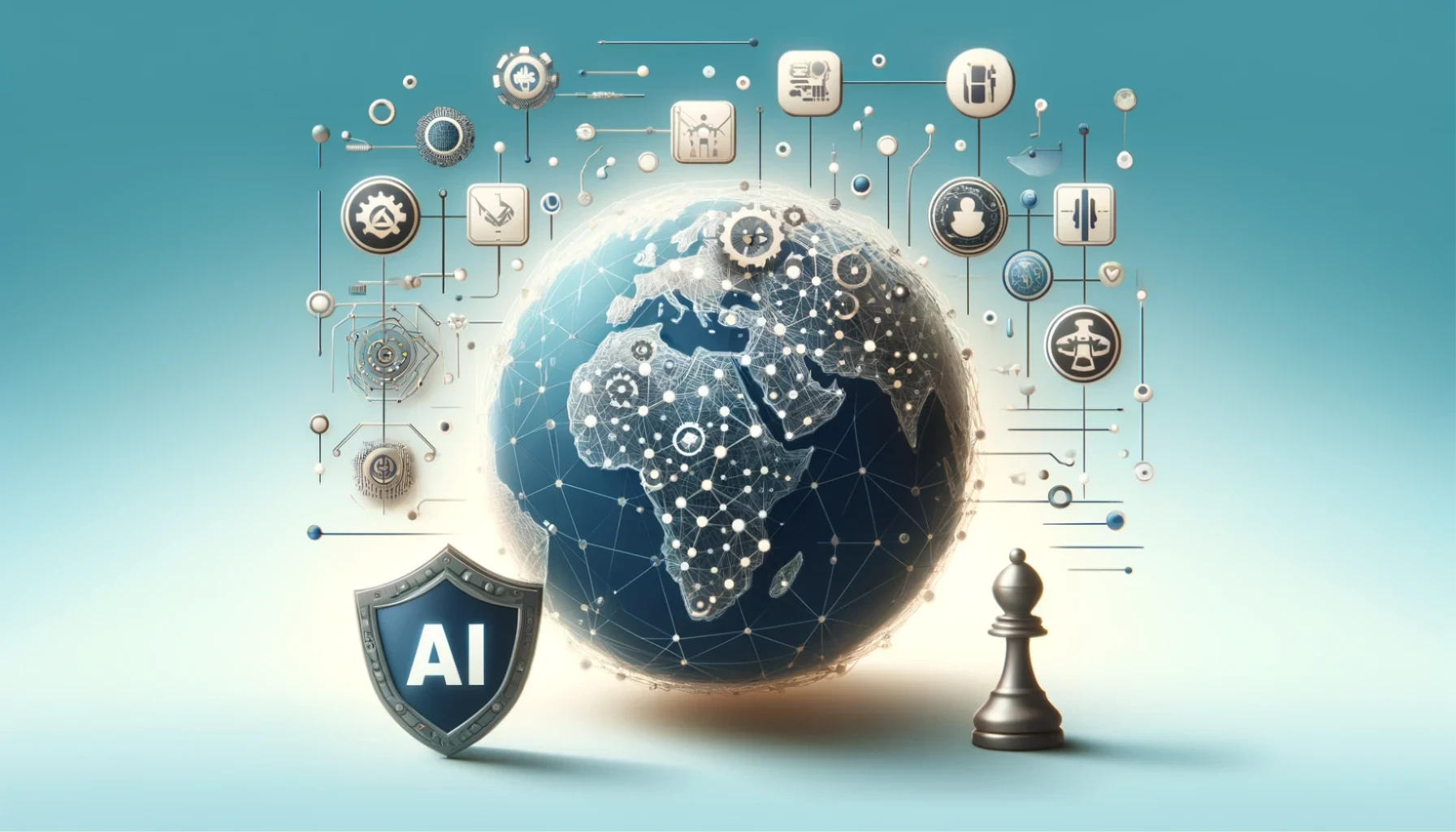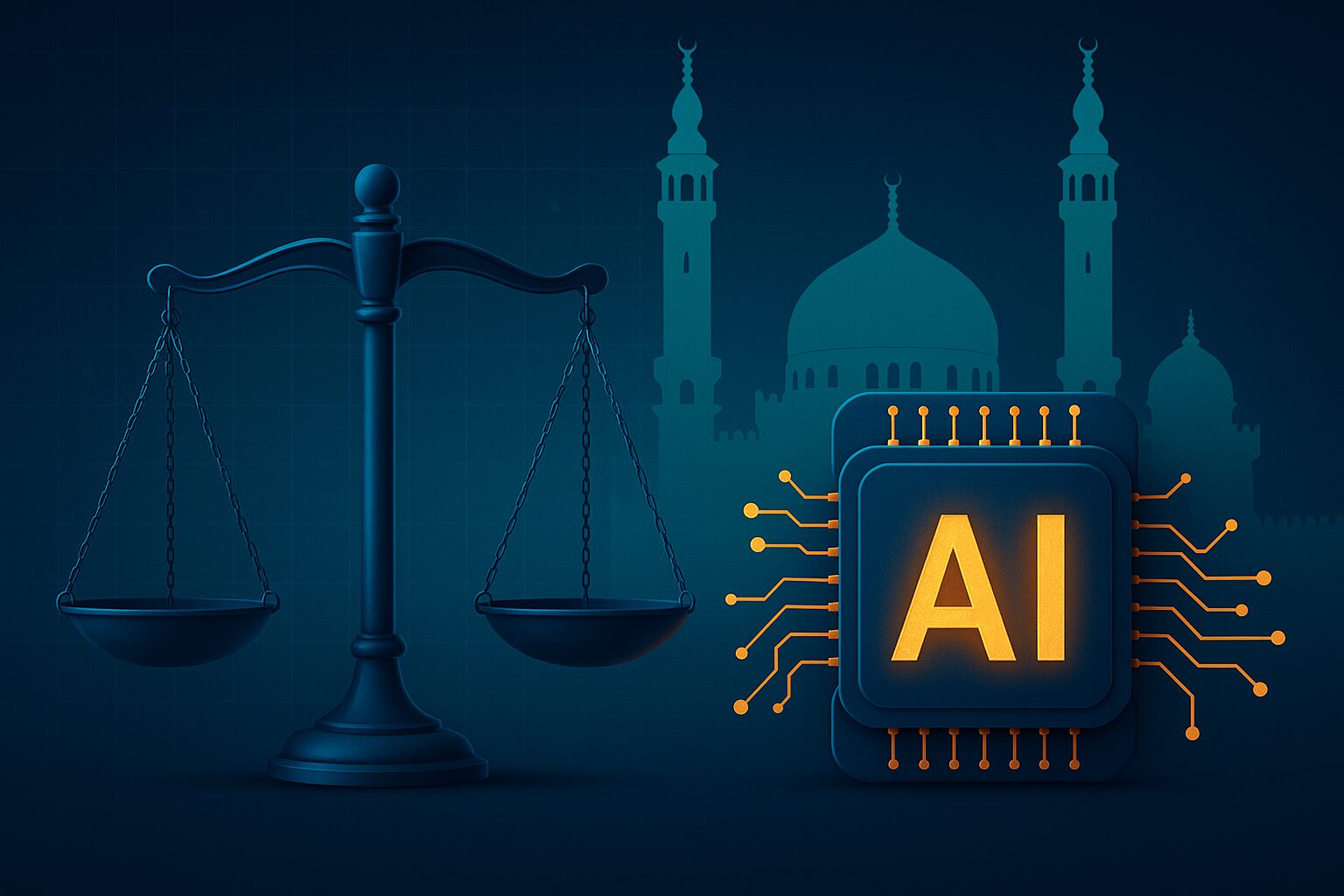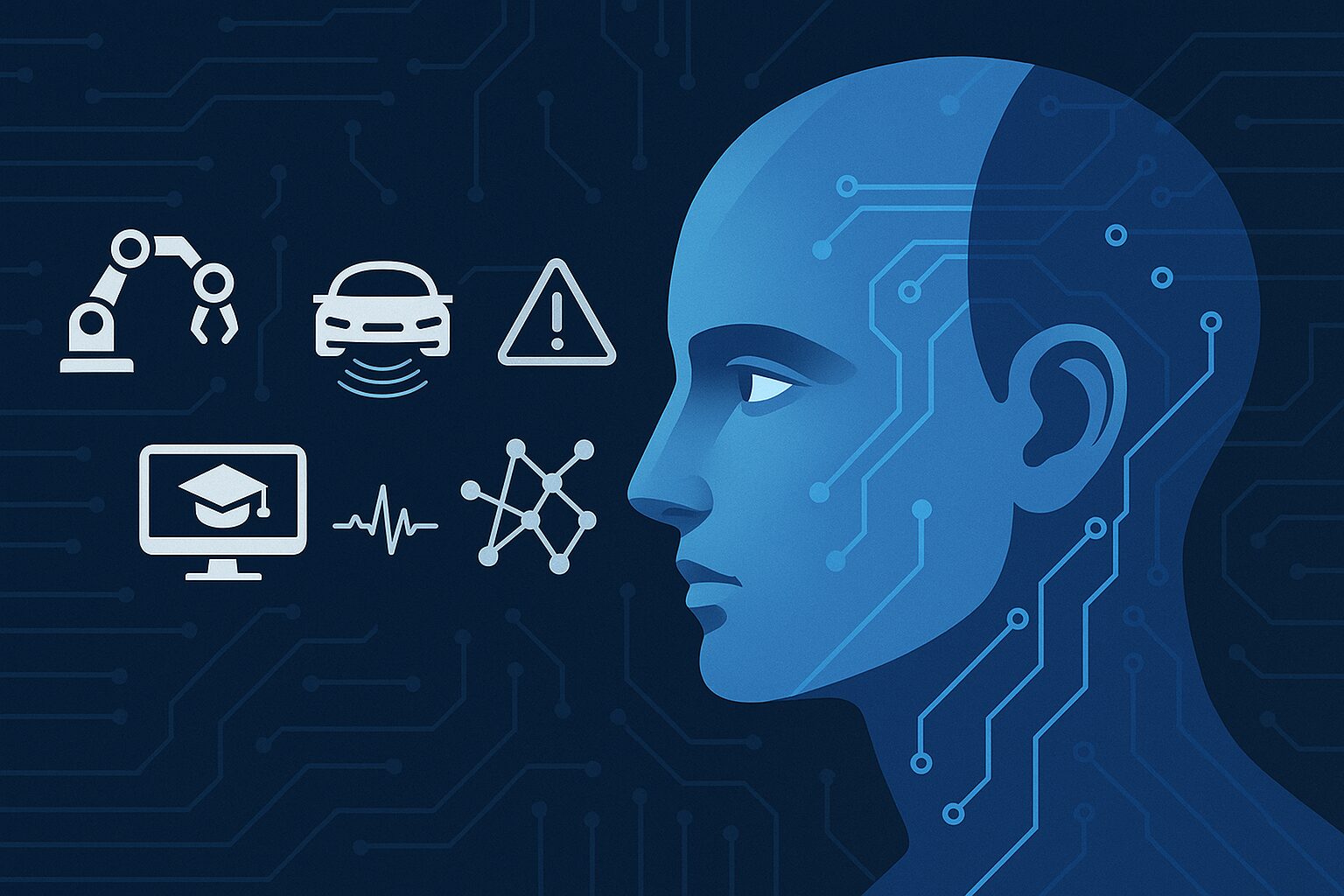أحمد الفاضل
أُجهِضت آمال ومشاريع الذكاء الاصطناعي التي حصلت بين 1974 و1980. وكان السبب التفاؤل الكبير الذي سبّبه الزخم الإعلامي الهائل فيما النتائج متواضعة، ما أدى إلى خفض تمويل المشاريع آنذاك. وتعثّرت تلك المحاولات مرة أخرى بسبب مشاكل التخزين ونقل البيانات بين 1987 وحتى منتصف التسعينات، ستسمى تلك المرحلتان لاحقاً بشتاءات الذكاء الاصطناعي. ولم يعد الذكاء إلى الواجهة إلا حين تمكن جهاز حاسوب من التغلب على غاري كاسباروف بطل العالم في الشطرنج، في ذلك الحين!
فهل يمكننا حالياً أن نعتبر أن ربيع الذكاء الاصطناعي قد بدأ وآن أوان خروج المارد الذكي من القمقم إلى غير رجعة؟ وهل سيأخذنا إلى أفق أكثر رفاهية كما فعل ابتكار العجلة والمطبعة والمصباح والهاتف والإنترنت..؟ أم أن هذا الشكل من المعرفة بالتفاعل بين بشر وآلات هو وليد المخيال الهوليوودي أو مزايدات صحافيي السبق والإثارة، أو فرط التفاؤل لدى باحثي الذكاء الاصطناعي؟!
لقد باتت الشبكات والقنوات تضج بالوعيد والجديد من هذا المارد. ومن وجهة نظري، من أولى الخطوات لفهم هذا “الآخر” الحديث العهد، إعادة النظر في ذواتنا مجدداً، وتجنب البقع العمياء التي مررنا بها ومراجعة العلاقات التاريخية في التجربة البشرية مع “الآخر” الذي مر في ظروف اغتراب في كثير من الثقافات بسبب نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو اللون. وفتح باب الفلسفة التي تنادي بدرجات من الاعتبار الأخلاقي لجميع الكائنات الحسّاسة، البشر في المقام الأول. فإذا ما أظهرت الذكاءات الاصطناعية (أو حتى الفضائية) دليلاً على إحساسها، حينها يجب التعاطف معها ومنحها حقوقا… وهذا التوجه الذي سيكون لها التأثير الكبير في التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وسن التشريعات الموافقة ووضع القيود المناسبة.
أما عن الذكاء الاصطناعي وماهيته المعقّدة صاغ جون مكارثي مصطلح Artificial Intelligence (الذكاء الاصطناعي) في ١٩٥٦، خلال انعقاد ورشة عمل دارتموث، في هامشاير الأميركية، حول هذا الموضوع: جعل الآلة تتصرف بطرق قد توصف بالذكاء لو كانت صادرة عن البشر. وقد اختار هذا المصطلح للتعريف بعمله مع زملائه، وتمييزه عن مجال السيبرانية الذي كان يحظى بأهمية كبيرة حينها. إلاّ أن الموضوع لم ينتهِ عند ذلك التعريف الإجرائي البسيط، فلا شك أن المصطلح يشوبه الغموض المفاهيمي ويتغير تعريفه بين أصحاب الاختصاصات ومن حين إلى حين.
وعلى رغم ما نتابعه من اجتهادات في إثبات العلاقة والتشابه بين الشبكة العصبونية في الدماغ والشبكة العصبونية الاصطناعية، تبقى هذه العلاقة علاقة قائمة بين التطلع والتقليد لا أكثر. فالإنسان حتى الآن وعلى رغم تقدّمه في العلوم وأدوات البحث، لا يدرك إلا القليل عن البنية الوسطية للدماغ، ولا يزال يجهل كيف تؤدي تلك العصبونات المهمات وطريقة ارتباطها وعملها بمعزل عن بعضها.
وفي ظل الإحساس وعمل العصبونات كمؤشرات إلى ذكاء الآلة، ساق عالِم الرياضيات ألن تورينغ سؤالاً بالغ الأهمية: “هل الآلة تفكر؟” أحياناً كثيرة كانت الإجابات بـ “نعم” لا تلتفت إلى ماهية الوعي الذي لا يزال العلماء والمفكرون يتقارعون على تعريفه. ذلك أن الإنسان يمتلك مؤهلات حسية وإدراكية وشعورية، فهو يدرك بعقله ويشعر بوجدانه وبهما يتشكل وعيه. وإذا سلّمنا جدلاً أن للذكاء الاصطناعي “عقلا”، يبقى الوجدان والوعي عصيين عليه عاصيين لمنطق الآلة لارتباطها بصميم النظام البيولوجي شديد التعقيد للإنسان. ومهما بلغ منهما سيبقى مسار الذكاء الاصطناعي حتمياً وخياراته محدودة.
لكنْ… من يعلم؟ هل سيكون الروبوت يوماً ما عاشقاً ولهاناً؟ وهل سيشعر بالعوز؟ ويختبر الفقر؟ هل سيجرب الشعور بالأمومة؟ هل سيصاب بالغيرة أو الوحدة؟ أو، سيصاب بطيف ثنائي القطب أو البرانويا؟ هل سيفني حياته من أجل قضية واحدة؟ هل سيغترب ويشعر بتقدم السن؟ سبق لبعض روايات وأفلام الخيال العلمي أن أجاب على تلك الأسئلة، منها روايات اقتُبست في السينما، مثل: “أنا روبوت” لأيزك أزيموف (1950)، “القمر عشيقة فظة” لروبرت هاينلاين (1966) و”أوديسا الفضاء” لأرثر كلارك (1968). وفيلم “هي” الرائع للمؤلف الممثل خواكين فينيكس (2013) -والذي أنصح بمشاهدته بعد هذا المقال-
ولكن ماذا عمّا يتصوّره الفلاسفة وعلماء الإنسانيات في شأن الذكاء الاصطناعي بعد طرح تطبيقاته والشروع في استخدامها على أوسع نطاق؟
مخاطر الذكاء الاصطناعي متعددة، ولكني أجد أنها نسبية ومتفاوتة تختلف بحسب البيئات والمستخدمين، علينا أن نطرح مسألتين بالغتي الأهمية في مشرحة الذكاء الاصطناعي، أولها يخص الأخلاقيات، فلا يجب أن نضع تعاريف ومشاعر القيم الإنسانية اليوم تحت تصورات مجموعة مهندسين في كاليفورنيا يقترحون علينا ما فهموه في معزلهم. فهناك مفاهيم وأفكار لا تصاغ بذات الكلمات والسياق، فالكريم في ثقافة هو مسرف في ثقافة أخرى والشجاع قد يغدو متهورا أو أحمق في مجتمع آخر، وإن كثيراً من القيم لا يقبل الاختزال لأي أساس مفرد مثل الخير والسعادة أو الحرية والإيمان والرحمة والبر.
والتحدي الآخر الملكية الفكرية، وورطة مجال الملكية الفكرية اليوم في إنشاء معيار يميز الأفكار التي يولّدها البشر عن تلك التي يولدها الذكاء الاصطناعي، كما يجب استحداث أحكام قانونية محددة تنظم ملكية الاختراعات المستنبطة من الذكاء الاصطناعي، حيث إن نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم تنهب قواعد البيانات دون إذن أو رادع، وهنا مثال: أستراليا في صناعة الأدوية أخذت تمنح براءات الاختراع للذكاء الاصطناعي نفسه. تحدٍ آخر، هل ستسمح قوانين حقوق الملكية للروبوتات بالتعلم؟ والإجابة هي نعم، لأن مبدأ قيام هذا الذكاء هو التعلّم وإلا انتفى وجوده. وعموماً لا يجب التأخر في طرح الأخلاقيات الإلزامية وقوانين الملكية الفكرية لعالم الذكاء الاصطناعي وتطويرها مرحلياً فيما بعد، فالتأخر سيفتح شهية الانتهاز!
سيكون من التحديات في البداية، مواجهة التحيّز غير المقصود الذي يَحدث بناء على المعطيات التي تدفع نسب توافرها تلقائياً إلى تفضيل بعضها على البعض الآخر. وكذلك انتهاك الخصوصية والمراقبة الشاملة على حياة الناس وإمكانية إغراق المحتوى بمعلومات مضللة من أجل أغراض سياسية أو عقائدية. وكذلك البطالة فكثير من الوظائف ستموت، الأمر الذي سيؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مثلما حدث في كثير من الأحيان. وهنا مثال: في القرن الـ 18 كان 70% من سكان أمريكا يعملون في الزراعة أما اليوم فوصلت النسبة إلى 1%.
والخوف مما يسمى اليوم “الاستعمار الرقمي”، حيث تهيمن الشركات على المجتمعات الفقيرة والمتخلفة. وعليه، لا يُستبعد أن يعيد الذكاء الاصطناعي زمن الاستعمار الأوروبي. وإذا لم ينظّم، سيأتينا بوجهات نظر وقيم لا تناسب الجميع. ومن الصعب حينها التوصل إلى بدائل أخرى، ما يمنحه القوة في التدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وتغييرها.
إن الغزو الفكري الذي كان الغرب ينتهجه سُلم حالياً لآلة وصناعها. وما يؤلمنا أن حضور اللغة العربية شحيح في كثير من العلوم الجديدة. وفي “شات جي بي تي” مثلاً لا تشكل أكثر من 1% من محتواه، ما يعني أن 99% تخص الآخرين. ذلك أن اللغة ليست كلمات فقط بل هي مبادئ وقيم وثقافة وعادات وعلوم. وستبنى قيم وأخلاق أخرى لحظة الترجمة من دون انتباه. ولذا، علينا تجهيز محتوى يليق بالتراكم العلمي والإبداعي للحاضنة العربية يلائم سباق الذكاء الاصطناعي.
قرارات الإنسان المستقبلية مهما بدت في ظاهرها مستقلة وموضوعية هي غير ذلك تماما. فقد أصبحنا اليوم في مرحلة مفصلية. والذكاء الصناعي يتطور سريعا جداَ وعلى الدول أن توائم تشريعاتها على المستوى العالمي لضمان حماية الجميع، وأن نسعى إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي فرصة تطور البشرية عموماً والانتقال إلى وضع أكثر ازدهارا وعدلا وحفظا لكرامة الإنسان وخصوصيته.
مرت القيم في تاريخ البشرية بالكثير من السدنة رجال الدين وفلاسفة ومؤرخين وعلماء اجتماع وسياسيين. وقد يحدث أن الآلة اليوم هي من سيحدد قيم المستقبل! وهذا يحصل حالياً مع الروبوتات التي تقبل المحتوى أو ترفضه وتعرقل نشره، بناء على معايير أخلاقية صارمة وُضعت فيها، مثال أدب الكراهية، ومعاداة السامية التي تفسّرها فتنحاز في مصلحة واضعيها.
لقد دعا كيسينجر إلى صوغ نظام دولي يحمل “شيئا أساسياً من النظام الذي ظهر بعد الحروب النابوليونية في أوروبا”، ويقضي بأن تكون هناك منظومة قيم يُتفق عليها وأنماط سياسية منضبطة تتركز على الاستقرار والسلام. لكن هذا الأمر مرة أخرى سيخضع للمهيمن على البيانات والمعلومات.
لا شك في أن الدول التي ستبني أنظمة ذكاء اصطناعي ستشهد تقدماً سريعاً خلال الفترة المقبلة، يكون أسرع من بقية الدول، ما قد يخلق فجوة كبيرة بين الاقتصادات ويخلخل تراتبية الأهمية والأولويات.
في 3 أكتوبر 2017، مُنح الإنسان الآلي صوفيا الجنسية “الفخرية” في المملكة العربية السعودية، لتكون صوفيا بذلك أول روبوت يحصل على جنسية. كان ذلك إعلاناً للحدود الجديدة للإنسانية، وأتمنى أن نُلحِق بركب الذكاء الاصطناعي ثقافتنا العربية، وأن لا نترك مسؤولية مشاركتها الفعالة لغير أبنائها والناطقين بها، فنتأخر أكثر مما تأخرنا. وعلينا أيضاً المشاركة في إعلاء قيمة الحياة والجماليات، ووضع المحددات التي تحفظ الإنسان والبيئة، وأن لا نعامِل الآلة الجديدة باستهتار أو استكبار خصوصاً وأن للإنسان تجاربه المضنية دائماً مع أي غريب.